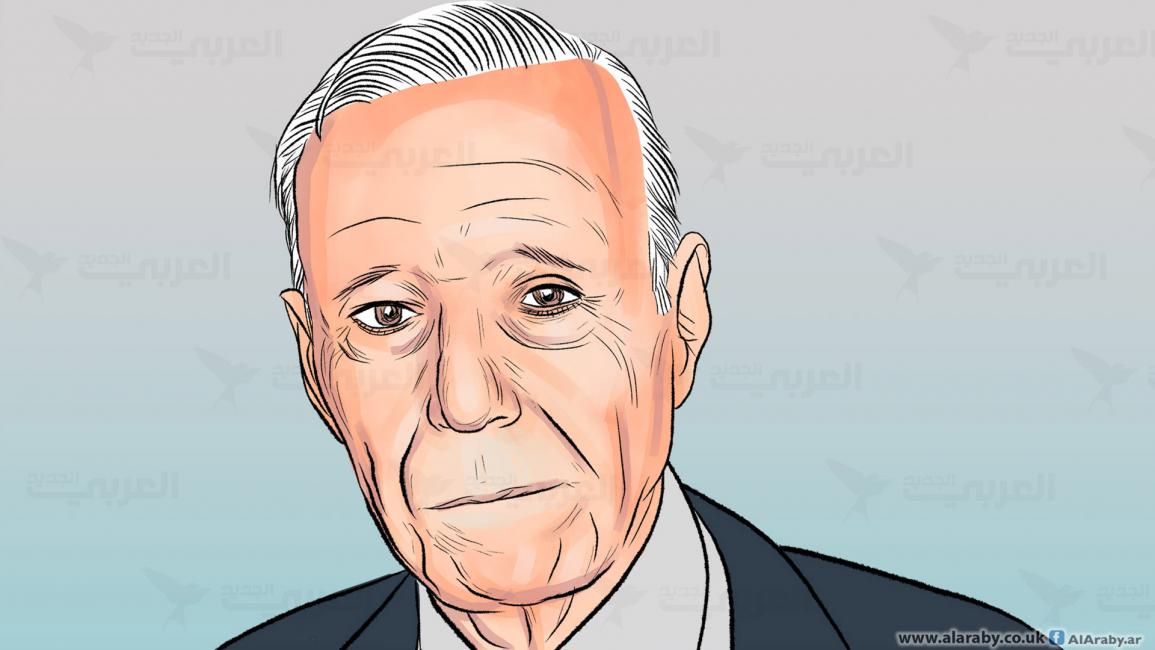19 مارس 2024
الطيب تيزيني وداعاً
الطيب تيزيني وداعاً

عبد الباسط سيدا
كاتب وسياسي سوري، دكتوراه في الفلسفة، تابع دراساته في الآشوريات واللغات السامية في جامعة ابسالا- السويد، له عدد من المؤلفات، يعمل في البحث والتدريس.
تعود علاقتي المعرفية مع الأستاذ الدكتور الطيب تيزيني إلى أوائل سبعينيات القرن المنصرم، إلى عام 1973 تحديداً. العام الذي بدأت فيه دراستي في جامعة دمشق، كلية الآداب، قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية.
كان الطيب من الأسماء الجديدة، ومع ذلك لفت نظري، وأثار اهتمامي أكثر من غيره، بتواضعه، وبساطة لبسه، بشعره الأبيض الذي كان يضفي وقاراً وهيبة على هدوئه واتزانه، وحواراته العقلانية.
أول كتاب قرأته لتيزيني كان عنوانه "حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث - الوطن العربي نموذجاً" في 1973. جذبني الكتاب بمضمونه، ولغته، سيما المصطلحات التي كان تيزيني يستخدمها بسلاسة ودقة وفصاحة يُحسد عليها. ثم قرأت كتابه الآخر الذي كان قد صدر عام 1971 "مشروع رؤية جديدة للفكر العربي الوسيط". أعجبت بطرحه، وكان يمثّل بالنسبة لي في ذلك الحين، وأنا في ذلك السن، كنزاً معرفياً، وكان عليّ أن أعمق معرفتي به، وأتابع المصادر والمراجع التي يحيل إليها. في مرحلة الدراسات العليا، تعمقت علاقتي الفكرية والشخصية مع الطيب، فقد كنت أزوره في مكتبه في القسم، وفي منزله أحياناً. وبعد حصولي على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، كان توجهي أن أدرس المنطق، كنت أريد أن أتخصّص في المنطق الرياضي، وأعمل تحت إشراف بديع الكسم. ولكن ما حصل أنه لم يكن هناك أي شاغر عند الدكتور بديع، بموجب ما كانت تسمح به أنظمة الجامعة، فكان رأيه أن أفاتح
الدكتور صادق العظم بموضوع الإشراف، لأنه، وفق راي بديع، كان الأفضل من جهة الإطلاع على المنطق، والأكثر قدرة من غيره في هذا المجال. وتم التوافق بيني وبين صادق على أن يكون موضوع الأطروحة "المنطق الوضعي عند زكي نجيب محمود"، مع تناول عام لدراساته في مجالات التراث والفن والنقد الأدبي.
ولكن علاقتي مع الطيب استمرت، واطلعت على كتبه الجديدة، منها "من الترات والثورة، 1978". وحصل في ما بعد أن الظروف الصحية الخاصة بالدكتور صادق، إلى جانب تنقله بين دمشق التي كان قد عاد إليها عام 1978 للتدريس في قسم الفلسفة، وبيروت حيث منزله ومركز نشاطاته البحثية والإعلامية التي لم يكن من المسموح له ممارستها في دمشق، فتم توزيع طلبته على الأساتذة الآخرين، بالتوافق طبعاً. وهنا اخترت أن أكون مع الدكتور الطيب تيزيني، فتحول التوجه العام للرسالة نحو التراث. وفي هذه المرحلة، تعمقت علاقتي معه، وأصبح يطلعني، بصورة أعمق، على أفكاره وتوجهاته السياسية. كان ينتقد النظام بمرارة وبقسوة في جلساتنا الخاصة، ولكنه، في الوقت ذاته، لم يكن يعول على المعارضة الموجودة، فقد كان تقييمه لها أنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. ومن أجل أن يستمر في نشاطه الأكاديمي الذي كان يفتح له الآفاق البحثية، ويمكّنه من التواصل مع الشباب في المقام الأول، كان يعتمد صيغة التعميم، تحاشياً لقمع السلطات التي كانت تتحسّب لمثل هذه الظواهر، وتعمل على وأدها أو احتوائها بكل السبل.
وفي فترة الثمانينيات، تحوّل الدكتور الطيب إلى ظاهرة ثقافية، فقد كان يمتلك جمهوراً واسعاً بين الطلبة الجامعيين من مختلف الانتماءات والمناطق، هؤلاء الذين كانوا يحرصون على الوجود في محاضراته العامة، وتلك التي كان يلقيها على طلبة الفلسفة، كما كانت له مكانة خاصة لدى المثقفين والأكاديميين خارج أسوار الجامعة، وبين المفكرين والأكاديميين والمثقفين العرب. وإلى جانب ذلك، كان يشارك في المؤتمرات واللقاءات الفلسفية، سواء في مصر أو تونس والجزائر والمغرب والخليج، وفي أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأميركية، حتى أصبح اسماً معروفاً على مستوى العالم العربي.
كانت لدى الدكتور الطيب علاقات احترام متبادل مع عديدين من رجال الدين المتنورين، ولم يكن يتهرّب من المناظرات والمناقشات، بل كان في مقدوره تناول أصعب الموضوعات مع أصحاب الرأي المختلف، أو المواقف المختلفة، وبموضوعيةٍ وهدوء، وكان يتشارك في هذه الخاصية مع الدكتور صادق. ونحن إذا عدنا إلى حواره مع الشيخ رمضان البوطي وحوار صادق مع كل من يوسف القرضاوي وحسن الترابي، ندرك مدى نضج علمين من أعلام الفكر اليساري العلماني السوري، بل والعربي بصورة عامة.
كان الدكتور الطيب يشدّد على ضرورة أخذ خصوصية الوضعية المشخصة بالاعتبار في أي
عملية بحث عن حلولٍ لجملة المشكلات التي تعاني منها، ولا تستوقفه في هذا المجال الأحكام القطعية الثابتة، فقد كان يدعو إلى المراجعات المستمرة، ويقول: كل فلسفة أو أيديولوجيا تقطع الطريق أمام التجاوز سيتم تجاوزها عاجلاً أم آجلاً.
وكانت لديه شبكة واسعة من العلاقات مع المفكرين والباحثين العرب. كان الجميع يحترمه، وهو يقابل ذلك الاحترام بتواضعٍ غير مصطنع، وبساطةٍ طبيعيةٍ لا توصف. لم أسمع منه، في أي من جلساتي الكثيرة معه، كلمة واحدة سلبية بحق زملائه في القسم، وبحق المفكرين والباحثين السوريين والعرب، على الرغم من معرفته بأحكام بعضهم السلبية بحقه، وكان على صلة بباحثين شباب كثيرين، ويعقد الآمال على الباحثين الشباب. وحده محمد عابد الجابري كان عقدة العقد بالنسبة إلى الدكتور الطيب، ولكنه كان يتعامل مع فكر الجابري وليس شخصه، كان ينتقده من موقع معرفي بحثي.
وجاءت مرحلة الدكتوراه، وتعمّقت العلاقة أكثر مع الطيب، وقرأت كتبه الجديدة التي كان يصدرها تباعاً: "الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى، من يهوه إلى الله"، في مجلدين، "مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر نشأة وتاسيساً"، وغيرها. وعلى الرغم من الأحكام العامة التي كان يلجأ إليها، والثنائيات التي عرف بها، وتكراره بعض الموضوعات، من باب تأكيد أهمية تناولها، كانت كتب الطيب موضع ترحيب جمهور واسع، ليس في سورية وحدها، بل في معظم الدول العربية. ولعل الطبعات العديدة لمعظم كتبه تمثل مقياساً يُعتمد عليه في هذا المجال.
مع بدايات الثورة السورية، استغل الدكتور الطيب تيزيني مناسبة اللقاء التشاوري (10- 11 تموز/يوليو 2011) الذي دعا إليه النظام تحت اسم هيئة الحوار الوطني، وأداره نائب الرئيس فاروق الشرع، ليدعو إلى ضرورة وقف الحرب على السوريين، عبر تحريم سفك الدم السوري، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين. كما شدّد على ضرورة تفكيك الدولة الأمنية المهيمنة على مفاصل الدولة والمجتمع. ولم يكن هذا موقفا جديدا للدكتور طيب، بل أعلن عنه بكل وضوح ودقة منذ بدايات الثمانينيات، حينما قال: سابقاً كنا نتحدث عن أمن الدولة، والآن نتحدث عن دولة الأمن. شعار هذه الدولة إفساد من لم يُفسد بعد، وإدانة الجميع كي يكونوا تحت الطلب.
لم يكن الطيب هجومياً صدامياً، وذلك ينسجم مع موقعه مفكرا وباحثا. ومع ذلك، كان يريد التغيير، ويعمل على توعية الناس من خلال محاضراته وكتاباته. وربما أخذ عليه بعضهم قبوله بإلقاء المحاضرات ضمن منظمات حزب البعث أو كلية الأركان. وربما حتى انتسابه الاضطراي إلى حزب البعث (لم أسمع منه ما يؤكد ذلك)، ولكننا جميعاً نعلم أنه منذ تسلط حافظ الأسد على الحكم في سورية عام 1970، لم يعد هناك أي مجال لأي شخص أن يدرّس في الجامعة ما لم يكن عضواً في حزب البعث، أو حصل على موافقة الأجهزة الأمنية. ولكن الطيب لم يتنازل، ولم يتزلّف، ولم يتمكّن النظام من احتوائه كما فعل مع آخرين، يساريين وعلمانيين ومتدينيين.
في الثمانينيات، كان اسم تيزيني هو الأول بين المفكرين والمثقفين اليساريين، في حين أن اسم
البوطي كان الأول بين المتدينين. تمكّن النظام من احتواء الأخير إلى درجة جعله مجرد جزئيةٍ ضمن ماكينته الإعلامية، بينما لم يتمكن من فعل الأمر نفسه مع تيزيني، على الرغم من أنه حاول وضغط في هذا المجال.
في بداية الثورة، تواصلت معه، كان مسانداً داعماً. وتطورت الأمور، وتصاعدت الثورة. ولم يعد الاتصال مع الطيب ممكناً، حرصاً مني عليه. ولكنني كنت أتابع أخباره. وفي أثناء زيارة رسمية إلى برلين، مع وفد من المجلس الوطني السوري خريف عام 2012، تواصل معي الإخوة في قناة دويتشه فيله الألمانية من أجل إجراء حوار معمّق حول سورية، قلت لهم: سألبي الدعوة إذا كانت الظروف مساعدة. وفي الموعد المحدد، دق جرس الهاتف، وأخبروني من استعلامات الفندق أن صحافية تريد الحديث معي. قلت فلتتفضل، وجاء الصوت ليقول: أنا ريم تيزيني. لم أصدق أذني، فريم التي شاهدتها آخر مرة كانت طفلة مع والدتها الألمانية زوجة الدكتور الطيب، وذلك قبل مغادرتهم سورية في ظل ظروف صعبة. قالت أعرف طبيعة العلاقة المتميزة بينك وبين والدي. وأعرف مدى الاحترام المتبادل الذي هو بينكما، لذلك حرصت على أن آتي بنفسي، لنذهب سوية إلى القناة. وهذا ما كان. حمّلت ريم تحياتي الحارة لوالدها، وتميناتي له بالصحة المستمرة. وكان من بين أحلامي أن أعود يوماً إلى دمشق، وأزور أستاذي من جديد. ولكن الأحلام، حتى البسيطة منها، باتت مستحيلة التحقّق في واقعنا السوري بكل أسف.
يقول الكاتب السويدي، اليوناني الأصل، ثيودور كاليفاتيدس: مأساة المهاجر أنه يحنُّ باستمرار إلى العدم. يحنُّ إلى أشخاصٍ قد تغيروا، وإلى أماكن قد تغيرت. ولكن مأساتنا، نحن السوريين، أقسى وأشد، فنحن نحنُّ إلى أماكن لم تعد موجودة، وإلى أشخاصٍ نبلاء باتوا في العالم الآخر.
أول كتاب قرأته لتيزيني كان عنوانه "حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث - الوطن العربي نموذجاً" في 1973. جذبني الكتاب بمضمونه، ولغته، سيما المصطلحات التي كان تيزيني يستخدمها بسلاسة ودقة وفصاحة يُحسد عليها. ثم قرأت كتابه الآخر الذي كان قد صدر عام 1971 "مشروع رؤية جديدة للفكر العربي الوسيط". أعجبت بطرحه، وكان يمثّل بالنسبة لي في ذلك الحين، وأنا في ذلك السن، كنزاً معرفياً، وكان عليّ أن أعمق معرفتي به، وأتابع المصادر والمراجع التي يحيل إليها. في مرحلة الدراسات العليا، تعمقت علاقتي الفكرية والشخصية مع الطيب، فقد كنت أزوره في مكتبه في القسم، وفي منزله أحياناً. وبعد حصولي على دبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، كان توجهي أن أدرس المنطق، كنت أريد أن أتخصّص في المنطق الرياضي، وأعمل تحت إشراف بديع الكسم. ولكن ما حصل أنه لم يكن هناك أي شاغر عند الدكتور بديع، بموجب ما كانت تسمح به أنظمة الجامعة، فكان رأيه أن أفاتح
ولكن علاقتي مع الطيب استمرت، واطلعت على كتبه الجديدة، منها "من الترات والثورة، 1978". وحصل في ما بعد أن الظروف الصحية الخاصة بالدكتور صادق، إلى جانب تنقله بين دمشق التي كان قد عاد إليها عام 1978 للتدريس في قسم الفلسفة، وبيروت حيث منزله ومركز نشاطاته البحثية والإعلامية التي لم يكن من المسموح له ممارستها في دمشق، فتم توزيع طلبته على الأساتذة الآخرين، بالتوافق طبعاً. وهنا اخترت أن أكون مع الدكتور الطيب تيزيني، فتحول التوجه العام للرسالة نحو التراث. وفي هذه المرحلة، تعمقت علاقتي معه، وأصبح يطلعني، بصورة أعمق، على أفكاره وتوجهاته السياسية. كان ينتقد النظام بمرارة وبقسوة في جلساتنا الخاصة، ولكنه، في الوقت ذاته، لم يكن يعول على المعارضة الموجودة، فقد كان تقييمه لها أنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. ومن أجل أن يستمر في نشاطه الأكاديمي الذي كان يفتح له الآفاق البحثية، ويمكّنه من التواصل مع الشباب في المقام الأول، كان يعتمد صيغة التعميم، تحاشياً لقمع السلطات التي كانت تتحسّب لمثل هذه الظواهر، وتعمل على وأدها أو احتوائها بكل السبل.
وفي فترة الثمانينيات، تحوّل الدكتور الطيب إلى ظاهرة ثقافية، فقد كان يمتلك جمهوراً واسعاً بين الطلبة الجامعيين من مختلف الانتماءات والمناطق، هؤلاء الذين كانوا يحرصون على الوجود في محاضراته العامة، وتلك التي كان يلقيها على طلبة الفلسفة، كما كانت له مكانة خاصة لدى المثقفين والأكاديميين خارج أسوار الجامعة، وبين المفكرين والأكاديميين والمثقفين العرب. وإلى جانب ذلك، كان يشارك في المؤتمرات واللقاءات الفلسفية، سواء في مصر أو تونس والجزائر والمغرب والخليج، وفي أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأميركية، حتى أصبح اسماً معروفاً على مستوى العالم العربي.
كانت لدى الدكتور الطيب علاقات احترام متبادل مع عديدين من رجال الدين المتنورين، ولم يكن يتهرّب من المناظرات والمناقشات، بل كان في مقدوره تناول أصعب الموضوعات مع أصحاب الرأي المختلف، أو المواقف المختلفة، وبموضوعيةٍ وهدوء، وكان يتشارك في هذه الخاصية مع الدكتور صادق. ونحن إذا عدنا إلى حواره مع الشيخ رمضان البوطي وحوار صادق مع كل من يوسف القرضاوي وحسن الترابي، ندرك مدى نضج علمين من أعلام الفكر اليساري العلماني السوري، بل والعربي بصورة عامة.
كان الدكتور الطيب يشدّد على ضرورة أخذ خصوصية الوضعية المشخصة بالاعتبار في أي
وكانت لديه شبكة واسعة من العلاقات مع المفكرين والباحثين العرب. كان الجميع يحترمه، وهو يقابل ذلك الاحترام بتواضعٍ غير مصطنع، وبساطةٍ طبيعيةٍ لا توصف. لم أسمع منه، في أي من جلساتي الكثيرة معه، كلمة واحدة سلبية بحق زملائه في القسم، وبحق المفكرين والباحثين السوريين والعرب، على الرغم من معرفته بأحكام بعضهم السلبية بحقه، وكان على صلة بباحثين شباب كثيرين، ويعقد الآمال على الباحثين الشباب. وحده محمد عابد الجابري كان عقدة العقد بالنسبة إلى الدكتور الطيب، ولكنه كان يتعامل مع فكر الجابري وليس شخصه، كان ينتقده من موقع معرفي بحثي.
وجاءت مرحلة الدكتوراه، وتعمّقت العلاقة أكثر مع الطيب، وقرأت كتبه الجديدة التي كان يصدرها تباعاً: "الفكر العربي في بواكيره وآفاقه الأولى، من يهوه إلى الله"، في مجلدين، "مقدمات أولية في الإسلام المحمدي الباكر نشأة وتاسيساً"، وغيرها. وعلى الرغم من الأحكام العامة التي كان يلجأ إليها، والثنائيات التي عرف بها، وتكراره بعض الموضوعات، من باب تأكيد أهمية تناولها، كانت كتب الطيب موضع ترحيب جمهور واسع، ليس في سورية وحدها، بل في معظم الدول العربية. ولعل الطبعات العديدة لمعظم كتبه تمثل مقياساً يُعتمد عليه في هذا المجال.
مع بدايات الثورة السورية، استغل الدكتور الطيب تيزيني مناسبة اللقاء التشاوري (10- 11 تموز/يوليو 2011) الذي دعا إليه النظام تحت اسم هيئة الحوار الوطني، وأداره نائب الرئيس فاروق الشرع، ليدعو إلى ضرورة وقف الحرب على السوريين، عبر تحريم سفك الدم السوري، ويطالب بإطلاق سراح المعتقلين. كما شدّد على ضرورة تفكيك الدولة الأمنية المهيمنة على مفاصل الدولة والمجتمع. ولم يكن هذا موقفا جديدا للدكتور طيب، بل أعلن عنه بكل وضوح ودقة منذ بدايات الثمانينيات، حينما قال: سابقاً كنا نتحدث عن أمن الدولة، والآن نتحدث عن دولة الأمن. شعار هذه الدولة إفساد من لم يُفسد بعد، وإدانة الجميع كي يكونوا تحت الطلب.
لم يكن الطيب هجومياً صدامياً، وذلك ينسجم مع موقعه مفكرا وباحثا. ومع ذلك، كان يريد التغيير، ويعمل على توعية الناس من خلال محاضراته وكتاباته. وربما أخذ عليه بعضهم قبوله بإلقاء المحاضرات ضمن منظمات حزب البعث أو كلية الأركان. وربما حتى انتسابه الاضطراي إلى حزب البعث (لم أسمع منه ما يؤكد ذلك)، ولكننا جميعاً نعلم أنه منذ تسلط حافظ الأسد على الحكم في سورية عام 1970، لم يعد هناك أي مجال لأي شخص أن يدرّس في الجامعة ما لم يكن عضواً في حزب البعث، أو حصل على موافقة الأجهزة الأمنية. ولكن الطيب لم يتنازل، ولم يتزلّف، ولم يتمكّن النظام من احتوائه كما فعل مع آخرين، يساريين وعلمانيين ومتدينيين.
في الثمانينيات، كان اسم تيزيني هو الأول بين المفكرين والمثقفين اليساريين، في حين أن اسم
في بداية الثورة، تواصلت معه، كان مسانداً داعماً. وتطورت الأمور، وتصاعدت الثورة. ولم يعد الاتصال مع الطيب ممكناً، حرصاً مني عليه. ولكنني كنت أتابع أخباره. وفي أثناء زيارة رسمية إلى برلين، مع وفد من المجلس الوطني السوري خريف عام 2012، تواصل معي الإخوة في قناة دويتشه فيله الألمانية من أجل إجراء حوار معمّق حول سورية، قلت لهم: سألبي الدعوة إذا كانت الظروف مساعدة. وفي الموعد المحدد، دق جرس الهاتف، وأخبروني من استعلامات الفندق أن صحافية تريد الحديث معي. قلت فلتتفضل، وجاء الصوت ليقول: أنا ريم تيزيني. لم أصدق أذني، فريم التي شاهدتها آخر مرة كانت طفلة مع والدتها الألمانية زوجة الدكتور الطيب، وذلك قبل مغادرتهم سورية في ظل ظروف صعبة. قالت أعرف طبيعة العلاقة المتميزة بينك وبين والدي. وأعرف مدى الاحترام المتبادل الذي هو بينكما، لذلك حرصت على أن آتي بنفسي، لنذهب سوية إلى القناة. وهذا ما كان. حمّلت ريم تحياتي الحارة لوالدها، وتميناتي له بالصحة المستمرة. وكان من بين أحلامي أن أعود يوماً إلى دمشق، وأزور أستاذي من جديد. ولكن الأحلام، حتى البسيطة منها، باتت مستحيلة التحقّق في واقعنا السوري بكل أسف.
يقول الكاتب السويدي، اليوناني الأصل، ثيودور كاليفاتيدس: مأساة المهاجر أنه يحنُّ باستمرار إلى العدم. يحنُّ إلى أشخاصٍ قد تغيروا، وإلى أماكن قد تغيرت. ولكن مأساتنا، نحن السوريين، أقسى وأشد، فنحن نحنُّ إلى أماكن لم تعد موجودة، وإلى أشخاصٍ نبلاء باتوا في العالم الآخر.
دلالات


عبد الباسط سيدا
كاتب وسياسي سوري، دكتوراه في الفلسفة، تابع دراساته في الآشوريات واللغات السامية في جامعة ابسالا- السويد، له عدد من المؤلفات، يعمل في البحث والتدريس.
عبد الباسط سيدا
مقالات أخرى
05 مارس 2024
20 فبراير 2024
06 فبراير 2024