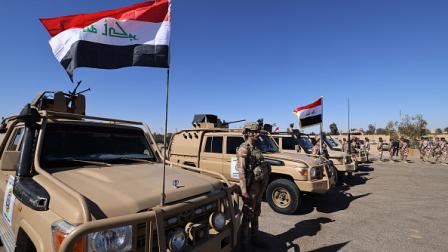الانتفاضات الشعبية: تناقض بين المطالب اليومية والمشروع الوطني
لم تتوقف المحاولات الاحتجاجية والهبات الشعبية في الأراضي الفلسطينية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، في وقت استمر الاحتلال الإسرائيلي في سياساته الهادفة إلى منع أي محاولة للتنظيم، أو التحرك الاحتجاجي العلني، وحظر إجراء أي انتخابات ديمقراطية في محاولة لتكريس واقع جديد، ومنع من خلال الأوامر العسكرية أي نشاطات ذات طابع سياسي.
وفي الواقع فإن العديد من الحركات الشعبية ولدت تحت مسميات مختلفة في ظل الاحتلال الإسرائيلي في سبعينيات القرن العشرين، منها النقابات العمالية والاتحادات النسوية والطلابية والتطوعية ذات الطابع الجماهيري والعلني التي شاركت في الاحتجاجات والمظاهرات التي كان من أبرزها يوم الأرض في 30 آذار 1976 كعنوان للدفاع عن الأرض، وكذلك لجنة التوجيه الوطني وغيرها، وأغلقت النقابات والأندية ومراكز الشباب، وكانت آخر انتخابات بلدية قد جرت في العام 1976، التي عبر فيها الشعب الفلسطيني عن إرادته، بانتخاب ممثلين وطنيين مؤكدين على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني ورفضه الإدارة المدنية، ما أغضب سلطات الاحتلال، الذي قام بإقالة العديد من رؤساء البلديات، ثم استقال معظم رؤساء البلديات كاحتجاج جماعي ضد سياسات الاحتلال. ومع ذلك مهدت هذه الحركات والاحتجاجات الشعبية الفلسطينية الطريق نحو الانتفاضة الشعبية الأولى، وإن بقيت التنظيمات الفلسطينية هي اللاعب والمحرك الأساسي في المواجهة، دون أن تشكل حراكاً ذا طابع جماهيري حقيقي، إذ اقتصر عملها في معظمه على النشطاء السياسيين والأعضاء في التنظيمات السياسية الفلسطينية التي كانت محظورة، وكانت مطالبها موجهة لمناهضة الاحتلال.
أدت هذه التراكمات إلى اندلاع الانتفاضة الشعبية الأولى التي شاركت فيها كل الحركات والمنظمات الجماهيرية بشكل عفوي أولا ثم ممنهج احتجاجاً على سياسات الاحتلال وممارساته القمعية، ولكن لم يمض وقت طويل حتى عادت الأحزاب والتنظيمات السياسية الفلسطينية التي كان معظمها خارج الوطن إلى العمل على احتواء فعاليات الانتفاضة الشعبية والسيطرة عليها. ولم تنجح هذه الحركات والمنظمات الشعبية في التحول الى حركات اجتماعية فاعلة، حيث أبقت على البعد السياسي كأولوية أساسية ضمن توازن القوى داخل الحركة الوطنية. وهذا يمكن تفهمه من خلال طبيعة العمل السري في ظل وجود سلطة الاحتلال، ما ساهم في الحد من تطور الحركات الجماهيرية والاجتماعية في الأراضي المحتلة، وبقيت الحركة الطلابية رغم عمليات القمع أحد الخطوط الأمامية في الحركة الوطنية الفلسطينية.
جاءت تسمية الانتفاضة الثانية كامتداد ومحاولة لإعادة نسخ ما جرى في الانتفاضة الأولى التي بدأت في العام 1987، في محاولة مكررة لاسترجاع الزخم الواسع والحماسة التي رافقت الانتفاضة الشعبية الأولى، التي تميزت بالمشاركة الجماهيرية الواسعة، ووصلت إلى كل بيت في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة رغم التواجد والسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، الذي فشل في إيقافها رغم استخدامه جميع وسائل التنكيل والقتل والاعتقالات، التي طاولت كل الأعمار والمهن، وكان حظر التجول المكثف أداة لمحاولة السيطرة على إرادة الفلسطينيين، ومع ذلك لم تنجح كل هذه الوسائل في وقف الانتفاضة التي استمرت لأكثر من خمس سنوات، ولكن الظروف المحيطة تغيرت كثيراً.
وبالنظر الى الوراء قليلاً نجد أن هذه الانتفاضة الشعبية والتي بدأت عفوية، تميزت بالدور الفعال للأحزاب والتنظيمات الفلسطينية التي تولت قيادتها، من خلال القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة واللجان التابعة لها، التي كانت تمثل الكل الفلسطيني، تحت شعار رفض الاحتلال وسياساته والدعوة إلى إنهاء الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية، بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وتجلى انحسار الدور الشعبي وتراجع المشاركة الشعبية في الانتفاضة الأولى أمام تقدم السيطرة التنظيمية للأحزاب السياسية، التي أخذت تمسك بزمام الأمور وتوجه البوصلة وتعطي التعليمات لحركة الجمهور الفلسطيني، الذي سار خلفها بإرادته وثقته بأن هذه القيادة السياسية يمكنها القيام بالدور القيادي الفعال نيابة عن الشعب الفلسطيني كله للوصول إلى إنهاء الاحتلال.
وللأسف فإن الظروف والعوامل الخارجية التي رافقت هذه الانتفاضة في تلك الفترة من احتلال الكويت من قبل العراق والانقسامات العربية أبعدت الأنظار قليلا عن الانتفاضة، وعمقت من الأزمة العامة في المنطقة العربية وتداعياتها على الموقف الفلسطيني، وبالتالي انخفاض الدعم المالي والمعنوي العربي للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ولم يمر وقت طويل حتى وقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع الحكومة الإسرائيلية، كان من نتائجها المباشرة إنشاء السلطة الفلسطينية، التي بدأت بالتصرف كدولة ذات سياده تسيطر على أقل من 20% من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبدأت في إقرار التشريعات وإدارة أحوال المواطنين الفلسطينيين، وبدأ التراجع الفعلي التدريجي لتأثير الأحزاب السياسية الرئيسة، سواء التي سيطرت على السلطة أو المعارضة، ما دفع العديد من القطاعات إلى العمل خارج الأطر السياسية، في سبيل تحقيق بعض المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ونشأت العديد من النقابات خارج الإطار النقابي الرسمي، وتضاعف عدد المؤسسات الأهلية العاملة في المجالات المختلفة، حيث شملت العديد من المجالات بينها حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية والزراعة والبيئة والإعلام، وكلها أقرب إلى البنى المحلية والقطاعية، لذا تراجع العمل الجماهيري السياسي، وتم التسليم بدور السلطة الفلسطينية كمحرك العملية السياسية الأساسي، وخاصة في موضوع المواجهة مع الاحتلال، وتحولت المطالب الحياتية نحو السلطة الفلسطينية.
في ذات الوقت شهد الوضع العالمي اتساعا في الحركات الشعبية مع تراجع الأحزاب السياسية التقليدية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، بداية من حراك مناصري البيئة والخضر الاجتماعي والشعبي ذي المطالب المحددة، الذي نجح في اجتذاب مناصرين كثر، لكنه كغيره من حركات احتجاجية مشابهة لم يتمكن من الاستمرار في ذات النهج، حيث لم يطل الزمن طويلا حتى تحول إلى أحزاب سياسية دخلت البرلمانات، كان أشهرها في ألمانيا. أما فلسطينيا فقد أخذت الحركات الاجتماعية والاحتجاجية في التقدم، في ظل تراجع الأحزاب السياسية عن دورها وانصهار معظمها في العمل الحكومي وتراجع دورها المؤثر سياسياً، بحيث أصبحت جزءا من المنظومة الحاكمة وابتعدت عن مطالب المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن ضعف تأثيرها السياسي منذ نشوء السلطة الفلسطينية.
ورغم كل ذلك فإن معظم التحركات واللجان والمنظمات الأهلية التي بدأت بالتوسع، كانت تهدف بالأساس إلى إيجاد موطئ قدم في العمل السياسي تحت مسميات كثيرة، لذا انحصرت الفعاليات والاحتجاجات في مناطق المسماة ألف ولم تتجاوزها.
وكان اختبار قدرة وسيطرة السلطة الأول في الموقف من الاحتجاجات التي اندلعت في العام 1996، بعد أقل من خمس سنوات على انتهاء الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى، التي سميت هبة النفق حيث عمت الاحتجاجات جميع الأراضي الفلسطينية، وواجهها الاحتلال بالقمع والسلاح، وما لبثت أن اخمدت على أمل أن تقوم السلطة الفلسطينية بالدور المطلوب نيابة عن المواطنين، وأصبح الاعتماد على السلطة الفلسطينية وأدواتها وأجهزتها هو الأساس في التعامل مع قضايا المجتمع ومواجهة الاحتلال، وتم التسليم بهذا الدور من قبل جميع القوى والحركات كأحزاب أو منظمات أهلية.
ولم يمض وقت طويل على إنشاء السلطة الفلسطينية حتى بدأت الحركات ذات الطابع الشعبي بالظهور، كرد فعل على قضايا وسياسات محلية مطلبية، مثل الحركات التي دعت إلى إجراء الانتخابات، والحركات المطالبة بالحق في التعبير واختيار ممثليهم كحراك معلمي الحكومة، من خلال لجان التنسيق في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. لكن لم ترتق هذه الاحتجاجات الموجهة إلى مستوى المطالب السياسية، وبقيت مرتبطة بمطالب محددة مثل الرواتب والعلاوات والترقيات، وما لبثت أن تلاشت تحت ضغط حكومي فلسطيني.
مع ذلك لم تتعلم الحركات الشعبية الفلسطينية من اعتمادها السياسي المفرط على السلطة الفلسطينية وحكومتها، ومن المراهنة على قدرة السلطة على التعامل مع المستجدات، وعلى الموازنة بين دور الدولة من جانب ومن جانب آخر مع دورها في التحرر من الاحتلال وبناء الدولة الموعودة. إذ تم غض النظر عن الكثير من العوامل المؤثرة والأصوات التي تنقد عمل السلطة، أي تم تجاهل الكثير من السلبيات. ثم لم تنته السنوات الست التالية على هبة النفق، حتى اندلعت الانتفاضة الثانية في 2002، التي بدأت بالاجتياح الشامل لجميع الأراضي الفلسطينية (تحت السيطرة الفلسطينية)، وتنفيذ سياسة القمع والقتل والتدمير البنى التحتية وغيرها، لكن اقتصرت الاحتجاجات على المواجهات التي قامت بها التشكيلات العسكرية، ولم تتحول إلى حركات شعبية، وكان من نتيجتها تكريس دور السلطة خارج أطر التنظيمات الرسمية، التي أبقت على مسافة من التباعد بوعي واضح من التنظيمات الفلسطينية للنأي بنفسها عن تبني هذا الشكل من العمل والنضال، الذي كان يمكن أن يعرض مصالحها ومكاسبها إلى الخطر، وفي نفس الوقت ساهمت في ابتعاد الجمهور عن الفعل والاحتجاج.
وجاءت تسمية الرد على الاجتياح الإسرائيلي (الذي اعتبره البعض مفاجئاً) للمناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، بالانتفاضة الثانية في محاولة للتخفيف من حجم الكارثة، وبغرض استنهاض الشعب وتكرار سيناريو الانتفاضة الأولى من المشاركة الشعبية في مواجهه الاحتلال، خاصة أن معظم من هم في السلطة من الداخل الفلسطيني كانوا من النشطاء في الانتفاضة الأولى، متناسين المتغيرات التي أحدثها اتفاق أوسلو من خيبة الأمل، وابتعاد حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، التي أظهرت بوضوح أن الوضع السياسي أخذ بالتحول إلى مجريات أخرى مختلفة، خاصة منذ اغتيال رابين في نهايات العام 1994، حيث أصبح واضحاً موقف الحكومة الإسرائيلية من عملية السلام، وعدم استعدادها التخلي عن الأراضي المحتلة المفترض أن يتم بناء الدولة الفلسطينية العتيدة عليها.
وأخيرا يمكن القول إن اتفاقية أوسلو وتداعياتها المختلفة قد خلقت وضعاً متناقضاً في بنية الحركات الاجتماعية والشعبية، يتجلى في علاقتها مع الواقع الجديد، حيث كانت في السابق تعرف دورها ضمن المشروع الوطني، من خلال تأجيل الاحتياجات المطلبية لصالح المشروع الوطني، لكنها اليوم بل خلال السنوات التي تلت أوسلو، قد جسدت معادلة جديدة تعكس تراجع الدور السياسي لصالح التركيز على الحركات المطلبية، خاصة مع ظهور العديد من القطاعات الجديدة مثل البنوك وشركات التأمين، ومع توسع قطاع الخدمات الذي ترافق مع تضخم عدد موظفي الحكومة. أي برز مظهر جديد من التحركات المطلبية في القضايا الاجتماعية والاقتصادية اليومية، التي تهم حياة الناس مثل الصحة والتعليم والعمل والحماية من البطالة وغيرها، وأدت الى تأسيس العديد من النقابات، منها نقابة الوظيفة العمومية والاتحادات الشبابية للعمل على القضايا المطلبية للعاملين، ذات طابع احتجاجي اقتصادي وسياسي داخلي.
بالتالي أصبح واضحاً أن الحركات والاحتجاجات لم تعد تضع في أولوياتها معاداة الاستعمار أو إنهاء الاحتلال، بل أصبحت حركات مطلبية أو احتجاجات على سياسات السلطة الفلسطينية. وقد ظهر ذلك جلياً في الانتفاضة الثانية، التي جسدت التناقض بين إنهاء الاحتلال واستمرار المقاومة العنيفة، التي جاءت مع تراجع دور الأحزاب السياسية التقليدية والرسمية، أو تغييب دورها بسبب عوامل ذاتية وأخرى مرتبطة بالوعي العام وانعكاف المواطنين وانشغالهم بالحياة اليومية، وارتهان الموضوع السياسي في يد السلطة التي عززت هذا التوجه. ما ساهم في بقاء التناقض بين بناء حركات شعبية ضد سلطة تعتبر نفسها محتكرة الموضوع السياسي، والتحركات الشعبية التي لديها مطالب حياتية، إذ لم يتم حل هذا الإشكال حتى الآن بعد مرور عشرين عاماً على الانتفاضة الثانية، وللأسف فإن تناقض موقف السلطة الفلسطينية سياسيا ومطلبيا ساهم في تعزيز هذا التناقض بدلا من رأبه.