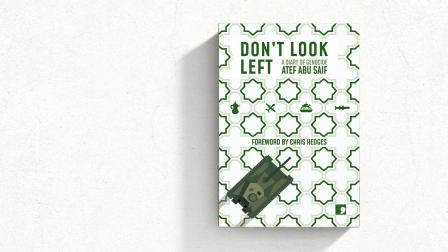هيلين بيسّيت.. اسمٌ يخرج من النسيان
من الصُّدَف ما قد يغيّر حياة كتّابٍ وكُتُب. لا نعرف إن كانت صُدَفٌ كهذه قد حوّلت في مسار هيلين بيسّيت عندما كانت ما تزال على قيد الحياة، لكنّنا نستطيع التأكيد أنّ منها مَا غيّر في حياة كُتُبها. الصدفة، هنا، هي سَنة ميلاد الكاتبة الفرنسية: 1918. ذلك أنه بعد دخول بيسّيت حيّز النسيان لسنواتٍ طويلة (حتى قبل رحيلها عام 2000)، جاءت مئوية ولادتها، قبل ثلاثة أعوام، لتُخرجها من تلك الظُّلمات.
تذكّرَتْها، في تلك المناسبة، دورُ نشرٍ كُبرى وصُغرى في فرنسا، واستعادتْها الصحافة ووسائل الإعلام الأُخرى. ومنذ 2018 وحمّى إعادة نشر أعمالها وتناوُل تجربتها لا تتوقّف ــ وهي حمّى حميدة على أيّة حال. مثلاً: في الشهرين الماضيين فقط، أُعيد إصدار كتابين لها، من بينهما "مرثاة لفتاة ترتدي الأسود" الذي صدر لدى منشورات "نو" المعروفة بوضع كُنية الكاتب فحسب على أغلفة كتبها، باعتبارها لا تطبع إلا لأسماء متفرّدة ومعروفة؛ كما استعادتْها، مطلعَ العام، "المكتبة الوطنية الفرنسية" ضمن سلسلة فعاليات عن الكاتبات المنسيات، في أحين عادت صحيفة "لوموند" إلى تجربتها بمقال مطوّل نُشر أخيراً ضمن سلسلة مشابهة عن شخصيات فرنسية نسائية غطّى عليها النسيان.
تأتي الصُّدفة هنا لتُعيد إلى تجربةٍ أدبية حقَّها أو جزءاً منه، بعد أن "رفضَ" التاريخ، أكثر من مرّة، ضمّ اسمَها إلى صفحاته: رُشّحت أعمال لها مرّتين لنيل جائزتي "غونكور" و"ميديسيس" لكنّها لم تنلْ أيّاً منهما؛ ولم يحفظ اسمَها مَن كتبوا وأرّخوا عن الرواية الجديدة، رغم أنها كانت ممّن زرعوا بذرة هذا التيّار الأدبي، قبل أن تنتقل إلى مساحات كتابية جديدة.
طوى النسيان أعمالها أربعة عقود ثم عادت إلى الواجهة
بدأت بيسّيت بنشر نصوص سردية في إحدى الدوريات المغمورة خلال إقامتها مع زوجها في كاليدونيا الجديدة، بين منتصف ونهاية الأربعينيات من القرن الماضي. ثم سرعان ما رُشّح اسمها لـ"غاليمار"، التي وقّعت معها عقداً لنشر عشر روايات لها. "لِيلي تبكي" (1953) كانت أولى ثمار هذا العقد، وهي رواية قائمة على قصّة قد تكون مألوفة (فتاة تعاني من طغيان أمها)، لكنها كُتبت بلغة وأسلوب لم يكونا مألوفين حينها في الرواية الفرنسية، حيث التخلّي عن الجمل الوصفية الاعتيادية والبنية الحوارية التقليدية، والالتفات إلى معجم شعريّ يلمّح بدلاً من أن يصف، يعبّر بجمل قصيرة تشبه ضربات فرشاة سريعة على لوحة، وتختلط فيه الأصوات بحيث لا يعرف القارئ أحياناً مَن يتحدّث. ستأتي روايات بيسّيت اللاحقة لتذهب بعيداً في هذا الأسلوب، حدّ أن الكاتبة ستُطلق على سردها تسمية "روايات شعرية"، ناسبةً، في الوقت نفسه، رؤيتها للأدب إلى أعمال فرجينيا وولف وجيمس جويس.
لكنْ، رغم نشرها 13 رواية، خلال عشرين عاماً (بين 1953 و1973)، لدى أبرز دار نشر فرنسية، هي "غاليمار"، ورغم المديح الذي نالته أعمالها من عددٍ من الكتّاب البارزين فرنسياً في القرن العشرين، مثل ريمون كينو ومارغريت دوراس ("هيلين بيسّيت هي الأدب الحيّ، بالنسبة إليّ، في هذه اللحظة، ولا أحد غيرها في فرنسا"، قالت عنها دوراس)، فإنّ النسيان غطّى الكاتبة بشكل شبه كلّي منذ نشر روايتها الأخيرة لدى "غاليمار": "إيدا أو الهلوسة". إذ مرّت عقودٌ أربعة، أو أكثر بقليل، قبل أن تُصدر دار نشر فرنسية كتاباً لها ("سعادةُ الليل"، منشورات "ليو شير"، 2006).
ثمّة أكثر من قراءة تحضر، هنا، لشرح هذا المصير. بعض النقّاد الذين توقّفوا عند هذه المفارقة ذكّروا بالبُعد بين أجواء النشر الباريسية، "البرجوازية"، وما تتطلّبه من نشاطٍ اجتماعيّ وشِلَلي لأيّ كاتب يُريد صناعة اسم على الساحة الأدبية، وبين خلفية بيسّيت الاجتماعية، وهي القادمة من عائلة فقيرة والمشتغِلة في مهَن مثل تنظيف المنازل أو حِراسة المباني، إضافة إلى تربية أبنائها. وتُذكَر في هذا السياق عبارةٌ قالتها دوراس في لقاء إذاعي لها، محاولةً شرح غياب اسم بيسّيت عن الساحة الأدبية الفرنسية: "لا يمكن لكتابٍ أن يصدر من تلقاء نفسه... فهو دائماً ما يأتي في سياقٍ معيّن. حتّى أكثر الكتب تفرّداً واختلافاً، قد تأتي كتبٌ أُخرى لتحول دون انتشاره".
على أن المظلومية ليست التعبير الوحيد عن حالة المؤلّفة. إذ لا بدّ من التذكير برفضها المتكرّر لدُخول لعبة السُّلطة في نُسختها الأدبية. تكتب في إحدى رسائلها إلى دار "غاليمار" التي قرّرت التوقف عن نشر أعمالها: "من المؤسف أن أجد نفسي مضطرّة، منذ سنوات، لترجّيكم كما لو كنتم آلهة".
كانت مارغريت دوراس من أبرز المتحمسين لكتابتها
هذه العصامية تحمل، في سياق الحديث عن بيسّيت، أسماءً أُخرى يحاول البعض من خلالها شرح تجاهُلها. فما يراه البعض موقفاً مبدئياً من عوالم النشر ولعبة السلطة، يسمّيه البعض الآخر تعالياً أو غرابةً في الشخصية، أو حتى جنوناً. وهو أمرٌ لم يطرأ على صاحبة "البرج" في وقت متأخّر من تجربتها، بل رافقها منذ نشر كتابها الأوّل، إذ وصفتها "غاليمار"، على غلاف روايتها "لِيلي تبكي" (1953) بأنها "ذات طَبعٍ نادر وغير مألوف".
ورغم أن هذا الوصف قد يحمل مصداقيةً في جانب منه (تكفي العودة إلى السيرة التي تركتها بيسّيت بعنوان "لا يعيش المرء إلّا حياتَيْن"، وإلى مراسلاتها، لالتقاط شيءٍ من طبعها "النادر" هذا، ومن مزاجها المتقلّب، وشخصيتها المراوحة بين اعتزاز بالنفس وإحساس مفرط بالمظلومية يُشبه إحساس روسو بـ"مؤامرة" تُحاك ضدّه)، إلّا أنه فتح الباب على تأويلاتٍ تُحمّل الكاتبة نفسَها مسؤوليةَ اندثار أثرها لسنوات.
إضافة إلى هاتين القراءتين ـ السببَيْن، يمكن الإشارة أيضاً إلى لغة الكاتبة وأسلوبها التجريبي، الذي قد لا يروق مَن يريد من الرواية أن تُخبره حكايةً بطريقة معتادة. فصاحبة "الطريق الأزرق" (1960) تدفع بالسرد إلى حدود الشعر تارة، وإلى التداعي الحرّ وتقلُّباته تارةً أُخرى، ضاربةً بعرض الحائط أغلبَ المعايير الشائعة في ما يخصّ البُنية السردية والحوارية وتشكيل الشخصيات، وهو ما يجعل قراءة واحدة من رواياتها عملاً شاقّاً لدى عدد لا بأس من القرّاء.
رغم ذلك، قد تكون "حمّى" العودة إلى رواياتها، وإعادتها إلى الضوء في الآونة الأخيرة، دليلاً على عدم صِحّة هذه المقولة، أو على نسبيّتها، بحيث يكون السببان المذكوران أعلاه أكثر دقّة في شرح غياب اسمها لعقود من الساحة الأدبية الفرنسية.