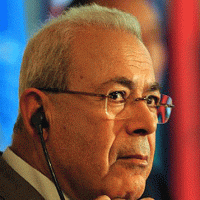27 يونيو 2024
مهمة موسكو المستحيلة في سورية
يحدث أن يزور سوريون أو أجانب دمشق، فيرون أمامهم سيارات تسير، ومارّة يتحادثون ويضحكون، ومحلات عامرة بالخضار أو الفواكه، فيعودون إلى بلدانهم، ويقولون إن الأمور على ما يرام، وقد انتهت الحرب وحل السلام. هذا ما يحاول الوزير الروسي، سيرغي لافروف، أن يقنع به أيضا الدول الصناعية، المستودع الأكبر للأموال والرساميل الباحثة عن استثمارات وعقود وصفقات، حتى تنخرط معه في عملية إعادة الإعمار التي يطمح من خلالها إلى الحصول على الموارد اللازمة، لتسيير نظام الأسد المنهار، وتغطية تكاليف الاحتلال الروسي، وإرضاء الحلفاء الإيرانيين الذين يعيشون أكبر ضائقة مالية، بعد فرض العقوبات الأميركية الجديدة، وانهيار سعر صرف العملة، وانفجار الغضب الشعبي على سياسات الولي الفقيه، ورفع شعارات إسقاط الديكتاتور في المسيرات الاحتجاجية الشعبية المستمرة من دون توقف منذ أسابيع.
صحيحٌ أن النظام نجح، بمساعدة الروس والإيرانيين، لا ينبغي أن ننسى ذلك أبدا، أي ليس بقواه الذاتية وقدرته على التنظيم وتوفير الموارد الضرورية، في حسم المرحلة الأولى من الحرب لصالحه، لكن الحرب لم تنته بعد، ولن تنتهي، كما يدلّ على ذلك سلوك النظام نفسه، ليس في المناطق التي لم يضمن بعد إلحاقها الكامل بمناطق سيطرته، ولكن في مناطق حكمه التي تتعرّض باستمرار لتفجيرات ومنازعات وحروب محلية بين أنصاره والمليشيات التي يستند إليها للاستمرار بالبقاء. بل أكثر من ذلك، بسبب استمراره في تطبيق سياسة فرّق تسد وزرع الفتنة بين أطياف الشعب وطوائفه، حتى يضمن لنفسه تحييد فئات المجتمع وجماعاته، واحدتها بالأخرى، ويخفّف من أعباء قمعه المباشر، ويعوّض عن نقص الجنود والمادة البشرية التي يحتاجها لترميم قواته التي ذابت في نار المعارك التي أطلقها، متأملا أن يقطف ثمار النزاعات الاهلية مناشداتٍ لبقائه في السلطة من الناس ذاتهم الذين عانوا من قهره وتنكيله. هذا هو
الوضع تماما في مدينة السويداء جنوب سورية التي نصب لها "الرئيس" فخا لا تزال تبحث عن المخرج منه، بعد أن نزع من سكانها أسلحتهم الشخصية، ونقل الدواعش من حوض اليرموك في دمشق إلى البادية القريبة منهم، وغطّى هجومهم على المدينة، قبل أن يرمي التهمة على العشائر البدوية المحيطة بها، لإعادة مناخ الحرب التقليدية بين الجماعتين، والتدخل باسم الأمن والتهدئة، ووضع اليد على المدينة، وإجبار شبابها على الالتحاق بقواته، بعد قرار شيوخها وقادتها المحليين برفض مشاركتهم في معارك ضد إخوانهم السوريين في الجبهات الأخرى، والاقتصار على حماية مدينتهم من الاعتداءات الخارجية، وردّا أيضا على رفض سكان المدينة شراء منتجات التعفيش، أي منهوبات المليشيات الأسدية من درعا ومحافظتها، كما جرت العادة بقرار من النظام نفسه.
ومع ذلك، لا يتعلق رفض الدول الأوروبية تلبية الطلب الروسي بشكّهم في مقدرة النظام على حسم المعركة في أغلب المناطق السورية، بما في ذلك في مناطق الشمال والشمالين الشرقي والغربي، ضد ما تبقى من مناطق المعارضة، وتلك التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، القائد لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، فليس لدى الروس أي حرصٍ على تجنّب الكارثة في إدلب ونواحيها، ولا لدى الأميركيين التزام بحماية سلطة "قسد" الكردية، أو بتحويل منطقة سيطرتها إلى قاعدةٍ ثابتة لنفوذهم. كما لا يتعلق بعدم ثقة الدول الغربية في إمكانية حل مشكلة اللاجئين، في إطار إعادة تأهيل النظام القائم، ومن دون التّقدّم في عملية انتقال سياسي، لا يزالون مصرّين عليها لضمان الحد الأدنى من الشروط السياسية والأمنية الضرورية للاستثمار والإعمار، والبدء بمعالجة أوضاع ملايين النازحين والمشرّدين داخل سورية نفسها، ومعرفة مصير ملايين المساكن المدمرة المهدّدة بالاستملاك من الدولة وأنصارها بالقانون رقم 10 الذي صدر هذا العام، وأوضاع المدن المزروعة بالألغام التي يصعب على المدنيين العودة إليها. المشكلة أكبر من ذلك وأعمق، وأكثر إشكالا بكثير، وهي تفسخ النظام القائم ذاته وانحلاله، حتى داخل المناطق التي تقع تحت سيطرته، وتضم الجزء الأكبر من السكان، وحلول نظام آخر مكانه، هو ذاك النظام الذي أقامته المليشيات المحلية، والذي تسهر عليه، وتخضع من خلاله المجتمعات المحلية لسلطتها ومصالحها وأهوائها. وهذا ما يطرح تحدياتٍ لا أحد يدري كيف يمكن مواجهتها، لا أصحاب "النظام" الرسمي، ولا حماتهم من الروس والإيرانيين، ولا المتعاطفون معهم من الدول الغربية والعربية.
أول هذه التحدّيات التي تكاد تصبح مستحيلة الحل دمار الآلة لإنتاجية، الصناعية والزراعية والتجارية معا، وما يعنيه ذلك من فقدان آلاف فرص العمل، واستحالة إحداث الجديد منها، وذوبان الأجور والموارد، حتى لم يبق في الاقتصاد قطاع مزدهر سوى اقتصاد االغزو القائم على التعفيش، وفرض الخوات وسرقة موارد الدولة، وتفكيك البنى التحتية ونهبها من قادة النظام ومليشيات دفاعه وحماته أنفسهم.
والثاني زوال المجتمع من حيث هو عضوية حية ومتفاعلة، وانقسامه إلى قطائع، داخل المدينة الواحدة، بين موالين ومعارضين، لا يجمع بينهم سوى الحقد والكراهية، وإرادة الانتقام، مع اعتقاد الموالين، أو القسم الأكبر منهم، أن كل ما يملكه خصومهم أو معارضوهم هو غنيمة شرعية لهم، وتعويض محدود عن التضحيات التي قدّموها لبقاء الأسد والنظام، ولا يتردّدون عندما تسنح الفرصة في تجريد الناس من أملاكهم ومواردهم. كما أن تأجيج الانقسامات الطائفية والمذهبية، وتأليب الطوائف المختلفة، أو القوميات المتعايشة بعضها على بعض، أدّى إلى تكوين مجتمعات محلية منطوية على نفسها، تعيش خائفة بعضها من بعض، وإلى إجبار الأفراد على الالتحاق بطوائفهم وعصبياتهم الأهلية، بحثا عن الحدّ الأدنى من الحماية والتضامن الإنساني.
والثالث الغياب الكامل لحكم القانون، مع تسليم الأمن في الأحياء والمدن والقرى لمليشيات الدفاع الخاصة، أي اللاوطنية التي تستخدم كل وسائل التشبيح والتهديد والابتزاز، لتعظيم مواردها، وتتصارع فيما بينها على اقتسام مناطق النفوذ، ومصادر العيش الضيئلة التي بقيت لدى السكان والمجتمعات المحلية.
أما التحدّي الرابع، فهو انهيار النظام الأمني وتفكّكه إلى درجةٍ لم يعد للنظام نفسه قدرة على ضمان أي اتفاق أو التزام، ولا حتى مع المساعدة الكبيرة لحلفائه الروس. ولم يبق في أيدي جماعة النظام لترويع السكان وفرض الإذعان عليهم سوى وضعهم تحت خطر التفجيرات وعمليات الاغتيال والاعتقال الدائمة، بينما تكاد تخلى القرى والمدن من الرجال في سن حمل السلاح.
هكذا، باستثناء القلة الضعيفة من أثرياء الحرب ومفترسي العباد والاقتصاد، ما يميز حياة السوريين اليوم في مناطق النظام هو الجمع بين حياة الفقر والبؤس والبطالة وغياب الأمن والخضوع لسلطة المليشيات التشبيحية وقانونها، والخوف المتبادل لدى السكان، بعضهم من بعض، ومن النظام وحلفائه، وانعدام أي ثقةٍ في المستقبل، أو في عودة الهدوء والأمن. يعزّز من هذا المناخ السياسي والاجتماعي المأساوي استمرار الصراع الإقليمي والدولي، وتمسّك كل طرف من الدول المنخرطة في النزاع بمشاريعها الخاصة، في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها.
لا يملك الروس، ولا الإيرانيون، القدرة والإمكانات والموارد، لمساعدة النظام على مواجهة هذه الأوضاع التي سيزداد الشعور بكارثيتها مع انقشاع دخان الحرب والعودة النسبية إلى ما يشبه
الحالة الطبيعية، كما هو الحال في قسم من الأراضي الخاضعة لسلطة الأسد. ولن يستطيع الروس، من دون قوة عسكرية كبيرة، لا يريدون المغامرة بإرسالها، السيطرة على المناطق وإخراجها من تحت سيطرة المليشيات التي تتصرّف على أنها ربحت الحرب، وأنها هي بالتالي صاحبة الحق بالتصرّف في أملاك الشعب المهزوم وأرزاقه، والبتّ في تقرير مصيره على مستواها المحلي. أما الرهان لمواجهة هذا الوضع على المليشيات المموّلة من إيران، كما هو الحال اليوم، فهو يعني معالجة الداء بالداء نفسه، وتعميق المشكلة بدل حلها. وإذا لم ينجح سيرغي لافروف في تأمين الدعم الغربي لإعادة الإعمار، أي لتمويل ما تبقى من الحرب وإدارة الاحتلال، ولن ينجح، لن تزيد مكاسب النظام العسكرية سوى في تعميق أزمته السياسية، وإظهار الجوهر الوحشي والمأساوي لخياراته الاستراتيجية، وتضييق الخناق عليه، ومحاصرته بالقضايا الأساسية التي أعلن على شعبه الحرب من أجل التغطية عليها.
يعرف الروس أنهم يضحكون على أنفسهم، وعلى العالم، عندما يتحدّثون عن إعادة الإعمار. لكنهم يعتقدون أن بإمكانهم خداع الغرب، للحصول على الموارد الضرورية لإنقاذ النظام المتهاوي الذي قدّم لهم سورية على طبق من ذهب. والحال لن ينجح الروس، ولا غيرهم، مهما فعلوا، في إنقاذ نظامٍ لا يصلح، وغير قابل للإصلاح، فشلت دول عديدة قبلهم في مساعدته، لأنه قائم على منطق الغزو، والنهب والسلب والاستيلاء، ولا يقبل أي تقاسم أو شراكة مع السكان والمحكومين، ويرفض أي مساومةٍ على حقه في الاحتكار الكامل للسلطة والثروة والنفوذ، ولا يعرف التعامل بغير منطق القوة والعنف الذي يسقيه يوميا لمحكوميه من دون حساب، حتى وهو يعاني سكرات الموت.
لا ينبغي للسوريين انتظار الحل من أحد. وليس في مصلحة الروس، ولا الإيرانيين، إنهاء النظام الذي انتنزع جيل الثورة الأول، ببطولاته وتضحياته اللامحدودة روحه الخبيثة، وحوله جثة هامدة، تفوح رائحة تفسّخها اليوم كل الأنحاء وتتآكلها الديدان. لكن في الوقت نفسه، لن يدخل الركام المتفسخ من تلقاء نفسه في حفرته الأخيرة. هذه وظيفة المعارضة، والمهمّة التاريخية التي تنتظرها.
صحيحٌ أن النظام نجح، بمساعدة الروس والإيرانيين، لا ينبغي أن ننسى ذلك أبدا، أي ليس بقواه الذاتية وقدرته على التنظيم وتوفير الموارد الضرورية، في حسم المرحلة الأولى من الحرب لصالحه، لكن الحرب لم تنته بعد، ولن تنتهي، كما يدلّ على ذلك سلوك النظام نفسه، ليس في المناطق التي لم يضمن بعد إلحاقها الكامل بمناطق سيطرته، ولكن في مناطق حكمه التي تتعرّض باستمرار لتفجيرات ومنازعات وحروب محلية بين أنصاره والمليشيات التي يستند إليها للاستمرار بالبقاء. بل أكثر من ذلك، بسبب استمراره في تطبيق سياسة فرّق تسد وزرع الفتنة بين أطياف الشعب وطوائفه، حتى يضمن لنفسه تحييد فئات المجتمع وجماعاته، واحدتها بالأخرى، ويخفّف من أعباء قمعه المباشر، ويعوّض عن نقص الجنود والمادة البشرية التي يحتاجها لترميم قواته التي ذابت في نار المعارك التي أطلقها، متأملا أن يقطف ثمار النزاعات الاهلية مناشداتٍ لبقائه في السلطة من الناس ذاتهم الذين عانوا من قهره وتنكيله. هذا هو
ومع ذلك، لا يتعلق رفض الدول الأوروبية تلبية الطلب الروسي بشكّهم في مقدرة النظام على حسم المعركة في أغلب المناطق السورية، بما في ذلك في مناطق الشمال والشمالين الشرقي والغربي، ضد ما تبقى من مناطق المعارضة، وتلك التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، القائد لقوات سورية الديمقراطية (قسد)، فليس لدى الروس أي حرصٍ على تجنّب الكارثة في إدلب ونواحيها، ولا لدى الأميركيين التزام بحماية سلطة "قسد" الكردية، أو بتحويل منطقة سيطرتها إلى قاعدةٍ ثابتة لنفوذهم. كما لا يتعلق بعدم ثقة الدول الغربية في إمكانية حل مشكلة اللاجئين، في إطار إعادة تأهيل النظام القائم، ومن دون التّقدّم في عملية انتقال سياسي، لا يزالون مصرّين عليها لضمان الحد الأدنى من الشروط السياسية والأمنية الضرورية للاستثمار والإعمار، والبدء بمعالجة أوضاع ملايين النازحين والمشرّدين داخل سورية نفسها، ومعرفة مصير ملايين المساكن المدمرة المهدّدة بالاستملاك من الدولة وأنصارها بالقانون رقم 10 الذي صدر هذا العام، وأوضاع المدن المزروعة بالألغام التي يصعب على المدنيين العودة إليها. المشكلة أكبر من ذلك وأعمق، وأكثر إشكالا بكثير، وهي تفسخ النظام القائم ذاته وانحلاله، حتى داخل المناطق التي تقع تحت سيطرته، وتضم الجزء الأكبر من السكان، وحلول نظام آخر مكانه، هو ذاك النظام الذي أقامته المليشيات المحلية، والذي تسهر عليه، وتخضع من خلاله المجتمعات المحلية لسلطتها ومصالحها وأهوائها. وهذا ما يطرح تحدياتٍ لا أحد يدري كيف يمكن مواجهتها، لا أصحاب "النظام" الرسمي، ولا حماتهم من الروس والإيرانيين، ولا المتعاطفون معهم من الدول الغربية والعربية.
أول هذه التحدّيات التي تكاد تصبح مستحيلة الحل دمار الآلة لإنتاجية، الصناعية والزراعية والتجارية معا، وما يعنيه ذلك من فقدان آلاف فرص العمل، واستحالة إحداث الجديد منها، وذوبان الأجور والموارد، حتى لم يبق في الاقتصاد قطاع مزدهر سوى اقتصاد االغزو القائم على التعفيش، وفرض الخوات وسرقة موارد الدولة، وتفكيك البنى التحتية ونهبها من قادة النظام ومليشيات دفاعه وحماته أنفسهم.
والثاني زوال المجتمع من حيث هو عضوية حية ومتفاعلة، وانقسامه إلى قطائع، داخل المدينة الواحدة، بين موالين ومعارضين، لا يجمع بينهم سوى الحقد والكراهية، وإرادة الانتقام، مع اعتقاد الموالين، أو القسم الأكبر منهم، أن كل ما يملكه خصومهم أو معارضوهم هو غنيمة شرعية لهم، وتعويض محدود عن التضحيات التي قدّموها لبقاء الأسد والنظام، ولا يتردّدون عندما تسنح الفرصة في تجريد الناس من أملاكهم ومواردهم. كما أن تأجيج الانقسامات الطائفية والمذهبية، وتأليب الطوائف المختلفة، أو القوميات المتعايشة بعضها على بعض، أدّى إلى تكوين مجتمعات محلية منطوية على نفسها، تعيش خائفة بعضها من بعض، وإلى إجبار الأفراد على الالتحاق بطوائفهم وعصبياتهم الأهلية، بحثا عن الحدّ الأدنى من الحماية والتضامن الإنساني.
والثالث الغياب الكامل لحكم القانون، مع تسليم الأمن في الأحياء والمدن والقرى لمليشيات الدفاع الخاصة، أي اللاوطنية التي تستخدم كل وسائل التشبيح والتهديد والابتزاز، لتعظيم مواردها، وتتصارع فيما بينها على اقتسام مناطق النفوذ، ومصادر العيش الضيئلة التي بقيت لدى السكان والمجتمعات المحلية.
أما التحدّي الرابع، فهو انهيار النظام الأمني وتفكّكه إلى درجةٍ لم يعد للنظام نفسه قدرة على ضمان أي اتفاق أو التزام، ولا حتى مع المساعدة الكبيرة لحلفائه الروس. ولم يبق في أيدي جماعة النظام لترويع السكان وفرض الإذعان عليهم سوى وضعهم تحت خطر التفجيرات وعمليات الاغتيال والاعتقال الدائمة، بينما تكاد تخلى القرى والمدن من الرجال في سن حمل السلاح.
هكذا، باستثناء القلة الضعيفة من أثرياء الحرب ومفترسي العباد والاقتصاد، ما يميز حياة السوريين اليوم في مناطق النظام هو الجمع بين حياة الفقر والبؤس والبطالة وغياب الأمن والخضوع لسلطة المليشيات التشبيحية وقانونها، والخوف المتبادل لدى السكان، بعضهم من بعض، ومن النظام وحلفائه، وانعدام أي ثقةٍ في المستقبل، أو في عودة الهدوء والأمن. يعزّز من هذا المناخ السياسي والاجتماعي المأساوي استمرار الصراع الإقليمي والدولي، وتمسّك كل طرف من الدول المنخرطة في النزاع بمشاريعها الخاصة، في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها.
لا يملك الروس، ولا الإيرانيون، القدرة والإمكانات والموارد، لمساعدة النظام على مواجهة هذه الأوضاع التي سيزداد الشعور بكارثيتها مع انقشاع دخان الحرب والعودة النسبية إلى ما يشبه
يعرف الروس أنهم يضحكون على أنفسهم، وعلى العالم، عندما يتحدّثون عن إعادة الإعمار. لكنهم يعتقدون أن بإمكانهم خداع الغرب، للحصول على الموارد الضرورية لإنقاذ النظام المتهاوي الذي قدّم لهم سورية على طبق من ذهب. والحال لن ينجح الروس، ولا غيرهم، مهما فعلوا، في إنقاذ نظامٍ لا يصلح، وغير قابل للإصلاح، فشلت دول عديدة قبلهم في مساعدته، لأنه قائم على منطق الغزو، والنهب والسلب والاستيلاء، ولا يقبل أي تقاسم أو شراكة مع السكان والمحكومين، ويرفض أي مساومةٍ على حقه في الاحتكار الكامل للسلطة والثروة والنفوذ، ولا يعرف التعامل بغير منطق القوة والعنف الذي يسقيه يوميا لمحكوميه من دون حساب، حتى وهو يعاني سكرات الموت.
لا ينبغي للسوريين انتظار الحل من أحد. وليس في مصلحة الروس، ولا الإيرانيين، إنهاء النظام الذي انتنزع جيل الثورة الأول، ببطولاته وتضحياته اللامحدودة روحه الخبيثة، وحوله جثة هامدة، تفوح رائحة تفسّخها اليوم كل الأنحاء وتتآكلها الديدان. لكن في الوقت نفسه، لن يدخل الركام المتفسخ من تلقاء نفسه في حفرته الأخيرة. هذه وظيفة المعارضة، والمهمّة التاريخية التي تنتظرها.