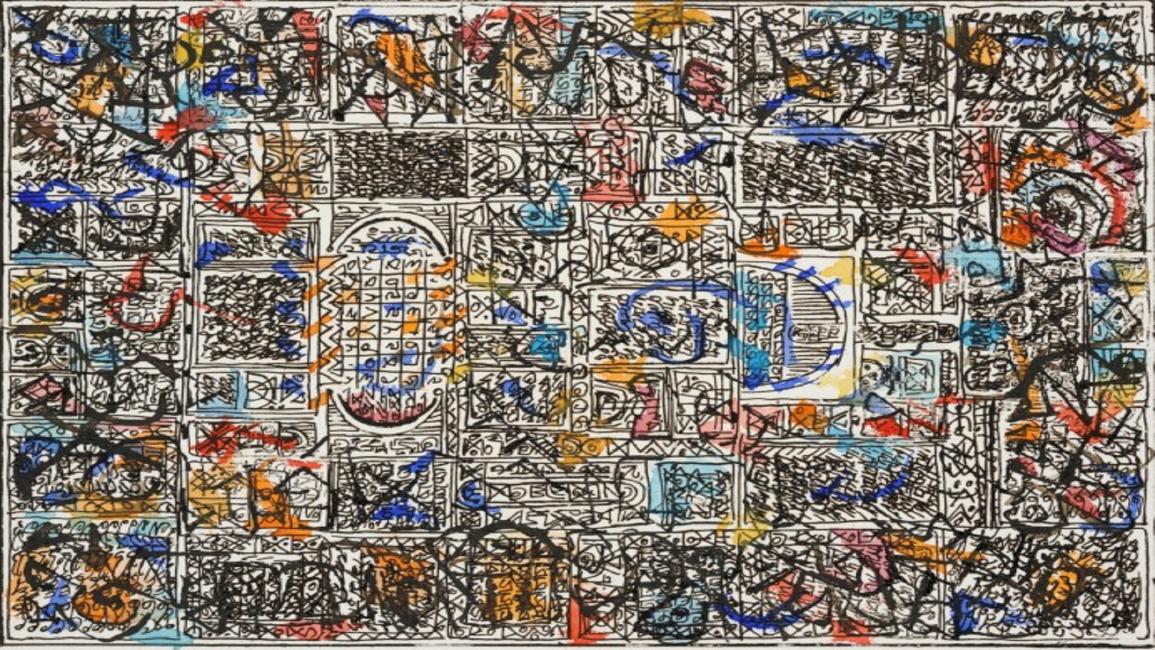14 مايو 2024
العقل والنّقل – ثُنائيّة الافتراق تُراثاً وحاضراً

خالد الجبر
(محجوب بن بلة)
هل يضرُّ تبسيطُ إشكال علاقتنا بالتّراث وحضوره الممتدّ، واختزالُه بالقول: تساوقَ تيّارا العَقْل والنَّقْل في مرحلة النُّضج حضاريًّا، ثمّ افترقَا في نِزاعٍ في المسائل العقَديّة، حتّى تغوَّل النّقلُ على العقلِ، وجعلهُ وسيلةً من وسائلِه، فَانسربَ تيّار العقلِ إلى العُلوم، وهاجرَ إلى بيئةٍ متعطِّشةٍ له؟
أيوفِّر الاختزالُ نفسُه تفسيرًا لوراثةِ أوروبّا أواخرَ عصورِ الظّلام منجزاتِ تيّار العقلِ العربيّ التّنويريّةَ في أوجِه، ورُزوحِنا منذ أواخر تلك العُصور تحتَ أثقالِ الظّلاميّة؟ وهل يمتدّ هذا الاختزالُ ليطُولَ ظاهرةَ هِجرة العقلِ من المجتمعات العربيّة الإسلاميّة حاليًّا إلى بيئاتٍ أُخرى يجدُ فيها ذواتِه، ويُحقِّق مشاريعَه؟
قد يتراءى افتراق العقل والنّقل في التّراث العربيّ الإسلاميّ في لحظاتٍ حرجةٍ كثيرة، أشهرُها ما جسَّدته أسئلة بعض الصّحابة للنّبيّ الكريم عمّا يجدونَه في أنفسهم من "الوسوسة" الّتي عَنْوَنَ بها بعض مصنِّفي كتب الحديث "باب في الوسوسة في أمر الرّبّ عزّ وجلّ"، فقال يصف إحجامَهم عن التّصريح بها: "ذلك صَريحُ/ محضُ الإيمان"، وظاهريًّا حينَ تعرّض أحمد بن حنبل للاستجوابِ في "خَلْقِ القُرآن" حين استقوى المعتزلةُ (القائلونَ بأسبقيّة العقلِ على الشّرعِ، وبالحُسنِ والقُبحِ العقليّين)، والمواجهةُ التي خاضَها أبو حنيفةَ النُّعمان حين قال: "هُم رِجَالٌ ونحنُ رِجَال"، وتمسُّك ابن رُشدٍ بالعلاقة التّلازُميّة المُطلقة بين السَّبب والمُسبَّب. لكنّ "أدلّة العُقول" الّتي سلكَها المعتزلةُ لم تلبث أن تراجَعت منزلتُها، وانفتحَ أفق آخرُ للعقلِ هو الطّبيعيّات. لم ينحسِم الجدلُ في العقلِ والنّقل؛ لكنّه انتهى إلى خِدمةِ العقلِ للنَّقلِ في الجانبِ الفقهيّ بالتَّمحوُر حول النّصّ؛ تكرَّست وظيفة العقلِ في تلقّي النّصّ، وفهمه، وتفسيره، وشرحِه، واستنباطِ الأحكامِ منه، وبيانِ ناسخِه ومنسوخِه، ومتشابِهه ومُحكَمه، وأسباب نُزولِه، ووجوهِ قراءاتِه، وتسويغِ ما قد يظهرُ من مفارقةٍ لقاعدةٍ نحويّة أو تصريفيّة، وأصالةِ ألفاظِه وأساليبِه في العربيّةِ أو تعريبِها وأعجميّة بعضِها، فضلًا عن استكشافِ وجوهِ البيانِ والبلاغةِ فيه، وإعجازِه. وهذا في ذاتِه أصّل لعددٍ من العلومِ المُقترنةِ بِه، وعُلوم أُخرى في العربيّة.
وفي الآن نفسِه، تشكَّلت ملامحُ تيّارٍ عقليّ آخرَ، انصرفَ إلى العُلومِ الطّبيعيّة، غير منبتٍّ تمامًا
من المسألة الإيمانيّة، أو التّديُّنيّة (انظر: الشّكوك على بطلمْيوس لابن الهيثم)، لكنّه وجد نفسَه منبهرًا بأفكارِ الأُمم الأُخرى المشتغلة بالفلسفة والمنطق والطّبيعيّات. واقترنَ هذا التّشكُّل بسياق التّحوّل الاجتماعيّ من مرحلة البداوة التي طبعت العقليّة العربيّة ردحًا من الزّمن، إلى حياة الاستقرار والمدينة والاختلاطِ بمكوّنات جديدة- بمحاولة تشكيل أوّل نظام حُكم: يفصلُ بين الحيّز الخاصّ (نظر الخاصّ الّذي يمثّل أملاك الأسرة العبّاسيّة)، والحيّز العامّ (بيت المال بموارده المتعدّدة)، ويُحافظ للخليفة على سُلطةٍ عُليا من دون أن يتدخّل في تفاصيل إدارة الدّولة الّتي يقومُ عليها جهاز تنفيذيّ (الوزارة بما تضمّه من مستشارين وكتّاب ومحاسبين ورؤساء للدّواوين). غير أنّ الغلبةَ كانت في غاية الصّراعِ لصالح التّقليد الّذي أطاحَ تلك التّجربةِ، فارتدّت الدّولة إلى عهدٍ سابقٍ، وارتكست الثّقافةُ لتغليبِ الطّابعِ (الأعرابيّ) على كلّ ما سواه، حتّى كان تفضيلُ الأمينِ (ابن القُرشيّة زبيدة) على المأمونِ (ابن مَرَاجِل البَاذغيسيّة)، مع أنّ "التَّعرُّبَ" كان سمةَ العصرِ، ومع علم الرّشيد وتصريحه بأنّ المأمونَ أكثرُ أهليّة للخلافةِ من الأمين. وحتّى تغلّبت قصائد المفضّليّات والأصمعيّات على حِكَم ابن المقفّع، وكليلة ودمنة، وحكايات شهرزاد، وبخلاء الجاحظ، ورسائله، ...، وأصبحت حواضرُ العراقِ مَحَطّ رحالِ "الأعرابِ" يتّجرونَ إليها ببضاعتِهم المُزجاة من القصص والغرائب والنّوادر والطّرائف الّتي نال بها مثلُ الأصمعيّ منزلتَه عندَ الرّشيد.
اتّخذ العقليُّ منحى الفلسفيّ والعلميّ، والتبسَ النّقليّ بالأُصوليّ والفقهيّ، وترسّخ الافتراقُ حتّى عصرنا هذا، مع محاولةٍ دائبةٍ من التّيّارينِ في استمالةِ الآخر، بل استلابه واستحواذِه، وتوظيفِه لخدمتِه. وتجلّت مُحاولاتُ العقليّ العلميّ الفلسفيّ في تقديمِ تفسيراتٍ اجتماعيّة، واقتصاديّة، وأسطوريّة، وأخفّها التّاريخيّة، للأديان والتّديّن. واجتهدَ أهل النّقل في توظيفِ مكتشفات العلوم وإنجازاتِها لإثباتِ النّقليّ، الأمر الذي تصدّى له نفرٌ من أهل "الإعجاز العلميّ" للقرآن والحديث أيضًا. وهكذا، كان كلا التّيّارينِ يتجاذبُ حركةَ الواقعِ بينَ اتّجاهينِ: واحدٍ يُغرِّبُ عن الواقعِ باتّجاهٍ ماضَويّ منبتٍّ عن الرّاهِن، وآخرَ يغرِّبُ عن الواقعِ باتّجاهٍ مستقبليّ ينبتُّ عن الرّاهنِ أيضًا. والواقعُ أنّ هذه الثّنائيّة المُتَخَيَّلةَ في ذاتِها مُشكلٌ عويص، لا وجودَ له سوى في الأذهانِ.
إنّ النّاظر في علاقةِ العقليّ بالنّقليّ (العلميّ بالدّينيّ) في أوروبا، حين بدأت حركة التّنوير في نهايات عصور الظّلام، يجدُها متوتّرة قاسيةً عنيفةً، شهدت أحكامًا بالسّجن والإعدام، فضلًا عن الرّمي بالهرطقة والكُفر والإلحادِ والزّندقة (ما حدث لغاليليو غاليلي نموذج)، غير أنّ سيرورة الحياة، والتّحوّلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وبالتّالي السّياسيّة، ونشوء نُخَب جديدة، قادت كلّها إلى حركةٍ لا يغيبُ فيها التّديُّن غيابًا مُطلقًا عن الواقع في حياة الأوروبيّ (وسواه طبعًا)، وينطلقُ فيها العقلُ العلميّ النّاقدُ في كلّ اتّجاهٍ: سائلًا ومتسائلًا، وشاكًّا ومُتحقِّقًا، وباحثًا ومستكشفًا، وناظرًا ومنظِّرًا، ومتراجعًا عن نظريّة أثبتَت البراهينُ خطأها، ومنتقلًا إلى أُخرى بصدد إثباتِها، ومجسِّدًا لصراعاتٍ تكادُ لا تنتهي بين نظريّة وأُخرى مقابِلة، واتّجاه نقديّ وآخرَ مُعاكِس...
هذا هو القيدُ الّذي أزالَه الفِكر العلميّ والحِراكُ الفكريّ الحديث، وأزاحَهُ مآل التّغيّرات الاجتماعيّة
والاقتصاديّة والسّياسيّة، عن حركة العقلِ وحُرّيّته ذاتَ لحظةٍ مُفارقة. لم تُفارق المسألة الإيمانيّة أو التّديّن هذه الحركة في المُطلَق، بل كان النّقاش فيها مصاحبًا لنقاشٍ علميّ عميقٍ في نظريّات مثل "نشأة الكون والانفجار العظيم"، مثلما صاحَبَ ابن الهيثم حين قرّر في كتابه "الشّكوك على بطلمْيوس": مبدأً تأسيسيًّا في منهجيّة البحث العقليّ النّقديّ: الحقّ في العلوم الطبيعية مطلوب لذاته، والطريق إليه وعر وصعب، لأن الحقيقة منغمسة في الشبهات والأهواء، ورؤيةً فذَّةً في البحث العلميّ تمثّل طريق طالب الحقّ الّذي لا يكتفي بالنَّظر في كتب المتقدّمين، ويسترسِلُ في حُسن ظنِّه بالعلماء، إنّما هو المشكِّك والمتَّهِم لحُسن ظنِّه فيهم، والمتَّبِع للحُجّة، لا قول العالم الذي هو إنسانٌ مجبولٌ على الخلل والنُّقْصان. ابن الهيثمِ هذا هُو نفسُه القائلُ حين مرّ به مارٌّ فوجده مع صاحبٍ يتجادلانِ في كتاب المَجِسْطِي، فسألهما عمّا يفعلانِ: كنّا نطلب فهم آيةٍ من كتاب الله.
إنّ ملاحقةَ ما تُنتجُه العلوم في عصرنا لجَعْلِ خُلاصاتِها ونتائجِها تجسيدًا لما في النّصوص الشّرعيّة فاسدٌ من جهتينِ: أنّه من واحدةٍ يقلبُ تصوُّر هذه النّصوص ليجعلها نُصوصًا علميّةً بدلًا من كونِها نُصوصًا للهدايةِ والإيمان، والعلومُ متغيِّرة لا ثبات لها، وقابلةٌ للجدل والطّعن والتّعديل والتّغيُّر بما هي العلوم كذلك، وبحسب ما يطرأ على نظريّاتها من براهينَ وأدلّة تُبطلُها حينًا، وتثبتُ صحّتَها حينًا آخرَ لتُصبحَ قوانينَ علميّة. ومن الجهة الأُخرى أنّه مَسْعًى يُخيِّل للمؤمنِ أنّه مُكْتَفٍ مُسْتَغْنٍ عن البحثِ والنَّظر والاستكشافِ والخوضِ في التّجاربِ العلميّة والبحثِ العلميّ، إذ كلُّ ما يمكنُ أن يصلَ إليه العلماءُ في هذا الكونِ مسطُورٌ عندَه منذ 15 قرنًا. ولعلّ خُطورة هذه الأخيرة على العقلِ عندنا أنّها أوّلًا: تُحِيلُ كلّ منجزٍ علميّ يتحقّق في عالمِ الأعيانِ المُشاهَد مجرّدَ تجسيدٍ لنصٍّ هو في قِمّة البيانِ والهداية، وتُفقِدُ المسافةَ بين "الكامن بالقوّة" في هذا النّصّ دلاليًّا و"المتحقِّق بالفِعلِ" في المنجزِ العلميّ الحاضرِ- قيمتَها، وهي المسافة التّوتيريّة الضّروريّة للانخراطِ في البحث العلميّ والانشغالِ العقليّ. وثانيًا: أنّها أدّت إلى نُشوء تيّارٍ من الرِّدّة بين الدّارسينَ يستشكفُ كلّ ما يُنتجُه العقلُ العلميّ والنّقديّ والأدبيّ والفنّيّ ... خارجَ "عالمِنا" للبحثِ عن نَظِيرٍ لهُ في "تُراثنا" الضّخم الزّاخر، ليقولَ هذا التّيّار: "كلّ شيءٍ لدينا، ونحنُ أصحابُه" في نرجسيّة ونوستالجيا شِبهِ مَرَضيَّة، وتَعَالٍ متضخِّم للذّاتِ الجمعيّة، سالكًا في هذي السّبيلِ إسقاطاتٍ عقيمةً، وتأويلاتٍ دلاليّةً خادعةً يُسْقِطُها فورًا التّساؤُل: إذا كان هذا كلُّه موجودًا عندَنا، فلماذا تخلّفنا وتقدّم العالمُ كلُّه؟
قد يتراءى افتراق العقل والنّقل في التّراث العربيّ الإسلاميّ في لحظاتٍ حرجةٍ كثيرة، أشهرُها ما جسَّدته أسئلة بعض الصّحابة للنّبيّ الكريم عمّا يجدونَه في أنفسهم من "الوسوسة" الّتي عَنْوَنَ بها بعض مصنِّفي كتب الحديث "باب في الوسوسة في أمر الرّبّ عزّ وجلّ"، فقال يصف إحجامَهم عن التّصريح بها: "ذلك صَريحُ/ محضُ الإيمان"، وظاهريًّا حينَ تعرّض أحمد بن حنبل للاستجوابِ في "خَلْقِ القُرآن" حين استقوى المعتزلةُ (القائلونَ بأسبقيّة العقلِ على الشّرعِ، وبالحُسنِ والقُبحِ العقليّين)، والمواجهةُ التي خاضَها أبو حنيفةَ النُّعمان حين قال: "هُم رِجَالٌ ونحنُ رِجَال"، وتمسُّك ابن رُشدٍ بالعلاقة التّلازُميّة المُطلقة بين السَّبب والمُسبَّب. لكنّ "أدلّة العُقول" الّتي سلكَها المعتزلةُ لم تلبث أن تراجَعت منزلتُها، وانفتحَ أفق آخرُ للعقلِ هو الطّبيعيّات. لم ينحسِم الجدلُ في العقلِ والنّقل؛ لكنّه انتهى إلى خِدمةِ العقلِ للنَّقلِ في الجانبِ الفقهيّ بالتَّمحوُر حول النّصّ؛ تكرَّست وظيفة العقلِ في تلقّي النّصّ، وفهمه، وتفسيره، وشرحِه، واستنباطِ الأحكامِ منه، وبيانِ ناسخِه ومنسوخِه، ومتشابِهه ومُحكَمه، وأسباب نُزولِه، ووجوهِ قراءاتِه، وتسويغِ ما قد يظهرُ من مفارقةٍ لقاعدةٍ نحويّة أو تصريفيّة، وأصالةِ ألفاظِه وأساليبِه في العربيّةِ أو تعريبِها وأعجميّة بعضِها، فضلًا عن استكشافِ وجوهِ البيانِ والبلاغةِ فيه، وإعجازِه. وهذا في ذاتِه أصّل لعددٍ من العلومِ المُقترنةِ بِه، وعُلوم أُخرى في العربيّة.
وفي الآن نفسِه، تشكَّلت ملامحُ تيّارٍ عقليّ آخرَ، انصرفَ إلى العُلومِ الطّبيعيّة، غير منبتٍّ تمامًا
اتّخذ العقليُّ منحى الفلسفيّ والعلميّ، والتبسَ النّقليّ بالأُصوليّ والفقهيّ، وترسّخ الافتراقُ حتّى عصرنا هذا، مع محاولةٍ دائبةٍ من التّيّارينِ في استمالةِ الآخر، بل استلابه واستحواذِه، وتوظيفِه لخدمتِه. وتجلّت مُحاولاتُ العقليّ العلميّ الفلسفيّ في تقديمِ تفسيراتٍ اجتماعيّة، واقتصاديّة، وأسطوريّة، وأخفّها التّاريخيّة، للأديان والتّديّن. واجتهدَ أهل النّقل في توظيفِ مكتشفات العلوم وإنجازاتِها لإثباتِ النّقليّ، الأمر الذي تصدّى له نفرٌ من أهل "الإعجاز العلميّ" للقرآن والحديث أيضًا. وهكذا، كان كلا التّيّارينِ يتجاذبُ حركةَ الواقعِ بينَ اتّجاهينِ: واحدٍ يُغرِّبُ عن الواقعِ باتّجاهٍ ماضَويّ منبتٍّ عن الرّاهِن، وآخرَ يغرِّبُ عن الواقعِ باتّجاهٍ مستقبليّ ينبتُّ عن الرّاهنِ أيضًا. والواقعُ أنّ هذه الثّنائيّة المُتَخَيَّلةَ في ذاتِها مُشكلٌ عويص، لا وجودَ له سوى في الأذهانِ.
إنّ النّاظر في علاقةِ العقليّ بالنّقليّ (العلميّ بالدّينيّ) في أوروبا، حين بدأت حركة التّنوير في نهايات عصور الظّلام، يجدُها متوتّرة قاسيةً عنيفةً، شهدت أحكامًا بالسّجن والإعدام، فضلًا عن الرّمي بالهرطقة والكُفر والإلحادِ والزّندقة (ما حدث لغاليليو غاليلي نموذج)، غير أنّ سيرورة الحياة، والتّحوّلات الاقتصاديّة والاجتماعيّة وبالتّالي السّياسيّة، ونشوء نُخَب جديدة، قادت كلّها إلى حركةٍ لا يغيبُ فيها التّديُّن غيابًا مُطلقًا عن الواقع في حياة الأوروبيّ (وسواه طبعًا)، وينطلقُ فيها العقلُ العلميّ النّاقدُ في كلّ اتّجاهٍ: سائلًا ومتسائلًا، وشاكًّا ومُتحقِّقًا، وباحثًا ومستكشفًا، وناظرًا ومنظِّرًا، ومتراجعًا عن نظريّة أثبتَت البراهينُ خطأها، ومنتقلًا إلى أُخرى بصدد إثباتِها، ومجسِّدًا لصراعاتٍ تكادُ لا تنتهي بين نظريّة وأُخرى مقابِلة، واتّجاه نقديّ وآخرَ مُعاكِس...
هذا هو القيدُ الّذي أزالَه الفِكر العلميّ والحِراكُ الفكريّ الحديث، وأزاحَهُ مآل التّغيّرات الاجتماعيّة
إنّ ملاحقةَ ما تُنتجُه العلوم في عصرنا لجَعْلِ خُلاصاتِها ونتائجِها تجسيدًا لما في النّصوص الشّرعيّة فاسدٌ من جهتينِ: أنّه من واحدةٍ يقلبُ تصوُّر هذه النّصوص ليجعلها نُصوصًا علميّةً بدلًا من كونِها نُصوصًا للهدايةِ والإيمان، والعلومُ متغيِّرة لا ثبات لها، وقابلةٌ للجدل والطّعن والتّعديل والتّغيُّر بما هي العلوم كذلك، وبحسب ما يطرأ على نظريّاتها من براهينَ وأدلّة تُبطلُها حينًا، وتثبتُ صحّتَها حينًا آخرَ لتُصبحَ قوانينَ علميّة. ومن الجهة الأُخرى أنّه مَسْعًى يُخيِّل للمؤمنِ أنّه مُكْتَفٍ مُسْتَغْنٍ عن البحثِ والنَّظر والاستكشافِ والخوضِ في التّجاربِ العلميّة والبحثِ العلميّ، إذ كلُّ ما يمكنُ أن يصلَ إليه العلماءُ في هذا الكونِ مسطُورٌ عندَه منذ 15 قرنًا. ولعلّ خُطورة هذه الأخيرة على العقلِ عندنا أنّها أوّلًا: تُحِيلُ كلّ منجزٍ علميّ يتحقّق في عالمِ الأعيانِ المُشاهَد مجرّدَ تجسيدٍ لنصٍّ هو في قِمّة البيانِ والهداية، وتُفقِدُ المسافةَ بين "الكامن بالقوّة" في هذا النّصّ دلاليًّا و"المتحقِّق بالفِعلِ" في المنجزِ العلميّ الحاضرِ- قيمتَها، وهي المسافة التّوتيريّة الضّروريّة للانخراطِ في البحث العلميّ والانشغالِ العقليّ. وثانيًا: أنّها أدّت إلى نُشوء تيّارٍ من الرِّدّة بين الدّارسينَ يستشكفُ كلّ ما يُنتجُه العقلُ العلميّ والنّقديّ والأدبيّ والفنّيّ ... خارجَ "عالمِنا" للبحثِ عن نَظِيرٍ لهُ في "تُراثنا" الضّخم الزّاخر، ليقولَ هذا التّيّار: "كلّ شيءٍ لدينا، ونحنُ أصحابُه" في نرجسيّة ونوستالجيا شِبهِ مَرَضيَّة، وتَعَالٍ متضخِّم للذّاتِ الجمعيّة، سالكًا في هذي السّبيلِ إسقاطاتٍ عقيمةً، وتأويلاتٍ دلاليّةً خادعةً يُسْقِطُها فورًا التّساؤُل: إذا كان هذا كلُّه موجودًا عندَنا، فلماذا تخلّفنا وتقدّم العالمُ كلُّه؟
دلالات
مقالات أخرى
02 ديسمبر 2023
10 يوليو 2023
19 ابريل 2023