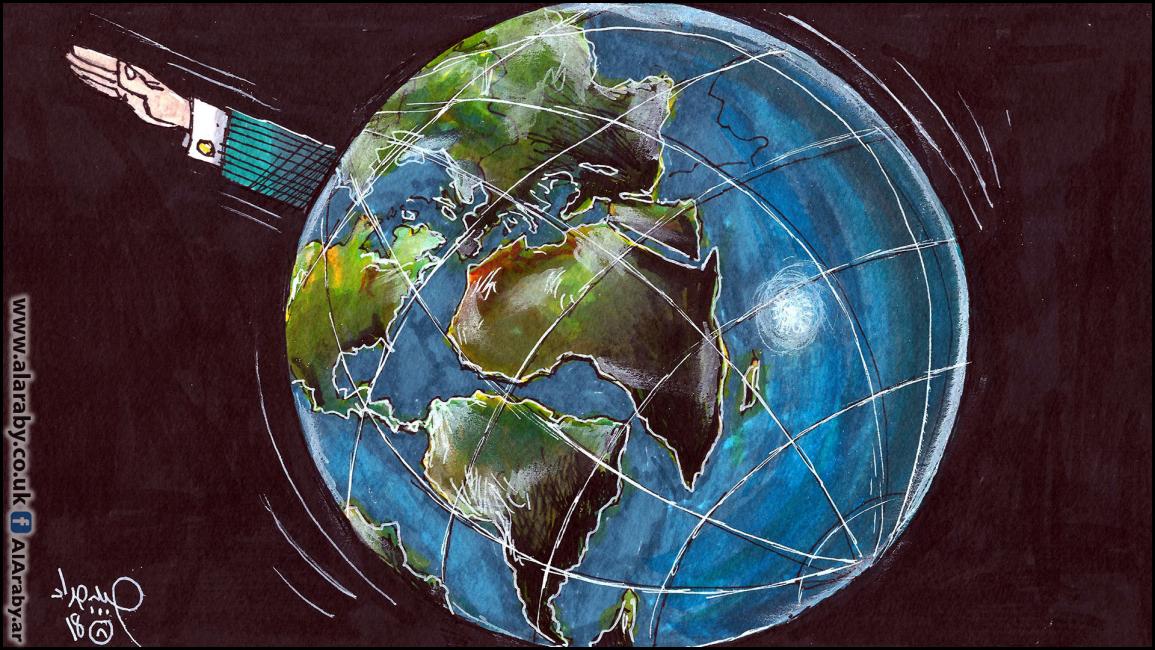16 اغسطس 2024
في حسابات استرضاء الأيديولوجيين وتهييج الدهماء
تضيع الحقيقة، كما نعجز عن تقديم قراءاتٍ دقيقةٍ وواعيةٍ لأي مسألة، عندما ننطلق من تحيز معرفي أو فكري أو سياسي مسبق. تلك أَولِيَّةٌ لا مراء فيها ولا جدال، خصوصاً في الحقول العلمية والدراسات الأكاديمية. ومع ذلك، تجد كثيرين بين المتخصّصين أو صُنَّاعِ الرأي العام، بمن فيهم رجال دين وأكاديميون وصحافيون، ومن كل الخلفيات الإيديولوجية والسياسية، يسقطون في فَخِّ التبسيط وتقديم التحليلات والقراءات الساذجة. وهم في ذلك لا يراعون أن ما كان منطلقه تحيزا أو قناعات مسبقة لم يخضع لفحص ونظر دقيقين، فإنه، عملياً، يعدم القيمة والمصداقية، أو أن هذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال.
ثمَّة بعد آخر، لا يقل أهميةً في هذا السياق، إذ ليس كل ما نطالعه اليوم وما نتابعه من تحليلات رَثَّةٍ وقراءات سطحية مرده التحيّز فحسب، بل إن دافعه، أحياناً، قد يكون طلب شعبيةٍ زائفةٍ بين القواعد الإيديولوجية، أو محاولة اصطناع شعبيةٍ بين الدهماء، وهم عامّة الناس وسوادهم. ولذلك، كان الفيلسوف الفرنسي، فولتير، لا يثق بالديمقراطية، إذ إنه كان يرى فيها تمكيناً لحماقات العامة والدهماء. وبغض النظر عن موضوعية إطلاقية الحكم في منطق فولتير، إلا أن ثمَّة مشروعية لتوجسه، ذلك أننا نجد تحذيراً في النظريات الفلسفية السياسية مما يعرف بـ"حكومة الدهماء"، أو Ochlocracy، وهي قد تكون في صورة "حكومة ديمقراطية"، إلا أنها ديماغوجية، تمارس فيها الأغلبية استبداداً قائما على العواطف، لا المنطق، وبالتالي، قد تقود إلى القمع والكبت والتمييز في حق الأقليات الدينية أو العرقية أو الفكرية أو السياسية.
اللافت هنا أن الغرب نفسه، وعلى الرغم من مرور ما يزيد على ثلاثة قرون من صدور مثل تلك التحذيرات عن فلاسفته، وعلى الرغم من تطويره نظم حكم ديمقراطية ومؤسسات عريقة تقوم
على رعاية قيمها وحراستها، إلا أن كثيراً من دوله، راهناً، تواجه صعود تياراتٍ تسعى إلى ترسيخ "حكومة الدهماء" في دولها. ولعلنا نجد تأكيداً لذلك في الأنموذج الذي تقدّمه الولايات المتحدة تحت رئاسة دونالد ترامب، فضلاً عن صعود اليمين المتطرّف المُشَبَّعِ بخطاب الكراهية نحو "الأجانب" في أوروبا، والمرتكس إلى مفهوم شوفيني للوطنية، كما في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. وليس من قبيل المبالغة القول اليوم إن الديمقراطية كفلسفة حكم، وكمؤسسة حكم سياسية، تواجه التحدّي الأبرز في سيرورتها، بل إنها قد تكون حَمَلَتْ بما قد يكون بذور فنائها إن عجز عقلاء الغرب عن تعديل جينات مواليد الكراهية والعنصرية في أحشائها.
وبعيداً عن الاستطراد، نعود هنا إلى موضوعة البحث عن شعبيةٍ زائفة، أو اصطناع واحدة، بين القواعد الإيديولوجية، أو الدهماء عامة، عبر تقديم قراءاتٍ أو تحليلاتٍ لقضايا دينية أو فكرية أو سياسية في أحداث حاضرةٍ ذات أهمية، بحيث تكون أقرب إلى اللعب على وتر العواطف والتحيزات والقناعات المسبقة عند عموم الناس. الضحية هنا ليست الموضوعية فحسب، ولا حتى تقديم تصوّر دقيق للمسألة محل البحث والنقاش فقط، بل الأخطر أن قائمة الضحايا تشمل الوعي، بحيث تبقى القواعد الحزبية والإيديولوجية، كما الشعوب في الإطار الأوسع، رهائن السطحية والجهل، وبالتالي يسهل التحكّم فيها وتوجيهها. الأخطر أن قواعد وجماهير جاهلة مُتَحَكَّما بها، عبر التهييج العاطفي أو الديني أو العرقي أو الفكري أو السياسي، هي أخطر أداة قتل وجدت عبر التاريخ الإنساني. يكفي أن تُصدر السلطة الحاكمة، أو المؤسّسة الدينية النافذة، حكماً بكفر شخص أو مجموعة أو تيار، حتى تعطيهما جماهير الغوغائيين شرعية قتلهم وسحقهم، أو على الأقل اضطهادهم وتهميشهم وإخراجهم من الملّة، من دون السماح بنقاش حقيقة أفكارهم ومواقفهم. إننا نجد نماذج لذلك كثيرة في تاريخنا الإسلامي، كما نجده في التاريخ المسيحي، ولا شك أننا سنجده في تاريخ كل دين آخر وحضارة أخرى.
إذاً، أدرك الانتهازيون، ماضياً وحاضراً، أن واحداً من أنجع وسائل الاغتيال المعنوي ضد من اصطنعوهم خصوماً لهم في سياق طلبهم الشعبية الزائفة هو إصدار أحكام قيمِيَّةٍ بحقهم، دينيةً كانت أو إيديولوجية أو قومية أو وطنية. بمعنى التشكيك في شرعية ما يطرحونه، لا لناحية مضمونه وجوهره، بل لناحية منشئه وأصله، وبالتالي لا يضطرّون إلى ولوج معارك فكرية أو سياسية قد يخسرونها، أو أنها قد تخلخل بنيان مقولاتهم وأطروحاتهم. مثلاً، قد يلجأ الانتهازيون إلى التشكيك في دين المخالف لهم، أو في مستوى فهمه، أو في نياته، أو في ولائه، أو في
وطنيته، كما في توزيع تهم العمالة يميناً وشمالاً من دون ضابط موضوعي ولا أخلاقي. يكفي مثلاً أن تقول إن هدف مشروع فلان هو نقض عرى الدين، أو تمييعه، أو تغريب مجتمعاتنا، أو تفكيك مقوماتها الأخلاقية، كي تحسم معركة الرأي العام بين صفوف الإيديولوجيين والدهماء، من دون نقاش يروم الحقيقة والموضوعية والصالح العام. ومرة أخرى، الضحية الأولى والأكبر، للأسف، هو عجزنا عن مراكمة الوعي الذي بدونه لا يمكن لنا أن نتقدّم إلى الأمام. وكما في الماضي، عبر العصور المتتالية، تجد انتهازيين كثيرين باحثين عن شعبية زائفة على حساب الموضوعية، أو حتى قضايا أممهم، وهم مسكونون بداء الحسد، أو مرض البحث عن شهرة، ابتغاء تحقيق سلطةٍ معنويةٍ أو مادية.
الأدهى من كل ما سبق أنه في عصر الطفرة التكنولوجية ووسائل الاتصال، أصبح للانتهازيين قنوات تواصل فعالة ومباشرة مع عشرات الملايين من القواعد الإيديولوجية والجماهيرية، فكان أن التقت الانتهازية مع الجهل، بشكلٍ جعل سلاح الغوغائية والديماغوجية أمضى أثراً، وأكثر خطراً من أي وقت سابق. طبعاً، هذا لا ينفي أن وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، كـ"يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر"، قدمت لنا مهرّجين وجهلة يخاطبون من هم مثلهم بالملايين، فالتقى الجهل مع جهل، فازداد الجميع خبالاً، غير أن زاوية تركيز هذا المقال ليست هذه.
باختصار، أشهر سلاح تهييج الغوغاء والدهماء، تاريخياً، في وجه المخالفين فكرياً وسياسياً، وحتى فقهياً، في السياق الديني، عندما عجز الانتهازيون عن حسم معاركهم في ساحات العلم والنقاش والمناظرة، فكانت النتيجة تأخّراً في تقدم الإنسانية، أو بعض حضاراتها، كما كان نتيجتها سفك دماء وانتهاك حقوق. المفارقة هنا أن هذا السلاح الغادر واللئيم وغير الأخلاقي لا يزال فعالاً، ولم تكتشف الإنسانية مصلاً بعد مضادّاً له، إذ إن الحاضنة التي ينتعش ويتقوى فيها هي حاضنة تعتاش على الجهل، وهي البيئة الغالبة إنسانياً. ومن أسفٍ، أنه يبدو أننا سنبقى نكافح في هذه الدائرة الشريرة المغلقة التي قوامها جهل الدهماء وتحيز الإيديولوجيين، من ناحية، ولا أخلاقية الانتهازيين في بحثهم عن شعبيةٍ زائفة، من ناحية أخرى، ولو على حساب الحقيقة ومستقبلنا جميعاً.
اللافت هنا أن الغرب نفسه، وعلى الرغم من مرور ما يزيد على ثلاثة قرون من صدور مثل تلك التحذيرات عن فلاسفته، وعلى الرغم من تطويره نظم حكم ديمقراطية ومؤسسات عريقة تقوم
وبعيداً عن الاستطراد، نعود هنا إلى موضوعة البحث عن شعبيةٍ زائفة، أو اصطناع واحدة، بين القواعد الإيديولوجية، أو الدهماء عامة، عبر تقديم قراءاتٍ أو تحليلاتٍ لقضايا دينية أو فكرية أو سياسية في أحداث حاضرةٍ ذات أهمية، بحيث تكون أقرب إلى اللعب على وتر العواطف والتحيزات والقناعات المسبقة عند عموم الناس. الضحية هنا ليست الموضوعية فحسب، ولا حتى تقديم تصوّر دقيق للمسألة محل البحث والنقاش فقط، بل الأخطر أن قائمة الضحايا تشمل الوعي، بحيث تبقى القواعد الحزبية والإيديولوجية، كما الشعوب في الإطار الأوسع، رهائن السطحية والجهل، وبالتالي يسهل التحكّم فيها وتوجيهها. الأخطر أن قواعد وجماهير جاهلة مُتَحَكَّما بها، عبر التهييج العاطفي أو الديني أو العرقي أو الفكري أو السياسي، هي أخطر أداة قتل وجدت عبر التاريخ الإنساني. يكفي أن تُصدر السلطة الحاكمة، أو المؤسّسة الدينية النافذة، حكماً بكفر شخص أو مجموعة أو تيار، حتى تعطيهما جماهير الغوغائيين شرعية قتلهم وسحقهم، أو على الأقل اضطهادهم وتهميشهم وإخراجهم من الملّة، من دون السماح بنقاش حقيقة أفكارهم ومواقفهم. إننا نجد نماذج لذلك كثيرة في تاريخنا الإسلامي، كما نجده في التاريخ المسيحي، ولا شك أننا سنجده في تاريخ كل دين آخر وحضارة أخرى.
إذاً، أدرك الانتهازيون، ماضياً وحاضراً، أن واحداً من أنجع وسائل الاغتيال المعنوي ضد من اصطنعوهم خصوماً لهم في سياق طلبهم الشعبية الزائفة هو إصدار أحكام قيمِيَّةٍ بحقهم، دينيةً كانت أو إيديولوجية أو قومية أو وطنية. بمعنى التشكيك في شرعية ما يطرحونه، لا لناحية مضمونه وجوهره، بل لناحية منشئه وأصله، وبالتالي لا يضطرّون إلى ولوج معارك فكرية أو سياسية قد يخسرونها، أو أنها قد تخلخل بنيان مقولاتهم وأطروحاتهم. مثلاً، قد يلجأ الانتهازيون إلى التشكيك في دين المخالف لهم، أو في مستوى فهمه، أو في نياته، أو في ولائه، أو في
الأدهى من كل ما سبق أنه في عصر الطفرة التكنولوجية ووسائل الاتصال، أصبح للانتهازيين قنوات تواصل فعالة ومباشرة مع عشرات الملايين من القواعد الإيديولوجية والجماهيرية، فكان أن التقت الانتهازية مع الجهل، بشكلٍ جعل سلاح الغوغائية والديماغوجية أمضى أثراً، وأكثر خطراً من أي وقت سابق. طبعاً، هذا لا ينفي أن وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، كـ"يوتيوب" و"فيسبوك" و"تويتر"، قدمت لنا مهرّجين وجهلة يخاطبون من هم مثلهم بالملايين، فالتقى الجهل مع جهل، فازداد الجميع خبالاً، غير أن زاوية تركيز هذا المقال ليست هذه.
باختصار، أشهر سلاح تهييج الغوغاء والدهماء، تاريخياً، في وجه المخالفين فكرياً وسياسياً، وحتى فقهياً، في السياق الديني، عندما عجز الانتهازيون عن حسم معاركهم في ساحات العلم والنقاش والمناظرة، فكانت النتيجة تأخّراً في تقدم الإنسانية، أو بعض حضاراتها، كما كان نتيجتها سفك دماء وانتهاك حقوق. المفارقة هنا أن هذا السلاح الغادر واللئيم وغير الأخلاقي لا يزال فعالاً، ولم تكتشف الإنسانية مصلاً بعد مضادّاً له، إذ إن الحاضنة التي ينتعش ويتقوى فيها هي حاضنة تعتاش على الجهل، وهي البيئة الغالبة إنسانياً. ومن أسفٍ، أنه يبدو أننا سنبقى نكافح في هذه الدائرة الشريرة المغلقة التي قوامها جهل الدهماء وتحيز الإيديولوجيين، من ناحية، ولا أخلاقية الانتهازيين في بحثهم عن شعبيةٍ زائفة، من ناحية أخرى، ولو على حساب الحقيقة ومستقبلنا جميعاً.