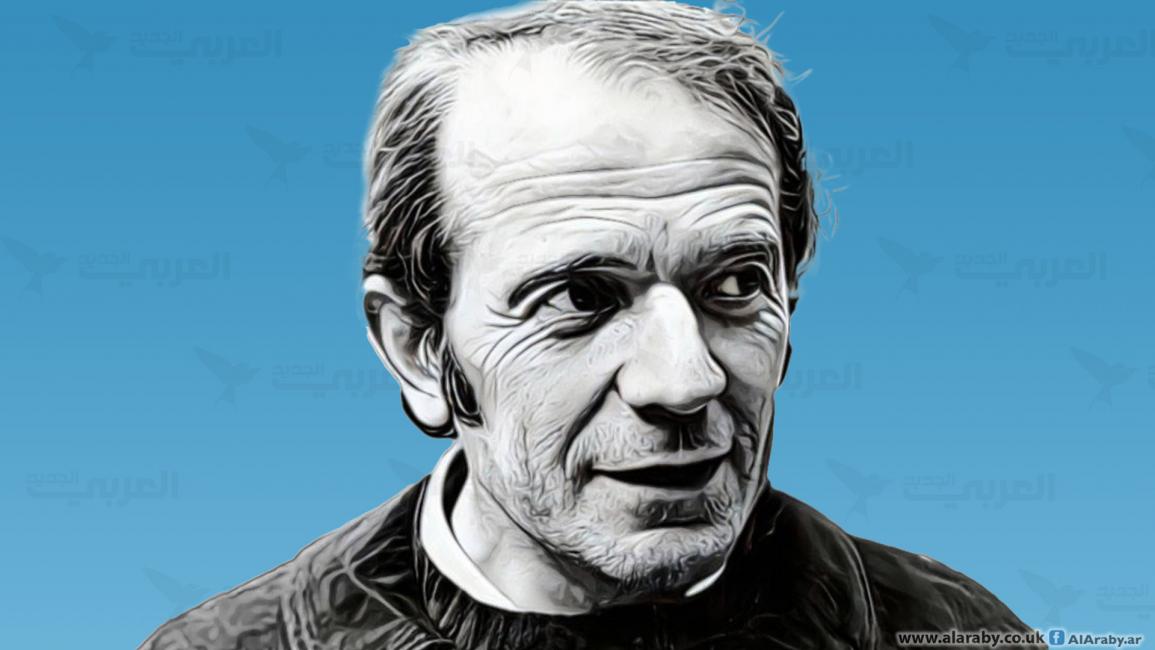جيل دولوز ... كصيحة ذئبٍ على قمر
فيلسوف له سحر عبارة تخايل الشعر والسحر وعلم النفس والأسطورة وفن "البوب"، يضفر أشياء غامضة داخل البناء الفلسفي، بالنظر إلى الأشياء العابرة عليه كقراءة الشعر أو لعبة التنس أو متعته من سماع الأغاني الشعبية والسينما وجولاته إلى المعارض الفنيّة، يكتب وكأنه في صحبة ما، صحبة وحدته من دون سفر أو أيديولوجية معلنة، فقط يستمتع بمنهج التدريس، ويعتبره متعته البسيطة للاستمرار في مشروعه الفلسفي.
يقول: "ليس لديّ ما أفعله مع الناس، لا شيء على الإطلاق"، ليست مقولة دولوز من باب التعالي أو التوحّد الخالص بعيدا عن الحضارة برمّتها كما عند إميل سيوران، وليس من باب ذلك البرج العنيف الذي استقوى به نيتشه كي يتعالى به على مرضه الصدري الذي ابتُلي به، حتى وإن كان دولوز نفسه مريض سل، ولكن ابتعاد دولوز هو بمثابة ارتباكةٍ ما، كي يبحث عما يحبّه بعيدا عن أي تجمّع أو سفر لمؤتمر أو التنزّه في محميّة ثقافية تضمن له الفوز بالجوائز أو الحضور أو الثراء أو المكانة المحمية.
يعتبر الأدب شأنا خاصا بلا تبجّح وبلا مبالغة "الأدب الآن شأن خاص ضئيل"، فما الذي يدفع دولوز إلا تلك المسؤولية النبيلة والغامضة والكريمة أيضا، والتي تجعله يقول في حوار أوصى أن ينشر فقط بعد مماته بعد ما تقاعد: "يشعر المرء بأنه مسؤولٌ تماما عن أيّ شخصٍ تمضي أموره بشكل سيئ"، فيلسوف لا ينطلق من الهرم الفلسفي أبدا، ولكن من خلال هدمه أو سؤاله، حتى وإن مال إلى جانب سبينوزا، إلا أنه ينطلق إلى الفلسفة من منظور شعبي، لا من خلال أبراج نيتشه أو أبراج إيمانويل كانط العقلية الخالصة.
يحتار المرء في أمر ما يكتُب، رغم أنه لم يتشوّق أبدا لكتابة روايةٍ كما يحلو للفلاسفة، ويعتبر الأدب برمته، رغم ارتكازه عليه في فلسفته: "الأدب الآن هو شأن خاص ضئيل" لا من حيث القيمة، ولكن من حيث زاوية الاهتمام والإخلاص، ومصير صاحبه أيضا.
يضرب دولوز بسهام عديدة في مسألة الأسلوب أو اللغة والموسيقى والتعليم الذي امتهنه، وكان سعيدا به بعيدا عن مشروعه الفلسفي، من دون أن يعتبر نفسه من نقّاد الأدب، والسفر من دون أن يسافر إلا نادرا، فحينما يتكلم عن الأسلوب يقول "لن يكتب أحد أبدا مثل بيجي"، والسبب لدى دولوز هو التلعثم في كتابته، يمكن القول إن أسلوبه تلعثم، ويصف الأسلوب "كلغة أجنبية في اللغة"، أي خلف لغة أجنبية في اللغة كما فعل كيرواك مثلا. وفي التعليم، تراه أشبه بكلاسيكي جدا من دون أن يفقد وهجه الحداثي بغير ادّعاء أو طنطنة فارغة "أنا مستعدٌّ تماما، أريد أن أتعلم الأشياء، لأننا لا نعرف شيئا، لكن لما كانت الصحف لا تقول شيئا هي الأخرى، فماذا يمكن للمرء أن يفعل؟"، ويقول دولوز عن جدوى التعليم وغايته "العلاقة التي يمكِن أن يقيمها المرء مع طلابه تعني أن يعلّمهم ضرورة أن يكونوا سعداء بعزلتهم"، فهل العزلة ضرورة للمرء إلى هذا الحد؟ فما الحيلة في فهم هذا الفيلسوف الشعبي بفلسفته الشعبية التي انطلق فيها من عزلته عن النخبة من دون أن يلفّ أو يدور في مصالحها أو دوائرها بعد ما أسند ظهرَه إلى عزلة ما بعد ما أحيل إلى التقاعد خصوصا ومن قبلها بعقود.
وعن الموسيقى، بعد ما أحيل إلى التقاعد بعد الستين يقول: "ببساطةٍ، ليس لدي الوقت للاستماع إلى الموسيقى".
أما عن السفر فقد ضرب فيه بأسهم موجعة وإيضاحات وجب الوقوف عليها، ".. وشخصيا لم أحبّ السفر أبدا"، "... ولم أعرف أبدا حقّا كيف أسافر، رغم أنني أحترم الرحّالة كثيرا"، هل كان دولوز الذي سافر من قبل إلى بيروت "ومشى فيها وحده من دون صحبةٍ حتى آخر الليل"، وكندا ... إلخ، قد وصل إلى قمّة عجزه الجسماني بعد ما تقاعد من عمله بعد الستين، حينما قال في حواره الذي أوصى بنشره فقط بعد موته "ما يجعل الشيخوخة مثيرة للرثاء، ما يجعلها شيئا حزينا، هو هؤلاء العجائز البائسون الذين لا يملكون من النقود ما يكفي لعيشهم". هل كان ذلك كله بمثابة مقدّمة حزينة لجيل دولوز والذي أقدم على الانتحار في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1995 مُلقيا نفسه من نافذة شقّته وهو في السبعين من عمره، تاركا وراء ظهره بقية مشاريعه الفلسفية.