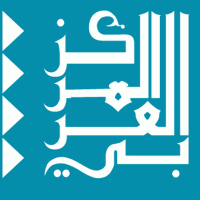25 يوليو 2024
قمة موسكو.. هل يصمد اتفاق وقف إطلاق النار حول إدلب؟
بوتين وأردوغان قبل محادثاتهما بشأن سورية في موسكو (5/3/2020/Getty)
توصل الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في لقاء قمة عُقد في موسكو في 5 آذار/ مارس 2020، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وجاء الاتفاق الذي قدِّم بوصفه ملحقًا لاتفاق سوتشي لعام 2018، على خلفية التصعيد الكبير الذي شهدته إدلب عقب هجومٍ شنّته قوات النظام السوري وحلفاؤها للسيطرة على الطرق الرئيسة في المحافظة، وتحوّل إلى مواجهةٍ مباشرةٍ مع وحدات من الجيش التركي، بعد تعرّض الأخيرة لهجومٍ أدّى إلى مقتل 33 عنصرًا منها في 27 شباط/ فبراير 2020.
بنود الاتفاق
اشتمل الاتفاق الذي أُعلن عنه، في ختام اجتماع استغرق ست ساعات بين الرئيسين بوتين وأردوغان، وقرأه وزيرا خارجية البلدين في مؤتمر صحفي مشترك، على ثلاث نقاط رئيسة: وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليلة 6 آذار/ مارس 2020، وإنشاء ممر آمن على طول الطريق الدولية حلب - اللاذقية "إم 4"، بعمق 6 كيلومترات شمال الطريق ومثلها جنوبه، وبدء تسيير دوريات مشتركة روسية - تركية على الطريق الدولية من بلدة الترنبة (الواقعة غرب سراقب) وصولًا إلى بلدة عين حور (الواقعة في ريف اللاذقية) بحلول 15 آذار/ مارس.
وفي ملحق خاص، نصّ الاتفاق على التزام البلدين بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، والقضاء على "الجماعات الإرهابية في سورية على النحو الذي حدّده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، ومنع تهجير المدنيين وتيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم، وعلى أولوية الحل السياسي بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، لعام 2015.
الطريق إلى موسكو
يمكن اعتبار اتفاق موسكو محاولة روسية - تركية لإنقاذ التفاهمات التي توصل إليها الجانبان
حول سورية منذ انطلاق مسار أستانا مطلع عام 2017، وخصوصًا اتفاق سوتشي لعام 2018 الذي جاء، بدوره، لإنقاذ منطقة خفض التصعيد الأخيرة في إدلب، بعد أن سيطر النظام السوري على المناطق الثلاث الأخرى (في محيط دمشق ودرعا وحمص)، خارقًا اتفاقًا بشأنها تم التوصل إليه في أيار/ مايو 2017.
نص اتفاق سوتشي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام السوري، في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، بعرض يراوح من 15 إلى 20 كيلومترًا. كما نص على التزام الجانب الروسي بضمان عدم القيام بعملياتٍ عسكرية في إدلب، في مقابل إبعاد الجماعات "المتطرّفة" عن المنطقة المنزوعة السلاح، و"العمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية، واستعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب - اللاذقية) وإم 5 (حلب - حماة) بحلول نهاية عام 2018". كما أكد الطرفان "عزمهما محاربة الإرهاب داخل سورية بجميع أشكاله وصوره"، واتخاذ "إجراءاتٍ فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب". وتقوم تركيا وروسيا بتسيير دوريات عسكرية منسقة لمراقبة الالتزام بالاتفاق باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة المنزوعة السلاح. وبموجب الاتفاق أيضًا، تنشئ تركيا 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، لحماية وقف إطلاق النار.
لم يصمد اتفاق سوتشي أكثر من بضعة أشهر؛ ففي مطلع أيار/ مايو 2019، بدأ النظام وحلفاؤه الروس حملة عسكرية كبيرة في محاولة للوصول إلى الطرق الدولية والسيطرة عليها. وجاء التصعيد على خلفية فشل جولة محادثات أستانا، نهاية نيسان/ أبريل 2019، في التوصل إلى اتفاقٍ بشأن أسماء أعضاء اللجنة الدستورية، التي انبثقت من مؤتمر سوتشي في كانون الثاني/ يناير 2018، ومهماتها وآليات عملها. وتذرّعت روسيا حينها بأن التصعيد الأخير جاء بعد هجماتٍ نفذتها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) أدّت إلى مصرع 22 جنديًا من قوات النظام. وقد اتهمت روسيا تركيا بالمسؤولية عن الإخلال بتعهداتها بموجب اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح، وأنها في حاجةٍ إلى تأمين مطار حماة العسكري، وقاعدة حميميم الجوية التابعة لها في ريف اللاذقية، التي زعمت موسكو أيضًا أنها تتعرّض لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من المنطقة المنزوعة السلاح.
خلال المعارك التي استمرت بين الجولتين 12 و13 من محادثات أستانا (نيسان/ أبريل وآب/ أغسطس 2019، على التوالي)، تمكّن النظام وحلفاؤه الروس من السيطرة على مساحاتٍ واسعة من منطقة خفض التصعيد، شملت أجزاء واسعة من ريفي حماة الشمالي والغربي وبلداته الكبرى، أهمها قلعة المضيق وكفرنبودة. كما سقطت مدينة خان شيخون الاستراتيجية الواقعة على الطريق الدولية حلب - حماة بعد ذلك بقليل.
وعشية الجولة 13، تم التوصل إلى هدنةٍ جديدة، كرّستها القمة الثلاثية الروسية –
التركية - الإيرانية في أنقرة في أيلول/ سبتمبر 2019، التي شهدت تحولًا في الموقفين، الروسي والإيراني، من سياسات أنقرة في مناطق شرق الفرات. وأعربت القمة الثلاثية عن تفهمها المخاوف الأمنية التركية في مناطق شرق الفرات، في ظل تهديد الرئيس أردوغان بشن عملية عسكرية كبيرة لإبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تمثل وحدات حماية الشعب (الكردية) مكوّنها الرئيس، عن الحدود السورية - التركية، وإفشال محاولات إقامة جيب كردي في المنطقة. كما أكدت القمة احترام هدنة آب/ أغسطس، والاتفاق على تفاصيل إنشاء اللجنة الدستورية بعد أكثر من 18 شهرًا من المفاوضات والمشاورات.
وكان دافع الروس والإيرانيين إلى تقبّل العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في مناطق شرق الفرات في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، هو إخراج الأميركيين، والأوروبيين، وخصوصًا الفرنسيين الذين كانوا يحتفظون بنحو 400 عنصر من قواتهم الخاصة لدعم الأكراد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال شرق سورية، وكذلك إخراج السعودية والإمارات اللتين أنشأتا علاقات قوية مع "قسد"، وتوجيه ضربةٍ إلى طموحات الكرد الانفصالية في المنطقة. وقد دفع ذلك كله الروس والإيرانيين إلى عدم معارضة العملية التركية شرق الفرات، بدليل أن وقف إطلاق النار في إدلب ظل صامدًا خلال تلك الفترة، على الرغم من محاولات النظام المحدودة للتصعيد.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، توصل الروس والأتراك إلى اتفاقٍ جديد في سوتشي، تعهدت بموجبه موسكو بالعمل على سحب وحدات حماية الشعب (الكردية) من كامل الشريط الحدودي السوري - التركي الواقع شرق الفرات، وتسيير دورياتٍ مشتركة روسية - تركية لضمان التنفيذ. وفي المقابل، أوقفت تركيا عمليتها العسكرية "نبع السلام" التي بدأتها بالتفاهم مع الأميركيين. ولكن ما إن انتهت العملية العسكرية التركية في مناطق شرق الفرات، حتى عادت موسكو إلى التركيز على إدلب في هجوم كبير بدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
عملية "درع الربيع"
تمكنت قوات النظام السوري، وحلفاؤها الروس والإيرانيون، خلال الهجوم الذي بدأ منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2019 من السيطرة على مناطق جديدة واسعة في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وريفي حلب الجنوبي والغربي، ومن أهم المناطق التي سقطت بيد النظام في هذه الهجمة الأخيرة: بلدتي معرّة النعمان وسراقب الواقعتين على الطريق الدولية حلب - حماة، حيث تجاوز النظام عددًا من نقاط المراقبة التركية التي أنشأتها أنقرة بموجب اتفاق سوتشي لعام 2018، وقام بحصارها. ومع فشل كل المحاولات التي بذلتها تركيا لدفع روسيا إلى الالتزام باتفاق إنشاء المنطقة العازلة، وإجبار قوات النظام السوري على الانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية، هدّد أردوغان بإطلاق عملية عسكرية في إدلب، إذا لم تنسحب قوات النظام السوري خلال مهلة تنتهي آخر شباط/ فبراير 2020، وعزّز تهديداته بدفع الآلاف من قواته إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب. وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا يمكن عودة الوضع في إدلب إلى ما كان عليه قبل سنة ونصف، أي عندما وقِّع اتفاق سوتشي. وبناء عليه، تعرّضت القوات التركية التي كانت تساند فصائل المعارضة السورية، في محاولاتها استعادة السيطرة على مدينة سراقب، لهجوم كبير في 27 شباط/ فبراير، أدّى إلى مقتل 33 جنديًا تركيًا في بلدة بليون في ريف إدلب الجنوبي. وردًا على ذلك، أطلقت تركيا عملية "درع الربيع"، التي استهدفت خلالها عشرات المواقع التابعة لقوات النظام والمليشيات الإيرانية المتحالفة معه؛ ما أدّى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفها. وقد كان لافتًا امتناع روسيا عن التدخل لصالح حلفائها في المواجهة مع الجيش التركي.
دفعت العملية التركية بوتين إلى القبول بمقترح تركي لعقد قمة روسية - تركية لاحتواء الموقف الذي بدأ يخرج عن السيطرة في إدلب، فوافق على عقد قمة في موسكو، بعد أن كان غير متحمس لأي لقاء مع أردوغان. وكانت كل جولات المفاوضات التي عقدها موفدون روس وأتراك في موسكو وأنقرة فشلت قبل ذلك في التوصل إلى اتفاقٍ لوقف القتال، نتيجة رفض روسيا العودة إلى حدود اتفاق سوتشي، وإصرارها على احتفاظ النظام بمكاسبه على الأرض.
اتفاق مرحلي جديد؟
في صيغته الحالية، لا يلبي الاتفاق أيًّا من المطالب التركية، ولا سيما العودة إلى حدود اتفاق
سوتشي التي تعني انسحاب قوات النظام من المناطق والبلدات التي سيطرت عليها منذ بدء الهجوم على منطقة خفض التصعيد مطلع أيار/ مايو 2019. ويغفل الاتفاق أيضًا تفاصيل كثيرة مهمة أخرى، فهو لا يتحدث عن مصير الطريق الدولية حلب - حماة "إم 5" التي سيطر عليها النظام كليًا في الأسابيع الأخيرة، بعد أن استولى على البلدات الرئيسة الواقعة بمحاذاتها، خصوصًا معرّة النعمان وسراقب. وسكت الاتفاق كذلك عن مصير نقاط المراقبة التركية التي يحاصرها النظام، وعددها 12 نقطة، وإنْ كانت ستبقى مكانها أم ستنسحب، وكانت أنقرة هدّدت بشنّ عملية عسكرية لطرد قوات النظام إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية، إذا لم يُفك الحصار عنها والانسحاب إلى ما وراءها. وعلى الرغم من أن الاتفاق تحدّث عن عودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم، فإنه لم يوضح كيف سيجري ذلك، خصوصا في المناطق التي سيطر عليها النظام. ويبقى أخيرًا سؤال الممر الآمن الذي فرضه الروس بعمق 6 كيلومترات شمال طريق حلب - اللاذقية وجنوبه، الذي يعد أيضًا، بصيغته الحالية، مكسبًا للنظام. وتدفعنا هذه النقاط إلى الاعتقاد أن اتفاق موسكو قد لا يكون أكثر من اتفاق مرحلي آخر، لن يلبث إلا أن ينهار، إلا إذا تمكّن الروس والأتراك من تطويره إلى اتفاقٍ أكثر تماسكًا في إطار حل سياسي شامل للصراع في سورية؛ فبنيته تشبه بنية بقية الاتفاقات التي اعترفت بتقدم النظام والروس والإيرانيين إلى حين خرقها بتقدم جديد.
خاتمة
حتى الآن، تدل كل المؤشرات على أن هدف الجولة الأخيرة من القتال وضع الطرق الدولية تحت سيطرة النظام، وقد تمكّنت روسيا من تحقيق ذلك بالقوة، بخصوص طريق حلب – حماة، بدليل القتال العنيف الذي جرى حول سراقب، وإصرار موسكو على السيطرة عليها لتتحول إلى أمر واقع قبل اجتماع موسكو، في حين نص الاتفاق على فتح الطريق الأخرى، حلب – اللاذقية، أمام حركة المرور والتجارة عبر إنشاء ممرٍّ آمن في مناطق سيطرة المعارضة، وتسيير دوريات مشتركة روسية - تركية لضمان تنفيذه. ولكن هذا لا يمنع أيضًا من القول إن الاتفاق، بصيغته الراهنة، يعكس موازين القوى على الأرض في إدلب، وكذلك الظروف السياسية المحيطة به، فهو، من جهة، يشير إلى أن موسكو ما زالت مهتمةً بالحفاظ على مسار أستانا، باعتباره أداتها الوحيدة لفرض رؤيتها للحل السياسي في سورية. ومن جهة أخرى، وفي إطار استراتيجي أوسع، ما زالت روسيا مهتمة بإبقاء تركيا قريبة منها، وربطها بها باتفاقات حول التجارة والطاقة، وحتى تزويدها بمنظومة صواريخ "إس 400"، ويدل على ذلك امتناع موسكو عن التدخل لحماية حلفائها من الهجوم التركي الواسع الذي جاء في إطار العملية العسكرية "درع الربيع" التي أطلقتها تركيا لوقف تقدم النظام وحلفائه في إدلب، وأوقعت بهما خسائر فادحة. تركيا من جهتها، وعلى الرغم من أنها تحاول الحفاظ على علاقتها ومصالحها المتشابكة مع موسكو، فإنها تمكّنت أيضًا من تأكيد أهمية إدلب بالنسبة إليها من خلال دعمها الناري لقوات المعارضة السورية، ثم دخولها مباشرة في المعارك إلى جانبها، في إشارةٍ إلى استعدادها لتصعيد محسوب دفاعًا عن دورها ومصالحها في سورية.
اشتمل الاتفاق الذي أُعلن عنه، في ختام اجتماع استغرق ست ساعات بين الرئيسين بوتين وأردوغان، وقرأه وزيرا خارجية البلدين في مؤتمر صحفي مشترك، على ثلاث نقاط رئيسة: وقف إطلاق النار ابتداءً من منتصف ليلة 6 آذار/ مارس 2020، وإنشاء ممر آمن على طول الطريق الدولية حلب - اللاذقية "إم 4"، بعمق 6 كيلومترات شمال الطريق ومثلها جنوبه، وبدء تسيير دوريات مشتركة روسية - تركية على الطريق الدولية من بلدة الترنبة (الواقعة غرب سراقب) وصولًا إلى بلدة عين حور (الواقعة في ريف اللاذقية) بحلول 15 آذار/ مارس.
وفي ملحق خاص، نصّ الاتفاق على التزام البلدين بسيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، والقضاء على "الجماعات الإرهابية في سورية على النحو الذي حدّده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، ومنع تهجير المدنيين وتيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى أماكن إقامتهم، وعلى أولوية الحل السياسي بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، لعام 2015.
الطريق إلى موسكو
يمكن اعتبار اتفاق موسكو محاولة روسية - تركية لإنقاذ التفاهمات التي توصل إليها الجانبان
نص اتفاق سوتشي على إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين مقاتلي المعارضة وقوات النظام السوري، في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، بعرض يراوح من 15 إلى 20 كيلومترًا. كما نص على التزام الجانب الروسي بضمان عدم القيام بعملياتٍ عسكرية في إدلب، في مقابل إبعاد الجماعات "المتطرّفة" عن المنطقة المنزوعة السلاح، و"العمل على ضمان حرية حركة السكان المحليين والبضائع، واستعادة الصلات التجارية والاقتصادية، واستعادة حركة الترانزيت عبر الطريقين إم 4 (حلب - اللاذقية) وإم 5 (حلب - حماة) بحلول نهاية عام 2018". كما أكد الطرفان "عزمهما محاربة الإرهاب داخل سورية بجميع أشكاله وصوره"، واتخاذ "إجراءاتٍ فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف النار داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب". وتقوم تركيا وروسيا بتسيير دوريات عسكرية منسقة لمراقبة الالتزام بالاتفاق باستخدام طائرات من دون طيار، على امتداد حدود المنطقة المنزوعة السلاح. وبموجب الاتفاق أيضًا، تنشئ تركيا 12 نقطة مراقبة للجيش التركي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، لحماية وقف إطلاق النار.
لم يصمد اتفاق سوتشي أكثر من بضعة أشهر؛ ففي مطلع أيار/ مايو 2019، بدأ النظام وحلفاؤه الروس حملة عسكرية كبيرة في محاولة للوصول إلى الطرق الدولية والسيطرة عليها. وجاء التصعيد على خلفية فشل جولة محادثات أستانا، نهاية نيسان/ أبريل 2019، في التوصل إلى اتفاقٍ بشأن أسماء أعضاء اللجنة الدستورية، التي انبثقت من مؤتمر سوتشي في كانون الثاني/ يناير 2018، ومهماتها وآليات عملها. وتذرّعت روسيا حينها بأن التصعيد الأخير جاء بعد هجماتٍ نفذتها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) أدّت إلى مصرع 22 جنديًا من قوات النظام. وقد اتهمت روسيا تركيا بالمسؤولية عن الإخلال بتعهداتها بموجب اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح، وأنها في حاجةٍ إلى تأمين مطار حماة العسكري، وقاعدة حميميم الجوية التابعة لها في ريف اللاذقية، التي زعمت موسكو أيضًا أنها تتعرّض لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من المنطقة المنزوعة السلاح.
خلال المعارك التي استمرت بين الجولتين 12 و13 من محادثات أستانا (نيسان/ أبريل وآب/ أغسطس 2019، على التوالي)، تمكّن النظام وحلفاؤه الروس من السيطرة على مساحاتٍ واسعة من منطقة خفض التصعيد، شملت أجزاء واسعة من ريفي حماة الشمالي والغربي وبلداته الكبرى، أهمها قلعة المضيق وكفرنبودة. كما سقطت مدينة خان شيخون الاستراتيجية الواقعة على الطريق الدولية حلب - حماة بعد ذلك بقليل.
وعشية الجولة 13، تم التوصل إلى هدنةٍ جديدة، كرّستها القمة الثلاثية الروسية –
وكان دافع الروس والإيرانيين إلى تقبّل العملية العسكرية التي بدأتها تركيا في مناطق شرق الفرات في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، هو إخراج الأميركيين، والأوروبيين، وخصوصًا الفرنسيين الذين كانوا يحتفظون بنحو 400 عنصر من قواتهم الخاصة لدعم الأكراد في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في شمال شرق سورية، وكذلك إخراج السعودية والإمارات اللتين أنشأتا علاقات قوية مع "قسد"، وتوجيه ضربةٍ إلى طموحات الكرد الانفصالية في المنطقة. وقد دفع ذلك كله الروس والإيرانيين إلى عدم معارضة العملية التركية شرق الفرات، بدليل أن وقف إطلاق النار في إدلب ظل صامدًا خلال تلك الفترة، على الرغم من محاولات النظام المحدودة للتصعيد.
وفي 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، توصل الروس والأتراك إلى اتفاقٍ جديد في سوتشي، تعهدت بموجبه موسكو بالعمل على سحب وحدات حماية الشعب (الكردية) من كامل الشريط الحدودي السوري - التركي الواقع شرق الفرات، وتسيير دورياتٍ مشتركة روسية - تركية لضمان التنفيذ. وفي المقابل، أوقفت تركيا عمليتها العسكرية "نبع السلام" التي بدأتها بالتفاهم مع الأميركيين. ولكن ما إن انتهت العملية العسكرية التركية في مناطق شرق الفرات، حتى عادت موسكو إلى التركيز على إدلب في هجوم كبير بدأ في كانون الأول/ ديسمبر 2019.
عملية "درع الربيع"
تمكنت قوات النظام السوري، وحلفاؤها الروس والإيرانيون، خلال الهجوم الذي بدأ منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2019 من السيطرة على مناطق جديدة واسعة في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي، وريفي حلب الجنوبي والغربي، ومن أهم المناطق التي سقطت بيد النظام في هذه الهجمة الأخيرة: بلدتي معرّة النعمان وسراقب الواقعتين على الطريق الدولية حلب - حماة، حيث تجاوز النظام عددًا من نقاط المراقبة التركية التي أنشأتها أنقرة بموجب اتفاق سوتشي لعام 2018، وقام بحصارها. ومع فشل كل المحاولات التي بذلتها تركيا لدفع روسيا إلى الالتزام باتفاق إنشاء المنطقة العازلة، وإجبار قوات النظام السوري على الانسحاب إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية، هدّد أردوغان بإطلاق عملية عسكرية في إدلب، إذا لم تنسحب قوات النظام السوري خلال مهلة تنتهي آخر شباط/ فبراير 2020، وعزّز تهديداته بدفع الآلاف من قواته إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب. وفي المقابل، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه لا يمكن عودة الوضع في إدلب إلى ما كان عليه قبل سنة ونصف، أي عندما وقِّع اتفاق سوتشي. وبناء عليه، تعرّضت القوات التركية التي كانت تساند فصائل المعارضة السورية، في محاولاتها استعادة السيطرة على مدينة سراقب، لهجوم كبير في 27 شباط/ فبراير، أدّى إلى مقتل 33 جنديًا تركيًا في بلدة بليون في ريف إدلب الجنوبي. وردًا على ذلك، أطلقت تركيا عملية "درع الربيع"، التي استهدفت خلالها عشرات المواقع التابعة لقوات النظام والمليشيات الإيرانية المتحالفة معه؛ ما أدّى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفها. وقد كان لافتًا امتناع روسيا عن التدخل لصالح حلفائها في المواجهة مع الجيش التركي.
دفعت العملية التركية بوتين إلى القبول بمقترح تركي لعقد قمة روسية - تركية لاحتواء الموقف الذي بدأ يخرج عن السيطرة في إدلب، فوافق على عقد قمة في موسكو، بعد أن كان غير متحمس لأي لقاء مع أردوغان. وكانت كل جولات المفاوضات التي عقدها موفدون روس وأتراك في موسكو وأنقرة فشلت قبل ذلك في التوصل إلى اتفاقٍ لوقف القتال، نتيجة رفض روسيا العودة إلى حدود اتفاق سوتشي، وإصرارها على احتفاظ النظام بمكاسبه على الأرض.
اتفاق مرحلي جديد؟
في صيغته الحالية، لا يلبي الاتفاق أيًّا من المطالب التركية، ولا سيما العودة إلى حدود اتفاق
خاتمة
حتى الآن، تدل كل المؤشرات على أن هدف الجولة الأخيرة من القتال وضع الطرق الدولية تحت سيطرة النظام، وقد تمكّنت روسيا من تحقيق ذلك بالقوة، بخصوص طريق حلب – حماة، بدليل القتال العنيف الذي جرى حول سراقب، وإصرار موسكو على السيطرة عليها لتتحول إلى أمر واقع قبل اجتماع موسكو، في حين نص الاتفاق على فتح الطريق الأخرى، حلب – اللاذقية، أمام حركة المرور والتجارة عبر إنشاء ممرٍّ آمن في مناطق سيطرة المعارضة، وتسيير دوريات مشتركة روسية - تركية لضمان تنفيذه. ولكن هذا لا يمنع أيضًا من القول إن الاتفاق، بصيغته الراهنة، يعكس موازين القوى على الأرض في إدلب، وكذلك الظروف السياسية المحيطة به، فهو، من جهة، يشير إلى أن موسكو ما زالت مهتمةً بالحفاظ على مسار أستانا، باعتباره أداتها الوحيدة لفرض رؤيتها للحل السياسي في سورية. ومن جهة أخرى، وفي إطار استراتيجي أوسع، ما زالت روسيا مهتمة بإبقاء تركيا قريبة منها، وربطها بها باتفاقات حول التجارة والطاقة، وحتى تزويدها بمنظومة صواريخ "إس 400"، ويدل على ذلك امتناع موسكو عن التدخل لحماية حلفائها من الهجوم التركي الواسع الذي جاء في إطار العملية العسكرية "درع الربيع" التي أطلقتها تركيا لوقف تقدم النظام وحلفائه في إدلب، وأوقعت بهما خسائر فادحة. تركيا من جهتها، وعلى الرغم من أنها تحاول الحفاظ على علاقتها ومصالحها المتشابكة مع موسكو، فإنها تمكّنت أيضًا من تأكيد أهمية إدلب بالنسبة إليها من خلال دعمها الناري لقوات المعارضة السورية، ثم دخولها مباشرة في المعارك إلى جانبها، في إشارةٍ إلى استعدادها لتصعيد محسوب دفاعًا عن دورها ومصالحها في سورية.