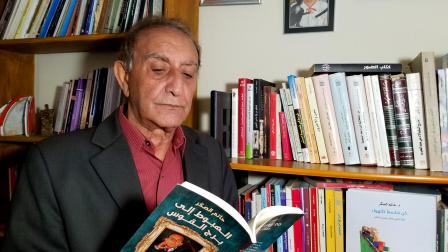الشرفة التي تطلّ على الماء
أجلس منذ الصباح على سطح الجيران المطلّ على بركة البيت الذي لم يعد بيتنا. أقضي وقت المدرسة هنا، فمدرستي الجديدة لا تكترث بطلابها مثل مدرستي القديمة.
أعود إلى مكاننا الجديد وقت الغداء، أفتح دفاتر مليئة بالخربشات أمام أُمّي، قائلًا لها إنني حللت وظائفي، فتسمح لي بالذهاب دون أن تتكلم، ودون أن أشعر بأنّها تراني حقًّا، فلم تعد أُمّي ذاتها منذ تركنا بيتنا القديم. فأرجع بسرعةٍ إلى مكاني هذا.
وبما أنني أمتلك الكثير من الوقت قبل أن يعود الملّاك الجُدد من أعمالهم وأطفالُهم من مدارسهم، فإنني سأحدّثكم عن بيتنا (لا أزال أسمح لنفسي بتسميته كذلك)، وعن أكثر الأشياء التي أُحبّها فيه. وبما أنني أجد صعوبةً بالغةً في إدراك أيّ أشياء المنزل أُحبّ أكثر، فإنني سأجعل الحديث يتدفق مني وحده دون أن أضبطه بقيودِ التفضيل أو الأهميّة.
لكن قبل ذلك، دعوني أخبركم عن المكان الذي أجلس فيه قبل أن تستغرقني الذكريات فأنسى. إنني أجلس على سطح بيتٍ غير مكتمل البناء، خلف شبهِ جدارٍ ينشزُ عن مظهر السطح، بفتحةٍ في منتصفه تُعينني على أن أكون لامرئياً وقت التجسس.
هذا المبنى يُشبهني، بنته "العانسات الثلاث" (كما يُطلق رجال حيّنا السابق عليهن) لأخيهنّ المهاجر مع عائلته. بنينه حجراً حجراً من دخل الخياطة والبقالة قرب بيتنا، دون أن يكتمل البناء منذ عشر سنواتٍ، فظلّ عظمًاً بلا لحمٍ، لأنّ الأخ المسكين ترك الحياة أيضاً كما تركهنّ.
أنا هنا على السطح المجاور لحياتي السابقة، أجلس لساعاتٍ كلّ يومٍ، أشعر أحياناً بأنني أجلس هنا منذ أسابيع، لكن ذلك مستحيلٌ لطفلٍ لم يبلغ العاشرة بعد. كأن الوقت لا يمر عليّ كما يمرّ على الآخرين، وأحياناً كثيرةً تحتلّ التفاصيلُ الغائرة في ذاكرتي المشهدَ أمامي، وتصيبني أحياناً أُخرى فترات عماءٍ حين يخلد السكان الجدد إلى النوم في الليل، ولا يتركون مصباحاً واحداً مضاءً في الخارج.
لكن ها أنا كعادتي الجديدة أنسى ما بدأته، أشذّ عن الموضوع، أو أُكرر الأفكار نفسها بصياغةٍ أُخرى (كما في الفقرة الأخيرة). فقد اكتشفت مؤخراً لعبة اللغة، أصبحت أُسلّي نفسي بإنهاك المعنى بالصياغات العديدة، أصبحت أعزيّها بتكرار المفردات الموحية بالدوام.
فدعوني إذن أعود للحديث - كما قلتُ سابقاً - عن أكثر ما أُحبّ في بيتنا. إنّ بيتنا مليء بالقناديل، فقد كان والدي تاجر تحفٍ يجلبها معه من سفراته العديدة. لكنّ أجمل القناديل التي نملكها كانت ثلاثة قناديل ساحرةٍ انتقاها والدي خصيصاً لمنزلنا من المغرب.
علّقنا قنديلين توأمين خارج البيت في المظلّة الحجريّة التي تصنعها شرفة غرفة والديّ المطلّة على المسبح. كنتُ أحرص أن أُضيئهما دائماً في الليل حين ينام ناسياً عادته في ترك ضوءٍ للخارج. وعلّقنا الآخر - الأجمل دون شكٍّ - داخل منزلنا، كي نقيه الريح.
كانت الريح تهبّ في الخارج، فيتأرجح ضوء التوأمين فوق الأشياء، مما يجعلني أعزل وجود المصباحين، فأنظر إلى الريح والضوء معاً، فأشاهد الريح تُحرّك الضوء مباشرةً، يُحرّك الهواءُ شبه الماديّ اللّاماديَ الأصفر المنبعث من المصباحين.
لكن اسمحوا لي أن أقطع مؤقتاً الحديث عن القناديل، وأن أحدّثكم عن المرآة التي تذكرتها الآن والتي تُلّح عليّ أن أتحدث عنها، إذ تعرف المرآة مدى سوء ذاكرتي في الآونة الأخيرة. ولا شكّ بأنني لن أنسى القنديل الآخر حين أتحدث عنها، نظراً للتجانس الكبير بينهما.
كانت المرآة الواقعة أمام الدرج مزخرفةً بالفنّ العربي. كان يُفرِحني نزولي من الطابق العلويّ على الدرجات الواحدة والعشرين، حتى أشاهد نفسي بتحبّبٌ فيها.
كان إطارها المربّع ذهبيّ اللّون، يحضنُ في الزوايا الأربع قطع بلاطٍ يختلط فيها التركواز باللّازورد، تعرش فوقها ورودٌ حلم بها أطفالٌ مكفوفون ينامون في الحدائق، وتتمايل أعناقها الشبيهة بخصور الراقصات حول أشكالٍ هندسيّةٍ زاخرة الألوان تُشاكس المربّع. ثمّ تلتقي القطع الأربع معاً (كأنّها تُعيد اللقاء كلّما نظرتَ إليها) مشكّلةً ما يشبه نجمةً زجاجيّةً تعكس عالماً آخر أكثر كثافةً، فيُخيّل للناظر أنّ الصّورة - اللّوحة داخل المرآة إذا ما قورنت بما خارجها هي الحقيقيّة دون ريب.
كان الدرج يقع قرب المطبخ المفتوح، يفصلهما جدارٌ صغيرٌ يحرس السلام بينهما. كنت أستلقي على ظهري تحت أنظار المرآة، فوق مصطبته الضيقة التي بالكاد تسع جسدي، أحدّق في القنديل المعلّق في أعلى سقف الدرج، مشتمّاً روائح الطبخ الشهيّة تنبعث من يدي أُمّي. كان قنديلاً عتيقاً، كأنّه وُلد من بنات أفكار صانع المرآة، محفوراً بزخارف هندسيّةٍ تشبه أشكال أوراق الأشجار التي تسقط قبل غيرها أوّل الخريف، ومنقوشاً بألوان زرقاء وخضراء وحمراء تتراصّ قرب بعضها البعض، راقصةً بلا حركةٍ في دائرةٍ سوداء عميقةٍ يُخيّل إليّ أنّها قادرة ٌ- إذا وقع المصباح - على أن تُغرق الكون داخلها كقطرةٍ في بحرٍ سرمديّ.
كنت أجلس على ظهري لساعاتٍ، أحدّق كعاشقٍ في بهاء سقف منزلنا، وبالشمس المموجة التي يعكسها ضوء القنديل المزخرف، والتي تغطي السقف كلّه حتى باب القرميد المعلّق.
كانت غرفتي هي الغرفة الوحيدة بالطّابق الأول. كنت أشعر بأنّها بيتٌ داخل البيت، فأنا أمتلك باباً خاصاً شبيهاً بنافذةٍ، يُطلّ مباشرةً على المسبح. ففور استيقاظي كنتُ أفتح النافذة - الباب، وأجد نفسي وجهاً لوجهٍ قبل الجميع أمام الماء الأزرق الشفّاف، والذي ينادي كلّ خليّةٍ في جسدي. بعد ذلك أعود إلى غرفتي، أفتح نافذتي الشرقيّة والباب الخشبيّ مُعيداً غرفتي إلى البيت. حينها يلتقي كلّ شعاع شمسٍ بأخيه القادم من الجهتين الأُخريين.
كما أنني كنت أُحبّ الدخول من نافذة الغرفة التي لا تمتلك حماياتٍ حديدية، والتي كنت أضع بقربها في الخارج دراجتي الهوائيّة التي أركبها وأنا منقسمٌ بفضل النافذة إلى شخصين، أحدهما في الداخل والآخر في الخارج، سرعان ما سيتّحدان مجدداً في الهواء على مقعد الدراجة.
كانت البركة امتداداً لسريري؛ تقع أمامه مباشرةً مشاركةً إيّاه لحافه الأزرق، ذلك الذي تسبح فيه الدلافين الصغيرة مقلّدةً والديها المصنوعين من فسيفساءٍ في القاع. كان الوالدان يحملاني على ظهريهما حين كنتُ ألمسهما بأصابع قدميّ خائفاً في أوّل الماء، يأخذاني في رحلةٍ إلى أعماقِ بركتنا، ويعلّماني على مهلٍ السباحة كوالدٍ يُعلّم ابنه ركوب الدراجة.
كانت طيورٌ سوداء لا أعرف اسمها تأتي وتشرب الماء وأنا أسبح دون أن تخاف مني، فقد ألفت وجودي بعد أن اعتادت مشاهدتي كلّ يومٍ. وحين أنتهي من السباحة كفرخ دلفينٍ طوال النّهار، كنت أجلس في الليل مع كوب شاي في يدي، محوّطاً بمعطفٍ خفيفٍ على الأُرجوحة الواقفة قرب باب غرفتي، كأنني أجلس في عشّ طائر الفرنار أحمر الطين، هازاً عشّي كلّ هنيهةٍ كي أطرد بقايا البرد، ومراقباً أضواء القنديلين الشبيهة بمراكب صيدٍ كبيرةٍ على سطح الماء، والقوارب الصغيرة المصنوعة في دوائر القرميد.
كانت تهبّ أحياناً ريحٌ قويةٌ، تضرب الماء مباشرةً فتتولّد أمواج المدّ، فأشعر حينها بأننا نمتلك بحراً في فناء بيتنا، يحميني من غضبه معطفي ووسادات الأُرجوحة الواقفة في مكانٍ لا تضربه العاصفة.
حينها أنفخ في الشاي الساخن جدّاً كي أشعر عندما أُشاهد اهتزاز الماء المنقّط بالضوء في كأسي، أنني أنفخ في بركةٍ صغيرةٍ بين يديّ، متحداً مع الريح التي تُغرق في الوقت ذاته مراكب الصيد والزوارق الصغيرة في بحرنا.
ها قد عاد سكان منزلنا، فالأُمّ تفتح شبابيك شرفة والديّ. كيف مرّ الوقت بهذه السرعة؟ إنّها ترتدي ثيابها التي لا أُحبّ ملمسها ولونها، إنّ ثيابها من قماشٍ خفيفٍ صارخ الألوان يتسلل الهواء منه بسهولة، تُناسب أثاث الغرفة العصري. أما ثياب أُمّي فمن صوفٍ يُكمّل الأثاث القديم ذا الخشب السميك.
أتذكر تمددي على ثيابها في الخزانة الكبيرة التي كنتُ أختبئ بها إذا أردت الجلوس مع نفسي، أو العبور إلى عالمٍ آخر انطوى داخلها لا يعرف غيري بوجوده.
وحين كانت أُمّي تضيء الشموع في غرفتها، كانت قطع الأثاث تتحدث مع بعضها البعض، إذ تكتسب أفواهاً من انعكاس لهب الشموع على خشبها البني. انظروا جيّداً إلى لهب الشمعة، ألا يُشبه شكل فمٍ؟ استخدموا خيالكم قليلاً لتكملوا شفتيه إذا أردتم، أمّا قطع أثاثنا فقد كانت تتحدث بلا صوتٍ، وإذا ما احتاجت إلى المجاز، فبوسع أُمّي بثيابها الصوفيّة أن تكون استعارة.
أراهم الآن يُخرجون المرآة، لطالما سمعتُ المرأة تطلب من زوجها تبديلها، لا شكّ أن مرآتنا الوفيّة لا تزال تعكس بين الفينة والأُخرى ظلالاً لحياتنا السابقة. فاختارت تلك المرأة التي لا تريدُ سوى انعكاسها، أن تضع مكانها ببغاءً مزعجاً يُقلّد برداءةٍ رتيبةٍ المشهد أمامه.
إنّها تظنّ المرآة مجرد ديكورٍ تستطيع تغييره متى تشاء، لا تأبه لشعور القنديل، ولا تعرف أنّ المرآة فردٌ عائليٌّ يحفظ كغيره تناغم الأشياء. لذلك أشعر بالخوف على المنزل، فكلّ قطعةٍ فيه تُشبه آجرة الخورنق، إن أُزيلتْ تهاوى بلا شكٍّ ولو بعد حينٍ.
كانت قصّة سمنار (بالرواية الخاصّة بمنزلنا) حكايتي المفضّلة في طفولتي، سمعتها أوّل مرّةٍ من أُمّي التي تمتلك مكتبةً محفورةً في خشب سريرها، حين كنتُ طفلاً مشاغباً يُزيل الأشياء من مكانها، فلم أجرؤ من وقتها على اللّهو بنظام البيت. وأسمعها بينما أتحدث إليكم، تُنشَدُ بغضب القنديل ذي الدائرة السّوداء، الذي يهتزّ فوق الفراغ الأبيض الذي خلّفته المرآة...
لقد خرج الطفل الذي يُماثلني في السن كي يلعب كعادته على دراجته بعد الغداء (لن أعود اليوم إلى الغداء، كعادتي في كلّ يومٍ يسبق العطلة الأُسبوعيّة). في ما مضى، كنتُ أركب دراجتي مسرعاً حول البركة، فأشعر بلذّة ملامسة السقوط.
لطالما فكرتُ وأنا أقترب مُسرعاً بدراجتي من المسبح بأن لا أتوقف، كنتُ أحلم بقيادتها وبتبديل الدوّاستين في الماء، لكنني لم أفعل ذلك قط، ربما بسبب الخوف على دراجتي من الصدأ، من الشيء نفسه الذي يأكلها الآن على مهلٍ مع أخواتها في الشرفة الضيّقة للشقة.
إنني أكره هذا الولد الغبي متبلد الإحساس، إذ كان يركض حول البركة بفرحٍ ساذجٍ حين سلّم والدي مفتاح البيت لوالده والدموع في عينيه. كان أبي هو الذي صمم منزلنا، كان يقول لي - وهو يحملني على كتفيه كي ألمس القناديل - إنّ البيت انتقل من رأسه إلى أرضٍ خاليةٍ ورّثه إيّاها والده، وكانت هذه الجملة تذهلني كلّما فكّرت فيها، إذ أستشعر اللانهاية كلّما تخيلتُ والدي يمشي في بيتٍ موجودٍ داخله.
لذلك أنفخ على الطفلِ الذي يحتلّ غرفتي كلّما اقترب من الماء، وتمايلتْ درّاجته بحيث تبدو للناظر أنّها تحتاح مجرد نفخةٍ صغيرةٍ كي تقع، أنفخ بكلّ قوّتي محاولاً استعادة اتحادي مع الريح كي يسقط في الماء الأخضر الكريه الذي تحتله الطحالب، فلا أحد يفهم مزاج بركتنا كأخي الكبير الذي يمتلك مهارة رعايتها (كي لا أقول ترويضها).
فالبركة كائنٌ أثيريٌّ يحتاج إلى عنايةٍ بالغةٍ، كأنّكم تمتلكون حقلاً مزروعاً بالماء، إذا أهملتم أشجاركم ستنهشها الأمراض وتحتلها الحشرات وتسقط أوراقها، وإذا أهملتم بركتكم ستغرق في نفسها المخضرّة من غزو الطحالب والكائنات الدقيقة كالبكتيريا.
أنفخُ فأجد نفسي أمام شموعٍ مضاءةٍ أمام المسبح، أصير جسداً تُحيطه هالةٌ من الضحكات شبيهةٌ بهالة الأولياء. إنهم يحتفلون بعيد ميلادي، يحتفلون بالمباني التي سأصير في الغد حجارتها، كأن الأرض لولاي ما أتمّت دورتها حول الشمس!
أشعر أحياناً أن هذا الولد يستطيع رؤيتي، إذ يُحدّق بغرابةٍ نحو موقعي، لكنني لا أهتم بذلك، فلا أحد يُصدّق خيالات الأطفال. كما أنني أتمنى أن يراني فعلاً، لعلّه يُدرك أنّه لا يشبهني، فقد سمعت أبي يقول لأُمّي إنّه شاهد شبهاً كبيراً بيننا.
فهذا الولد -على عكسي - يخاف النوم في العتمة، وكلما ضربتُ ببقايا حجارة البناءِ الماءَ أمامي ونافذةَ غرفتي، بعد أن أختار أخفّها ضرراً على الأشياء وأكثرها امتلاءً بالنتوءات، أُشاهده من طرف النافذة المفتوحة يختبئ تحت اللّحاف وهو يرتجف كمن أصابته حمّى. ثمّ إنّه طفلٌ بليدٌ لا يُطيع والديه حين يطلبان منه التكنيس.
أما أنا فكنتُ أكنس بكلّ فرحٍ الرمل والتراب على الأرض، طائراً على مكنستي كالساحرة من زاويةٍ إلى أُخرى، مستنشقاً الهواء المثقل بروائح موسم التزاوج والأسمدة، وباحثاً عن حُبيبات الرمل والتراب كأنّها نثار ذهبٍ أو معدنٍ لم يُكتشف بعد.
كنتُ أُخبّئها في علبةٍ كبيرةٍ (أنقذتها من القمامة قبل أن تُلقيها أُمّي)، لأُوزّعها حين أنتهي على أحواض الشجيرات، فأشعر - في سذاجتي الطفوليّة - بأنني أُوفّر مالاً على والدي، فقد سمعته يتّحدث ذات مرّةٍ عن سعر التراب الذي تغزوه الحبال السُّريّة لنباتاتنا الآن في خيالي.
كما أنّ هذا الطفل المدلل لا يُجيد القفز في البركة أبداً، إنّه يقف على الحافّة متردداً، يُنزل ساقيه بالماء، ثمّ يدفع بقيّة جسده، موحياً لنفسه أنّه قافزٌ ماهرٌ مثلي. فأنا كنتُ أُجيد جميع أنواع القفز، خصوصًا قفزة الرأس في الماء شتاءً، الذي يجعل أعضائي الداخليّة تتجمع حول نارٍ توقدها صدمة البرودة.
كنت أقفز من كلّ مكانٍ حول المسبح، حتى خطر لي ذات يومٍ وأنا أسبح على ظهري مع موجات الطيور المهاجرة في السماء، أن أقفز من شرفة أُمّي المطلّة مباشرةً على البركة. وحين حاولت ذلك أمسكتني أُمّي وأنا أهمّ بالقفز، أخذت تصرخ بي باكيةً وهي تضربني لأوّل مرةٍ وتحضنني في الوقت ذاته. أوصدتْ الباب بالمفتاح ثمّ خبّأته.
وقالت لي حين سألتها عنه إنّها أخذته إلى حدّادٍ حطّمه أمامها. لكنني لم أصدقها على غير عادتي، مدفوعاً بالشعور الذي سرى بداخلي حين وقفت على الحافّة مطلًّا على الماء الأزرق في الأسفل. لذلك أخذت أبحث عنه كلّ يومٍ دون أن تنتبه أُمّي، حتّى وجدته في النهاية في مجلدٍ كبيرٍ في مكتبتها.
اخترت بعد ذلك الوقت المناسب للقفز، وقت راحة أُمّي المعتادة واستلقائها على الكنبة أمام التلفاز، حيث تسهو عيناها معظم الأحيان. فتحت باب الشرفة بهدوءٍ، أوصدته ورائي كي أقفز والمفتاح بيدي، ثمّ وقفتُ على الحافة. نظرت إلى كلّ شيءٍ حولي، إلى العصافير السوداء وقمّة الجبل وحقل الأزهار القريب وكتلة الحشرات الطائرة والغيوم في السماء.
لم أنظر إلى الجبل أو العصافير كلٍّ على حدة، نظرت إلى كلّ شيءٍ في الوقت ذاته كأنّ الأشياء - وأنا معها - غدت شيئاً واحداً. ثمّ نظرت إلى الأسفل فتحوّل كلّ شيءٍ شاهدته إلى زرقةٍ فاتنةٍ.
فأحنيتُ قامتي ملامساً أصابع قدميّ، متقمّصاً قوساً يشدّ وترَه إحساسُه الجديد بوجوده، وفاتحاً مساماتي لحرارةٍ تصعد من الأرض وتتكدّس داخلي. حينها أطلقت جسدي مادّاً ذراعيّ إلى الأمام، ارتفعت إلى أعلى قليلاً ثمّ تلقفتني الجاذبيّة الهائلة تحتي.
كانت البركة تكبر كلّما اقتربتْ شوقاً للقائي، بينما يتذوق جلدي طبقات الهواء العديدة، وتعبر العصافير السوداء العطشى الحيّز بين ذراعيّ. وصلتُ بعد قطراتٍ في ساعة الماء السطحَ المرتعش، فتحته بالمفتاح في يدي، أشبهتُ بعدها شخصاً يُدرك في لحظةٍ خاطفةٍ أنّه معلّقٌ في العتبة. تبع نصفي الذي يحتوي ساقيّ في لمح البصر نصفيَ الآخر في البلل.
قضيت بعض الوقت في الهواء المائيّ بين السّطح والقاع، ثمّ لامست بأنامل يدٍ واحدةٍ الحيوانين النائمين في لوحتهما الفسيفسائيّة، فأفلتّ المفتاح لألمسهما بكلّ أصابعي... فاستيقظا كي يرافقا جسدي في الصعود نحو السطح حيث يرتشف لسان الشمس الماء.
ما إن يسرح المرء قليلاً حتى تحدث أشياءٌ عجيبةٌ في هذا البيت، فها هي الساحة مكتظّةٌ بأُناسٍ ليسوا من عائلتنا. إنّها حفلة الترحيب الذي سمعتهم بالأمس يتحدثون عنها، والتي أزالوا لأجلها - كما لاحظت الآن - القنديلين التوأمين أمام الباب. هناك أطفالٌ ينزلون إلى البركة، كيف يستطيعون السباحة في ماءٍ عكرٍ لا يزال أخضر حتى بعد أن أزالوا قطع الطحالب الشبيهة بجزرٍ متوهجةٍ على سطحه؟
الأكبر سناً بينهم يرتدي نظارة غوصٍ وينزل رأسياً في الماء العميق. والأطفال الآخرون يقفزون من جوانب البركة في الماء الضحل واقفين على أقدامهم. ألمح الغوّاص يحمل شيئاً بيده ويلوّح به نحو الكبار الجالسين على كراسي القش.
أستطيع تمييزه بعد أن خفّت حركة يده، إنّه يحمل مفتاح شرفة أُمّي. أحدهم يصرخ موجّهاً نظر الجميع نحوه، إنّه طفلٌ صغيرٌ يسحبونه من الماء. تنزف قدمه دماً غزيراً لا يتوقف، لكنّ رأسي يؤلمني بشدّةٍ دون أن أعرف لماذا، تتدفّق الآن أشياء لا أستطيع كبحها:
طعم موادٍ كيميائيّةٍ ماءٌ بلونٍ آخر صراخٌ دموعٌ أضواءٌ حمراء اهتزاز القنديل بفعل ريحٍ بغير موسمها...
ثمّ بعد ذلك لا يتركون مصباحاً واحداً مضاءً في الخارج.
* كاتب من فلسطين