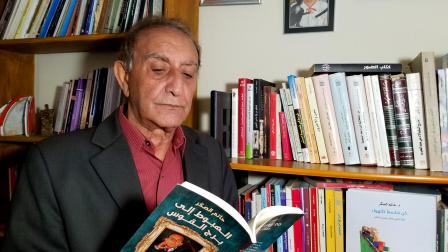"النص" و"التلقي": اقتراباً واغتراباً
(القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2015)
في البدء كان "النص" جبلاً مُشعّاً من نارٍ ونور.. وفي البدء أيضاً كان "المتلقي" يهرول نحوه، كي يأتيَ منه بقبسٍ، أو يجد على النار هدى! كان "بول فاليري" يقول: "إن المعنى الحقيقي للعمل الأدبي، يبدأ في التكون في نفس القارئ بعد انقطاع الحبل السري بين العمل ومؤلفه".
والواقع التاريخي يقرر أنّ مصطلحي "النص" و"التلقي" يغطيان كثيراً من الحقول المعرفية، فالمصطلح الأول تنضوي تحته كل أشكال التعبير اللفظي القابلة للتأويل وفق الأعراف اللغوية والاجتماعية، بينما يعني المصطلح الثاني كل ألوان "الاستجابة" العملية أو الذهنية أو الشعورية في مواجهة النص المطروح وما يترتب على هذه المواجهة من تداعيات.
انطلاقاً من هذه البديهة المعبرة عن آلية التواصل الإنساني عموماً، والأدبي خاصةً؛ يقرر الناقد المبدع أحمد درويش أن عيوبنا تفاقمت، حين فصلنا النص الإبداعي عن المتلقي، وجعلنا نظريات التلقي غير مرتبطة بالنص، فأصبحا مثل ترسين كل واحد منهما يدور في فلكه، ولكنهما لا يدوران معاً في آلة الإبداع بالشكل الحقيقي.
هنا وفي "النص والتلقي: حوار مع نقد الحداثة"، يلفت درويش إلى ظاهرة خطيرة يعاني منها الإبداع حالياً، تعود إلى ترهل الصلة بين طرفي الدائرة الإبداعية الأساسيين (النص) و(التلقي)، وهو ما أنتج ما يمكن تسميته بـ"الطنطنة الإبداعية". وهي تنشأ حين نرى النص يسعى إلى التحرر شيئاً فشيئاً من القوانين والضوابط باعتبارها موانع وقيوداً. وحينها تتحول النصوص إلى كائنات أحادية، وأصوات مفردة غالباً ما يصيبها التشويش المتبادل، ونادراً ما ينتج عنها نغمٌ متناسق.
العلاقة بين طرفي الدائرة الإبداعية إذن هي الشغل الشاغل للمؤلف الذي يدعو إلى إحكام الصلة بينهما، وتخفيف مناخ نشوة الانطلاق وكراهية القيود لدى المبدع لصالح القوانين الفنية والعلمية التي تسمح بتلقيه ومناقشته والتفاعل معه؛ لأن ذلك هو السبيل الوحيد لزحزحة الشعور بعدم جدوى الأدب وقلة محصول القارئ منه، والإحساس بأنه مجرد "طنطنة" يمكن أن يقدم عليها كل من رزق زلاقة اللسان وسيولة القلم.
إشكالية النقد الوافد
ترجع ظاهرة القطيعة بين طرفي الإبداع وأهم مظاهرها "الطنطة" إلى اضطراب موجات الإفادة من النقد الغربي الحديث منذ أوائل القرن التاسع عشر، وكان الرواد الأوائل الذين نقلوا إلينا الخبرات النقدية الغربية عبر كتاباتهم؛ على قدر كبير من الوعي، والقدرة على الموائمة واقتراح ما يناسب أدبنا العربي ويلتحم مع الأطر الثقافية والمعرفية الأخرى المحيطة بذلك الأدب، والتي نبعت من مثيلاتها في الثقافة الغربية، ورصد الأفكار التي تفاعل معها الأدب أخذاً وعطاءً. برز ذلك الاتجاه على يد رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وروحي الخالدي ويعقوب صروف وسليمان البستاني وأحمد ضيف وطه حسين والعقاد ومندور وغنيمي هلال، وغيرهم.
لكن درويش يكشف عن أنه لم يكن كل الذين أتيح لهم التواصل مع الثقافة الغربية الأدبية والنقدية على هذا القدر من الوعي والانتقاء والتمكن من الأدب العربي ذاته الذي يراد له التطوير من خلال تواصله مع تلك الثقافات، ومن هنا غلبت فكرة الانبهار بالجانب الغربي، ومحاولة ليِّ أعناق نصوص الجانب الآخر، مؤكداً أن كثيراً من تلك المحاولات القلقة كانت تشبه محاولات "زرع الأعضاء" التي لا يتم الإعداد الجيد لها.
أغفل هذا التيار المتأخر العلاقة بين نشأة أي منهج غربي والثقافة التي نشأت فيه، وتطور الجوانب الفلسفية والعلمية والمعرفية في تلك الثقافة. وقام المؤلف بإطلالة سريعة على بعض الظروف التي فرضت نشأة بعض المناهج النقدية الغربية، منذ القرن التاسع عشر وتأثر بعض النقاد بالداروينية أو الفلسفة الوضعية لكانت، وظهور نظرية الانعكاس، وتركيزها على مرحلة "ما قبل النص"، ثم تعرض لمرحلة التركيز على النص ودور الفكر الماركسي في تلك المرحلة، مروراً بالنزعة الوصفية التي تزعمها "دي سوسيير"، والعلاقة بين السياسة من جهة والنزعة الشكلانية لدى النقاد الروس من جهة أخرى، وغير ذلك.
والخلاصة أنه ليس كل ما يكتب في مناهج النقد الأدبي الغربية وتطبيقاتها صالحاً لأن ينقل ويترجم ويطبق على الأدب العربي بالضرورة، فالذين يترجمون الدراسات النقدية عن الآداب الأخرى، بالرغم من أهمية جهودهم؛ يترجمون أحياناً ما هو مفيد، وأحياناً أخرى ما هو غير مفيد، وتختلط في ترجماتهم الجمل العادية بالمصطلحات التي قد يتم تحميلها أكثر مما تعبر عنه في الحقيقة.
على سبيل المثال، شاعت عبارة "موت المؤلف" المنسوبة إلى رولان بارت (1915-1981)، وقد أغفل ما فيها من المجاز، وأسيء فهمها أحياناً، ولم يكن المقصود بها أبداً عملية إبعاد المؤلف في إنتاج النص، فهذا الهدف كانت قد تكلفت به المدارس الشكلية التي تنكفئ على النص وحده منذ دراسات دي سوسير حتى تفكيكية دريدا الذي أعلن أنه "لا شيء خارج النص"، فلم تكن هذه القضية من شواغل بارت، لكنه كان يريد بعبارته ما يمكن أن نعبر عنه بالعربية بـ "سلطة احتكار المؤلف لتفسير النص"، وهو تفسير يتسق مع تركيزه على عنصر ثالث في مثلث الإبداع كان مهملاً وهو عنصر (القارئ/الناقد)!
هذا العنصر الثالث لا يجعل المتلقي -الآن ونحن في عصر "النص المكتوب"- مجرد عنصر استهلاك للنص الأدبي كما كان سابقاً في عصر "النص المقروء"، وهو ما يعيدنا إلى مقولة فولفجانج أيزر: "إن مهمة الناقد ليست شرح النص من حيث هو موضوع، بل شرح الآثار التي يخلفها النص في القارئ"!
سؤالات الجدوى
صار التعامل مع مناهج النقد الوافدة، الشكلية منها خاصة، عملاً روتينياً يقوم به الباحثون والنقاد في الجامعات باعتبارها "وصفات جاهزة" لملء الصفحات وتزيينها بأسماء كبار النقاد دون أن يمثل العمل إضافة لغوية أو أدبية أو نقدية. يحكي الدكتور درويش عن ذلك موقفاً مع أحد الباحثين، وقد أعد رسالة حول تحليل روايات روائي عربي شهير، وقد امتلأت الصفحات بالأسس العامة لمناهج الغربيين [الوصفات الجاهزة]، وزينت ببعض الجداول والرسوم، وطبعت طباعة فاخرة أنيقة. يقول: "ورجوت الطالب أن يجيبني عن سؤال عام دون الدخول في التفصيلات عن الفائدة التي يعتقد أنها ستتحقق من خلال عمله، وهل ستصب في مصلحة المؤلف أو النص أو القارئ أو الباحث نفسه؟". وبالطبع لم تكن ثمة إجابة!
ليست هذه حالة مفردة بل هي حالة عامة في الجامعات المصرية، أما حلها فهو في قول درويش: "لو أنّ كلّ باحثٍ بدأ أولاً من نصٍ اهتز له ووجد فيه شيئاً يثير (إشكالية) للبحث، فيقدم نحوه بالمنهج الملائم لا بالمنهج المفروض سابقاً، لاستطعنا جميعاً أن نخرج من الطريق المغلق والنص المغلق".
أما عن النقاد - وهم القارئ الخاص- الذين يسهبون في شرح ثقافاتهم النقدية واستعراضها على حساب وظيفتهم في تقريب النص للقارئ العام، فإن الواحد منهم أشبه بطبيب يقف على رأس مريض في حاجة لأن يصف له تشخيصاً وعلاجاً لحالته، فإذا به يقرأ عليه ما تعلمه في كتب الطب، ويسرد له أسماء أصحاب النظريات المختلفة، وقوائم الأدوية التي يقترحها الصيادلة، وقد ينسى في النهاية أن يحدثه عن حالته الخاصة تشخيصاً ودواءً! ومن هنا كان كتاب الدكتور أحمد درويش نقداً تطبيقياً طوف فيه بين الترجمة والشعر العربي والسرد وبعض القضايا البلاغية الأخرى. باعتبارها منطلقاً طبيعياً للحوار حول الإبداع والنقد معاً.
الخيانة الجميلة
لا يعاني مترجم الحقائق الإخبارية أو المعادلات الحسابية مثلما يعاني مترجم النص الأدبي، لأن النص الأدبي يحمل مجموعة من العلاقات فوق اللفظية، ذات أبعاد معرفية واجتماعية وتاريخية. ولذا كثر الحديث عن صعوبة وفاء الترجمة بالمعنى الأصلي، وشيوع الخيانة الجميلة التي قد تكون ضرورية مع النص الأدبي.
لقد كان الأعشى ينشد شعره في بلاط كسرى لبعض أصدقائه الذين يفهمون العربية، ويقول:
أرقتُ: وما هذا السهاد المؤرق؟
وما بي من سقمٍ، وما بي معشقُ
فسأل كسرى عن معنى كلامه، فقال له المترجم: "إنه أصابه الأرق، مع أنه ليس مريضاً ولا عاشقاً". فقال كسرى: "إذن فهو لص"!
وتشير هذه الحكاية إلى أن ثمة مجموعة من العوامل الفنية مثل دلالات التركيب والسياقات تساعد في تشكيل المعنى الذي لن يوفيه مجرد نقل الألفاظ بطريقة معجمية.
لكن درويش مع ذلك يحذر من أن القضية لابد أن تؤخذ بكثير من التحوط، لئلا تنقلب إلى فوضى على يد صغار المترجمين الذين لا يستطيعون الالتزام بدقة العمل، فيفرون منه إلى ادعاء "الخيانة الجميلة"!
ويعدد الكتاب نماذج للترجمة التي تمثل هذه الخيانة المحببة بترجمات كليلة ودمنة من الهندية إلى العربية إلى الأوربية، وترجمات أنطوان جالون "ألف ليلة وليلة" إلى الفرنسية، وانتقال رباعيات الخيام إلى الانجليزية عبر ترجمة فيتزجرالد، وتعريبات المنفلوطي لروايات من الأدب الفرنسي، وترجمات خليل مطران لشكسبير، وكيف أنه هو الذي أطلق اسم "عطيل" على مسرحية "أوتلو". حين تصور شكسبير يحاكي نطقاً عربياً لاسم عبد مغربي ربما كان اسمه "عطا الله" أو "عطيل".
وقد أتم المؤلف فكرته بتطبيقه لترجمة ثلاث قصائد من الفرنسية للشاعر "جاك بريفير" وأضاف إليها عنصراً موسيقياً ملائماً، ووضع النص الأصلي أمام الترجمة لفتح باب للحوار والمناقشة حول مدى دقة الترجمة ومناسبتها للذائقة العربية في صورتها الجديدة.
معالجات تطبيقية
ينطلق الكتاب أيضاً ليقدم العديد من المعالجات النقدية التطبيقية بدءاً بعلاقة الدين بالشعر، مع سرد تاريخي وتحليلي لهذه العلاقة في نقدنا العربي القديم، ثم يقدم مجموعة من الفصول المتعلقة بنقد الشعر والنثر قديماً وحديثاً؛ كأن يناقش العلاقة بين الفنون التشكيلية (الرسم والعمارة) وفن الشعر من خلال "سينية" البحتري. ويفرد عدداً من الفصول لأحمد شوقي، فمن طموحه لأن يكون روائياً، إلى النظر في نثره، ثم إلى البعد الدرامي في فنه الذي تجسد كأعلى ما يكون في مسرحياته.
وكما أفرد فصولاً عن المسرح الشعري لشوقي وباكثير، ثم عما أسماه "الإبيجراما الشعرية العربية"، وعن تجارب لفاروق شوشة ومانع سعيد العتيبة، يفرد للسرد فصولاً عديدة يعود فيه لنجيب محفوظ والطيب صالح وأمير تاج السر.
كما لا ينسى علاقة الصحافة بالنقد ممثلاً في رجاء النقاش، أو بالإبداع ممثلاً في الكاتب الظريف محمود السعدني. منتهياً إلى قضية التفاعل الأدبي والنقدي بمواقع التواصل الإلكتروني!
(كاتب مصري)
والواقع التاريخي يقرر أنّ مصطلحي "النص" و"التلقي" يغطيان كثيراً من الحقول المعرفية، فالمصطلح الأول تنضوي تحته كل أشكال التعبير اللفظي القابلة للتأويل وفق الأعراف اللغوية والاجتماعية، بينما يعني المصطلح الثاني كل ألوان "الاستجابة" العملية أو الذهنية أو الشعورية في مواجهة النص المطروح وما يترتب على هذه المواجهة من تداعيات.
انطلاقاً من هذه البديهة المعبرة عن آلية التواصل الإنساني عموماً، والأدبي خاصةً؛ يقرر الناقد المبدع أحمد درويش أن عيوبنا تفاقمت، حين فصلنا النص الإبداعي عن المتلقي، وجعلنا نظريات التلقي غير مرتبطة بالنص، فأصبحا مثل ترسين كل واحد منهما يدور في فلكه، ولكنهما لا يدوران معاً في آلة الإبداع بالشكل الحقيقي.
هنا وفي "النص والتلقي: حوار مع نقد الحداثة"، يلفت درويش إلى ظاهرة خطيرة يعاني منها الإبداع حالياً، تعود إلى ترهل الصلة بين طرفي الدائرة الإبداعية الأساسيين (النص) و(التلقي)، وهو ما أنتج ما يمكن تسميته بـ"الطنطنة الإبداعية". وهي تنشأ حين نرى النص يسعى إلى التحرر شيئاً فشيئاً من القوانين والضوابط باعتبارها موانع وقيوداً. وحينها تتحول النصوص إلى كائنات أحادية، وأصوات مفردة غالباً ما يصيبها التشويش المتبادل، ونادراً ما ينتج عنها نغمٌ متناسق.
العلاقة بين طرفي الدائرة الإبداعية إذن هي الشغل الشاغل للمؤلف الذي يدعو إلى إحكام الصلة بينهما، وتخفيف مناخ نشوة الانطلاق وكراهية القيود لدى المبدع لصالح القوانين الفنية والعلمية التي تسمح بتلقيه ومناقشته والتفاعل معه؛ لأن ذلك هو السبيل الوحيد لزحزحة الشعور بعدم جدوى الأدب وقلة محصول القارئ منه، والإحساس بأنه مجرد "طنطنة" يمكن أن يقدم عليها كل من رزق زلاقة اللسان وسيولة القلم.
إشكالية النقد الوافد
ترجع ظاهرة القطيعة بين طرفي الإبداع وأهم مظاهرها "الطنطة" إلى اضطراب موجات الإفادة من النقد الغربي الحديث منذ أوائل القرن التاسع عشر، وكان الرواد الأوائل الذين نقلوا إلينا الخبرات النقدية الغربية عبر كتاباتهم؛ على قدر كبير من الوعي، والقدرة على الموائمة واقتراح ما يناسب أدبنا العربي ويلتحم مع الأطر الثقافية والمعرفية الأخرى المحيطة بذلك الأدب، والتي نبعت من مثيلاتها في الثقافة الغربية، ورصد الأفكار التي تفاعل معها الأدب أخذاً وعطاءً. برز ذلك الاتجاه على يد رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك وروحي الخالدي ويعقوب صروف وسليمان البستاني وأحمد ضيف وطه حسين والعقاد ومندور وغنيمي هلال، وغيرهم.
لكن درويش يكشف عن أنه لم يكن كل الذين أتيح لهم التواصل مع الثقافة الغربية الأدبية والنقدية على هذا القدر من الوعي والانتقاء والتمكن من الأدب العربي ذاته الذي يراد له التطوير من خلال تواصله مع تلك الثقافات، ومن هنا غلبت فكرة الانبهار بالجانب الغربي، ومحاولة ليِّ أعناق نصوص الجانب الآخر، مؤكداً أن كثيراً من تلك المحاولات القلقة كانت تشبه محاولات "زرع الأعضاء" التي لا يتم الإعداد الجيد لها.
أغفل هذا التيار المتأخر العلاقة بين نشأة أي منهج غربي والثقافة التي نشأت فيه، وتطور الجوانب الفلسفية والعلمية والمعرفية في تلك الثقافة. وقام المؤلف بإطلالة سريعة على بعض الظروف التي فرضت نشأة بعض المناهج النقدية الغربية، منذ القرن التاسع عشر وتأثر بعض النقاد بالداروينية أو الفلسفة الوضعية لكانت، وظهور نظرية الانعكاس، وتركيزها على مرحلة "ما قبل النص"، ثم تعرض لمرحلة التركيز على النص ودور الفكر الماركسي في تلك المرحلة، مروراً بالنزعة الوصفية التي تزعمها "دي سوسيير"، والعلاقة بين السياسة من جهة والنزعة الشكلانية لدى النقاد الروس من جهة أخرى، وغير ذلك.
والخلاصة أنه ليس كل ما يكتب في مناهج النقد الأدبي الغربية وتطبيقاتها صالحاً لأن ينقل ويترجم ويطبق على الأدب العربي بالضرورة، فالذين يترجمون الدراسات النقدية عن الآداب الأخرى، بالرغم من أهمية جهودهم؛ يترجمون أحياناً ما هو مفيد، وأحياناً أخرى ما هو غير مفيد، وتختلط في ترجماتهم الجمل العادية بالمصطلحات التي قد يتم تحميلها أكثر مما تعبر عنه في الحقيقة.
على سبيل المثال، شاعت عبارة "موت المؤلف" المنسوبة إلى رولان بارت (1915-1981)، وقد أغفل ما فيها من المجاز، وأسيء فهمها أحياناً، ولم يكن المقصود بها أبداً عملية إبعاد المؤلف في إنتاج النص، فهذا الهدف كانت قد تكلفت به المدارس الشكلية التي تنكفئ على النص وحده منذ دراسات دي سوسير حتى تفكيكية دريدا الذي أعلن أنه "لا شيء خارج النص"، فلم تكن هذه القضية من شواغل بارت، لكنه كان يريد بعبارته ما يمكن أن نعبر عنه بالعربية بـ "سلطة احتكار المؤلف لتفسير النص"، وهو تفسير يتسق مع تركيزه على عنصر ثالث في مثلث الإبداع كان مهملاً وهو عنصر (القارئ/الناقد)!
هذا العنصر الثالث لا يجعل المتلقي -الآن ونحن في عصر "النص المكتوب"- مجرد عنصر استهلاك للنص الأدبي كما كان سابقاً في عصر "النص المقروء"، وهو ما يعيدنا إلى مقولة فولفجانج أيزر: "إن مهمة الناقد ليست شرح النص من حيث هو موضوع، بل شرح الآثار التي يخلفها النص في القارئ"!
سؤالات الجدوى
صار التعامل مع مناهج النقد الوافدة، الشكلية منها خاصة، عملاً روتينياً يقوم به الباحثون والنقاد في الجامعات باعتبارها "وصفات جاهزة" لملء الصفحات وتزيينها بأسماء كبار النقاد دون أن يمثل العمل إضافة لغوية أو أدبية أو نقدية. يحكي الدكتور درويش عن ذلك موقفاً مع أحد الباحثين، وقد أعد رسالة حول تحليل روايات روائي عربي شهير، وقد امتلأت الصفحات بالأسس العامة لمناهج الغربيين [الوصفات الجاهزة]، وزينت ببعض الجداول والرسوم، وطبعت طباعة فاخرة أنيقة. يقول: "ورجوت الطالب أن يجيبني عن سؤال عام دون الدخول في التفصيلات عن الفائدة التي يعتقد أنها ستتحقق من خلال عمله، وهل ستصب في مصلحة المؤلف أو النص أو القارئ أو الباحث نفسه؟". وبالطبع لم تكن ثمة إجابة!
ليست هذه حالة مفردة بل هي حالة عامة في الجامعات المصرية، أما حلها فهو في قول درويش: "لو أنّ كلّ باحثٍ بدأ أولاً من نصٍ اهتز له ووجد فيه شيئاً يثير (إشكالية) للبحث، فيقدم نحوه بالمنهج الملائم لا بالمنهج المفروض سابقاً، لاستطعنا جميعاً أن نخرج من الطريق المغلق والنص المغلق".
أما عن النقاد - وهم القارئ الخاص- الذين يسهبون في شرح ثقافاتهم النقدية واستعراضها على حساب وظيفتهم في تقريب النص للقارئ العام، فإن الواحد منهم أشبه بطبيب يقف على رأس مريض في حاجة لأن يصف له تشخيصاً وعلاجاً لحالته، فإذا به يقرأ عليه ما تعلمه في كتب الطب، ويسرد له أسماء أصحاب النظريات المختلفة، وقوائم الأدوية التي يقترحها الصيادلة، وقد ينسى في النهاية أن يحدثه عن حالته الخاصة تشخيصاً ودواءً! ومن هنا كان كتاب الدكتور أحمد درويش نقداً تطبيقياً طوف فيه بين الترجمة والشعر العربي والسرد وبعض القضايا البلاغية الأخرى. باعتبارها منطلقاً طبيعياً للحوار حول الإبداع والنقد معاً.
الخيانة الجميلة
لا يعاني مترجم الحقائق الإخبارية أو المعادلات الحسابية مثلما يعاني مترجم النص الأدبي، لأن النص الأدبي يحمل مجموعة من العلاقات فوق اللفظية، ذات أبعاد معرفية واجتماعية وتاريخية. ولذا كثر الحديث عن صعوبة وفاء الترجمة بالمعنى الأصلي، وشيوع الخيانة الجميلة التي قد تكون ضرورية مع النص الأدبي.
لقد كان الأعشى ينشد شعره في بلاط كسرى لبعض أصدقائه الذين يفهمون العربية، ويقول:
أرقتُ: وما هذا السهاد المؤرق؟
وما بي من سقمٍ، وما بي معشقُ
فسأل كسرى عن معنى كلامه، فقال له المترجم: "إنه أصابه الأرق، مع أنه ليس مريضاً ولا عاشقاً". فقال كسرى: "إذن فهو لص"!
وتشير هذه الحكاية إلى أن ثمة مجموعة من العوامل الفنية مثل دلالات التركيب والسياقات تساعد في تشكيل المعنى الذي لن يوفيه مجرد نقل الألفاظ بطريقة معجمية.
لكن درويش مع ذلك يحذر من أن القضية لابد أن تؤخذ بكثير من التحوط، لئلا تنقلب إلى فوضى على يد صغار المترجمين الذين لا يستطيعون الالتزام بدقة العمل، فيفرون منه إلى ادعاء "الخيانة الجميلة"!
ويعدد الكتاب نماذج للترجمة التي تمثل هذه الخيانة المحببة بترجمات كليلة ودمنة من الهندية إلى العربية إلى الأوربية، وترجمات أنطوان جالون "ألف ليلة وليلة" إلى الفرنسية، وانتقال رباعيات الخيام إلى الانجليزية عبر ترجمة فيتزجرالد، وتعريبات المنفلوطي لروايات من الأدب الفرنسي، وترجمات خليل مطران لشكسبير، وكيف أنه هو الذي أطلق اسم "عطيل" على مسرحية "أوتلو". حين تصور شكسبير يحاكي نطقاً عربياً لاسم عبد مغربي ربما كان اسمه "عطا الله" أو "عطيل".
وقد أتم المؤلف فكرته بتطبيقه لترجمة ثلاث قصائد من الفرنسية للشاعر "جاك بريفير" وأضاف إليها عنصراً موسيقياً ملائماً، ووضع النص الأصلي أمام الترجمة لفتح باب للحوار والمناقشة حول مدى دقة الترجمة ومناسبتها للذائقة العربية في صورتها الجديدة.
معالجات تطبيقية
ينطلق الكتاب أيضاً ليقدم العديد من المعالجات النقدية التطبيقية بدءاً بعلاقة الدين بالشعر، مع سرد تاريخي وتحليلي لهذه العلاقة في نقدنا العربي القديم، ثم يقدم مجموعة من الفصول المتعلقة بنقد الشعر والنثر قديماً وحديثاً؛ كأن يناقش العلاقة بين الفنون التشكيلية (الرسم والعمارة) وفن الشعر من خلال "سينية" البحتري. ويفرد عدداً من الفصول لأحمد شوقي، فمن طموحه لأن يكون روائياً، إلى النظر في نثره، ثم إلى البعد الدرامي في فنه الذي تجسد كأعلى ما يكون في مسرحياته.
وكما أفرد فصولاً عن المسرح الشعري لشوقي وباكثير، ثم عما أسماه "الإبيجراما الشعرية العربية"، وعن تجارب لفاروق شوشة ومانع سعيد العتيبة، يفرد للسرد فصولاً عديدة يعود فيه لنجيب محفوظ والطيب صالح وأمير تاج السر.
كما لا ينسى علاقة الصحافة بالنقد ممثلاً في رجاء النقاش، أو بالإبداع ممثلاً في الكاتب الظريف محمود السعدني. منتهياً إلى قضية التفاعل الأدبي والنقدي بمواقع التواصل الإلكتروني!
(كاتب مصري)