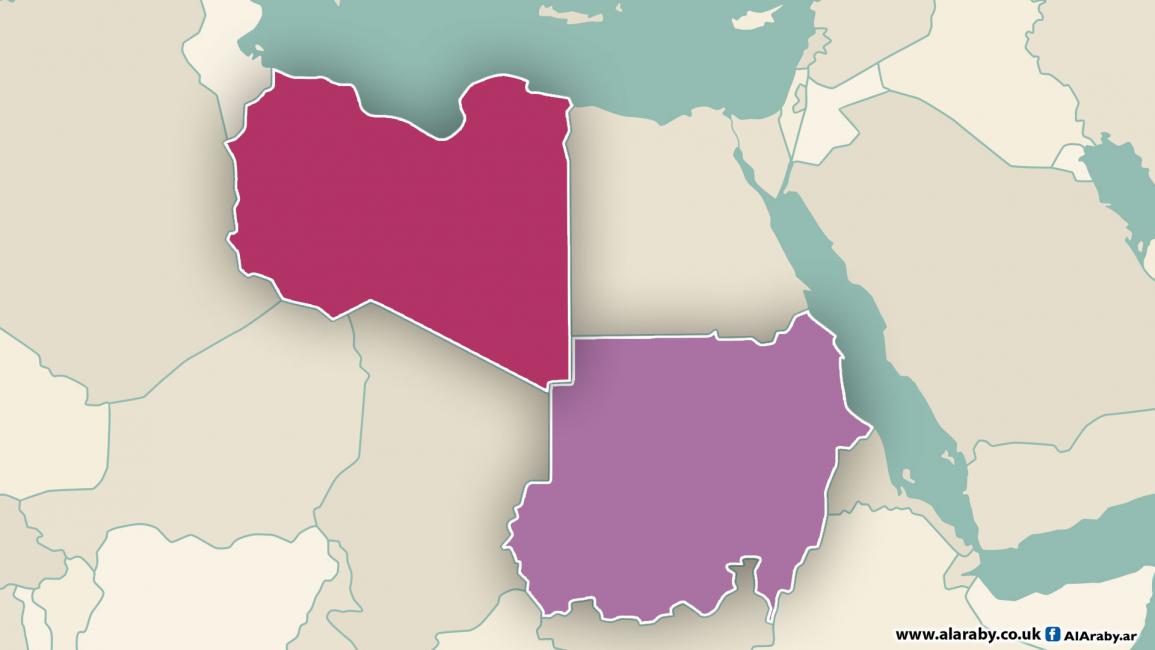27 أكتوبر 2023
هذه التأثيرات متبادلة بين ليبيا والسودان
هذه التأثيرات متبادلة بين ليبيا والسودان

العبيد أحمد مروح
بخلاف ما هو معروف من التداخل الطبيعي بين أي بلدين جارين، لا تفصلهما حواجز طبيعية ولا حدود محروسة، وتعيش على جانبي حدودهما مجموعاتٌ سكانيةٌ متداخلة، فقد ارتبط السودان وليبيا، طوال نصف القرن الماضي، بتأثيرات مباشرة كل في أوضاع البلد الآخر الداخلية. ومن أسف أن أغلب هذه التأثيرات هي مما يصلح وصفه بالعبارة الدبلوماسية "التدخل في الشؤون الداخلية للغير". فبعد نجاح انقلاب العقيد معمر القذافي في الأول من سبتمبر/ أيلول 1969 بقليل، أرسل قادة الانقلاب الذي سبقه بأشهر في السودان (مايو/ أيار 1969) أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة، وهو الراحل مأمون عوض أبو زيد، المصنّف ضمن القوميين العرب، ليساعد النظام الوليد في ليبيا في ترتيب أموره، لجهة إصدار المراسيم التي تنظم عمل الدولة، فمكث هناك عدة أشهر أنجز خلالها مهمته وعاد. وردّاً لهذا "الجميل" اعترض نظام العقيد القذافي طائرة تحمل اثنين من قادة انقلاب الحزب الشيوعي في السودان في يوليو/ تموز 1971، وهي في طريقها إلى السودان، وأنزلهما وسلمهما لاحقاً للرئيس جعفر النميري الذي أعدمهما ضمن محاكمات الانقلابيين.
لم يدم شهر العسل طويلاً في علاقات النظامين، إذ بعد سنوات قليلة تحوّلت الصداقة إلى عداوة، وعلى إثر ذلك وافق نظام القذافي على فتح معسكرات تدريب عسكري في الأراضي الليبية للمعارضة السودانية، ممثلة بتحالف الجبهة الوطنية، وأمدّهم بالسلاح، فكان ما عُرف إعلامياً ب"غزو المرتزقة" في يوليو/ تموز 1976، حيث دخلت قوات المعارضة السودانية القادمة من ليبيا إلى العاصمة الخرطوم، ونجحت في السيطرة العسكرية عليها ثلاثة أيام، لكنها فشلت في تسلّم السلطة وإعلان بيانها السياسي، ما مكّن نظام النميري من إعادة ترتيب صفوفه والقضاء على الحركة التي أطلق عليها وصف "المرتزقة"، وصارت تُعرف به، وجذّرت هذه الخطوة للعداء والكيد المتبادل بين النظامين، فكانت الغارة الجوية الليبية على إذاعة أم درمان في أوائل
الثمانينيات، باعتبارها مركزاً لبثّ إذاعة المعارضة الليبية، وسمحت الخرطوم بتمرير شحنات أسلحة عبرها إلى المعارضة الليبية المسلحة، في إطار ترتيباتها لمعركة باب العزيزية في 1984. إلا أن العداء الصارخ في تلك المعادلة كان عقب عام 1983، حينما أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان عن نفسها، إذ سرعان ما سمح لها نظام منغستو هايلي ماريام في إثيوبيا، الذي كان هو الآخر يعادي النظام في الخرطوم بفتح معسكرات للتدريب العسكري قرب الحدود المشتركة، وتدفقت عليهم الأسلحة من نظام العقيد القذافي الذي كان يربطه "حلف عدن" مع كل من نظام منغستو والنظام في اليمن الجنوبي وقتها، فامتلأت المخازن الإثيوبية ومخازن المتمرّدين السودانيين بشتى أنواع الأسلحة السوفييتية حتى درجة الكفاية. ولذلك، عندما أسقطت ثورة إبريل 1985 نظام النميري، لم تفلح جهود العقيد القذافي في إقناع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق بوضع السلاح والدخول في مفاوضات جادة لتسوية قضية الحرب الأهلية في جنوب السودان، لا مع الحكومة الانتقالية بقيادة سوار الذهب والجزولى دفع الله، ولا مع حكومة الصادق المهدي المنتخبة، فقد كان المعارضون الجنوبيون يعتبرون أن نظام القذافي كان بالنسبة إليهم كالبقرة الحلوب وقد حلبوها، كما قال لنا أحدهم في تلك الفترة.
ويعتقد مراقبون كثيرون أن الفتور الذي شاب العلاقة بين نظام العقيد القذافي والحكم التعددي في السودان بقيادة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة وأحد حلفاء القذافي القدامى في "الجبهة الوطنية"، سببه تمنّع الأخير عن الاستجابة لمطالب القذافي في عدد من القضايا الإقليمية، ولعل هذا الفتور هو ما فتح شهية القذافي في التعامل مع نظام الإنقاذ الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري في يونيو/ حزيران 1989، خصوصاً بعدما أبدى النظام الجديد مرونةً في اعتماد نظام المؤتمرات بديلاً للنظام التعدّدي، حيث زار القذافي الخرطوم أكثر من مرة في مطلع التسعينيات، وخاطب في إحداها جلسات المؤتمر التأسيسي لنظام المؤتمرات. لكن هذه العلاقة أيضاً لم تدم طويلاً، بل تحوّلت إلى حالة حرب باردة، خصوصاً بعدما بدأت تظهر معالم التوجه الإسلامي للنظام الجديد في السودان، واتضح لأجهزة المخابرات الليبية أن معارضي نظام القذافي الإسلاميين فتحوا قنواتٍ للتواصل مع السودان، فأعاد نظام القذافي فتح خطوطه مع الحركة الشعبية، ومع بعض قادة التجمع الوطني السوداني المعارض، وبدأ يقدم لهم بعض أشكال الدعم المادي، لكن وتيرة هذا الدعم تزايدت، وأصبحت شبه مكشوفة، بعدما ظهرت حركات سودانية مسلحة في إقليم دارفور تحارب النظام في الخرطوم، وكان القذافي يُظهر أنه يقوم بدور الوسيط في ذلك النزاع، في الوقت الذي كان يصبّ فيه الزيت على نار الصراع!
لم يقف النظام في الخرطوم مكتوف الأيدي تجاه هذه الخطوات، لكنه، في الوقت نفسه، لم يكن
يرغب في إظهار الخصومة لنظام القذافي، اتقاءً لشرّه. ولهذا عندما بدأت ثورة فبراير في ليبيا، كإحدى ثورات الربيع العربي نسج نظام الخرطوم شبكة علاقات سرّية مع الثوار الليبيين في الشرق وفي الغرب. ومن الثابت أن غالب الأسلحة التي مكّنت ثوار طرابلس من السيطرة على العاصمة، وإسقاط النظام رسمياً رتبت أمرها الخرطوم. ولهذا احتفظت الأخيرة بعلاقات جيدة مع الثورة الليبية في شرق البلاد وغربها، وكانت البعثة الدبلوماسية السودانية في ليبيا من البعثات القليلة جداً التي لم تغادر التراب الليبي، على الرغم من الخطر الذي ظل يتهدد الوجود الدبلوماسي الأجنبي في حينه وبعدها. لكن فاعلية التأثير السوداني بمجريات الأوضاع في ليبيا تراجعت إلى حدٍ كبير، بفعل الضغوط التي ظلت الخرطوم تتعرّض لها من كل من مصر والإمارات اللتين دخلتا على خط الأزمة في ليبيا، محرّضتين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وداعمتين له، عندما أعلن ما سمّاها عملية الكرامة في عام 2014.
وحين قوي ساعد حفتر، وأعلن عزمه على التقدم نحو الغرب الليبي، نشط سماسرة الصراعات من رجاله وداعميه في استقطاب منسوبي الحركات المسلحة في دارفور، ممن لم ينخرطوا في اتفاقات السلام التي استضافتها الدوحة في 2011، والذين فقدوا كثيراً من مناطق تمركزهم بفعل الضغوط العسكرية التي شكلتها عليهم الحكومة السودانية. ونجح سماسرة حفتر في تجنيد عديدين من منسوبي تلك الحركات، بالاتفاق مع قادتها وفق صيغ محدّدة يمكن إجمالها في عبارة "الرجال والقتال مقابل السلاح والمال". وقد كان أحد أبرز الأمثلة على ذلك، المعركة بين قوات مشتركة من الجيش السوداني والدعم السريع ضد قوات من حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي داخل الحدود السودانية، بينما كانت الأخيرة عائدة من ليبيا في مايو/ أيار 2017، محملة بالأسلحة والعتاد، بما في ذلك مدرعات وذخيرة مصرية كانت القاهرة قد دعمت بها خليفة حفتر، الأمر الذي سبّب أزمة دبلوماسية بين الخرطوم والقاهرة حينها.
ومع توالي إعلان النظام في الخرطوم وقف إطلاق النار في دارفور قبيل سقوطه قبل عام، واستمرار ذلك، مع تراجع وتيرة العمل المسلح، وفي الوقت نفسه، تقدم خليفة حفتر نحو الغرب الليبي، وحصاره العاصمة طرابلس، نجحت مجموعات السماسرة في استقطاب مقاتلين من عدد من الحركات الدارفورية لتأمين الإمداد بالرجال، أملاً في حسم المعركة لمصلحة "رجل ليبيا القوي"، كما يحاول أن يصوّره إعلام المحور العربي الذي يدعمه، ويسوّقه للقوى الدولية التي لا تمانع إطاحته السلطة المعترف بها دولياً، لمصلحة سلطةٍ تقوم على منطق القوة العسكرية وإسقاط الاتفاقيات التي أقامتها ورعتها الأمم المتحدة. ولعل مما يستدعي التوقف عنده، أن الغرب الأوروبي والأميركي الذي ظل يتظاهر بدعمه تلك الاتفاقيات الدولية، بقي متمسّكاً بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على ليبيا، التي تقتضي استمرار تجميد الأموال الليبية في المصارف الغربية، فيما تعاني الحكومة المعترف بها دولياً في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها في الغرب الليبي الذي يشكل ثلثي السكان. وفي الوقت نفسه، بقيت دول نافذة في ذلك الغرب، بطرف خفي وعملي، تدعم الجنرال حفتر، إما دعماً مباشراً أو بغضّ الطرف عن مشروعه لإعادة حكم ليبيا إلى ما يشبه حكم القذافي، وعن الشنائع التي يرتكبها في حق المدنيين، إلى أن جاءت الاتفاقيات مع تركيا فقلبت المعادلة، وأضحت المشاركة في الحرب في ليبيا بالغة الثمن، وبدأت المجموعات القتالية التي وصلت إلى ليبيا بإعادة حساباتها، بل شرع بعضها بالعودة إلى السودان بما حمل، وما من شك في أن هذا بحد ذاته ستكون له تبعاته على الوضع الأمني الداخلي في السودان.
ويعتقد مراقبون كثيرون أن الفتور الذي شاب العلاقة بين نظام العقيد القذافي والحكم التعددي في السودان بقيادة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة وأحد حلفاء القذافي القدامى في "الجبهة الوطنية"، سببه تمنّع الأخير عن الاستجابة لمطالب القذافي في عدد من القضايا الإقليمية، ولعل هذا الفتور هو ما فتح شهية القذافي في التعامل مع نظام الإنقاذ الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري في يونيو/ حزيران 1989، خصوصاً بعدما أبدى النظام الجديد مرونةً في اعتماد نظام المؤتمرات بديلاً للنظام التعدّدي، حيث زار القذافي الخرطوم أكثر من مرة في مطلع التسعينيات، وخاطب في إحداها جلسات المؤتمر التأسيسي لنظام المؤتمرات. لكن هذه العلاقة أيضاً لم تدم طويلاً، بل تحوّلت إلى حالة حرب باردة، خصوصاً بعدما بدأت تظهر معالم التوجه الإسلامي للنظام الجديد في السودان، واتضح لأجهزة المخابرات الليبية أن معارضي نظام القذافي الإسلاميين فتحوا قنواتٍ للتواصل مع السودان، فأعاد نظام القذافي فتح خطوطه مع الحركة الشعبية، ومع بعض قادة التجمع الوطني السوداني المعارض، وبدأ يقدم لهم بعض أشكال الدعم المادي، لكن وتيرة هذا الدعم تزايدت، وأصبحت شبه مكشوفة، بعدما ظهرت حركات سودانية مسلحة في إقليم دارفور تحارب النظام في الخرطوم، وكان القذافي يُظهر أنه يقوم بدور الوسيط في ذلك النزاع، في الوقت الذي كان يصبّ فيه الزيت على نار الصراع!
لم يقف النظام في الخرطوم مكتوف الأيدي تجاه هذه الخطوات، لكنه، في الوقت نفسه، لم يكن
وحين قوي ساعد حفتر، وأعلن عزمه على التقدم نحو الغرب الليبي، نشط سماسرة الصراعات من رجاله وداعميه في استقطاب منسوبي الحركات المسلحة في دارفور، ممن لم ينخرطوا في اتفاقات السلام التي استضافتها الدوحة في 2011، والذين فقدوا كثيراً من مناطق تمركزهم بفعل الضغوط العسكرية التي شكلتها عليهم الحكومة السودانية. ونجح سماسرة حفتر في تجنيد عديدين من منسوبي تلك الحركات، بالاتفاق مع قادتها وفق صيغ محدّدة يمكن إجمالها في عبارة "الرجال والقتال مقابل السلاح والمال". وقد كان أحد أبرز الأمثلة على ذلك، المعركة بين قوات مشتركة من الجيش السوداني والدعم السريع ضد قوات من حركة تحرير السودان بقيادة مني مناوي داخل الحدود السودانية، بينما كانت الأخيرة عائدة من ليبيا في مايو/ أيار 2017، محملة بالأسلحة والعتاد، بما في ذلك مدرعات وذخيرة مصرية كانت القاهرة قد دعمت بها خليفة حفتر، الأمر الذي سبّب أزمة دبلوماسية بين الخرطوم والقاهرة حينها.
ومع توالي إعلان النظام في الخرطوم وقف إطلاق النار في دارفور قبيل سقوطه قبل عام، واستمرار ذلك، مع تراجع وتيرة العمل المسلح، وفي الوقت نفسه، تقدم خليفة حفتر نحو الغرب الليبي، وحصاره العاصمة طرابلس، نجحت مجموعات السماسرة في استقطاب مقاتلين من عدد من الحركات الدارفورية لتأمين الإمداد بالرجال، أملاً في حسم المعركة لمصلحة "رجل ليبيا القوي"، كما يحاول أن يصوّره إعلام المحور العربي الذي يدعمه، ويسوّقه للقوى الدولية التي لا تمانع إطاحته السلطة المعترف بها دولياً، لمصلحة سلطةٍ تقوم على منطق القوة العسكرية وإسقاط الاتفاقيات التي أقامتها ورعتها الأمم المتحدة. ولعل مما يستدعي التوقف عنده، أن الغرب الأوروبي والأميركي الذي ظل يتظاهر بدعمه تلك الاتفاقيات الدولية، بقي متمسّكاً بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على ليبيا، التي تقتضي استمرار تجميد الأموال الليبية في المصارف الغربية، فيما تعاني الحكومة المعترف بها دولياً في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها في الغرب الليبي الذي يشكل ثلثي السكان. وفي الوقت نفسه، بقيت دول نافذة في ذلك الغرب، بطرف خفي وعملي، تدعم الجنرال حفتر، إما دعماً مباشراً أو بغضّ الطرف عن مشروعه لإعادة حكم ليبيا إلى ما يشبه حكم القذافي، وعن الشنائع التي يرتكبها في حق المدنيين، إلى أن جاءت الاتفاقيات مع تركيا فقلبت المعادلة، وأضحت المشاركة في الحرب في ليبيا بالغة الثمن، وبدأت المجموعات القتالية التي وصلت إلى ليبيا بإعادة حساباتها، بل شرع بعضها بالعودة إلى السودان بما حمل، وما من شك في أن هذا بحد ذاته ستكون له تبعاته على الوضع الأمني الداخلي في السودان.
مقالات أخرى
03 أكتوبر 2023
21 سبتمبر 2023
12 يوليو 2020