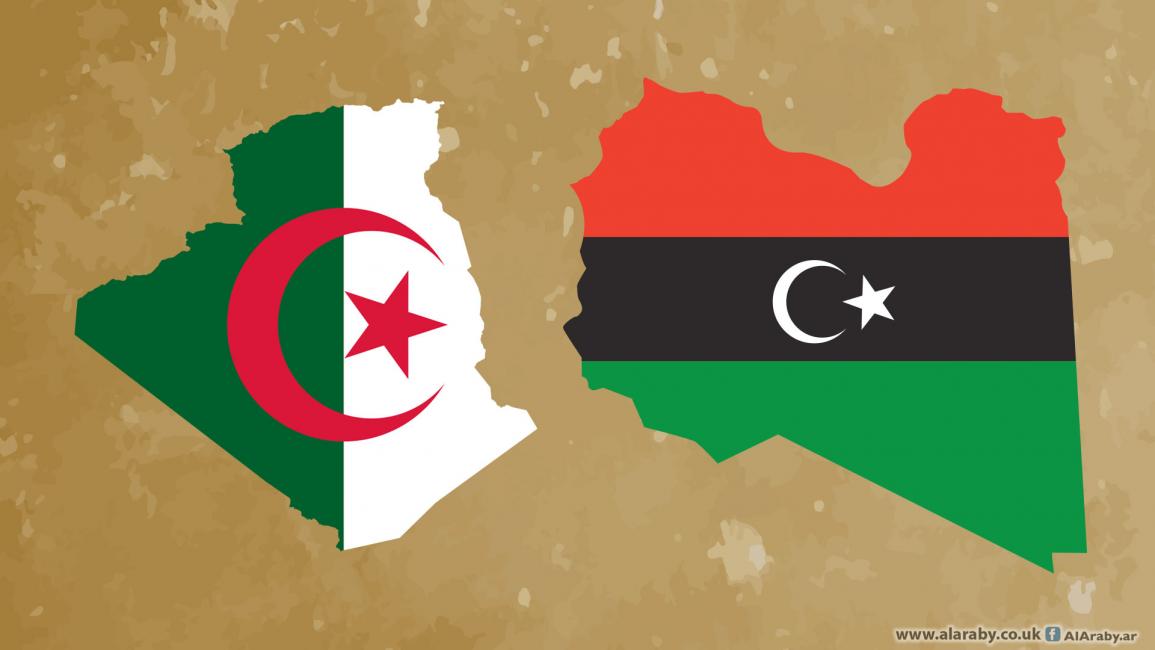18 مارس 2024
ليبيا وتجديد السياسة الجزائرية
ليبيا وتجديد السياسة الجزائرية
جاء انعقاد اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر في 23 يناير/ كانون الثاني الحالي مترابطا مع توجه الجزائر نحو التجديد السياسي، وتزايد النشاط الدولي لوقف الحرب الأهلية الليبية، فبعد وقت قصير من إعلان نتائج انتخابات الرئاسة، نشط الدور الجزائري على المستوى الإقليمي، ليس فقط فيما يتعلق بالنشاط الدبلوماسي عبر المشاركة في مؤتمر برلين وغيره من الأنشطة، ولكن في المسارعة إلى تحديد المخاطر الخارجية وأولوياتها، وهو ما يثير التساؤل عن فرصة هذا البلد في المساهمة في بناء إطار إقليمي متماسك لدعم الحل السياسي في ليبيا، والخروج من حالة الحرب.
القدرات الكامنة والمحتملة
بشكل عام، ترتبط فاعلية السياسة الجزائرية بجانبين، تأسيس السلطة وقدرتها على حماية مصالحها الأمنية والسياسية. وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى انتخابات رئاسة الجزائر، ليس بوصفها انتخابات تقليدية إجرائية، فقد جاءت بعد حراك شعبي، طالب بوضوح عملية انتقال السلطة وترقية شفافيتها ونزاهتها، وهي تغيراتٌ تثير الاهتمام بتوجهات السياسة الخارجية، ويمكن قراءة اجتماع "المجلس الأعلى للأمن القومي" في 27 الشهر الماضي (ديسمبر/ كانون الأول) مؤشّرا على تفعيل دور الجزائر تجاه التهديدات الأمنية على الحدود مع ليبيا ومالي، وتوصل الاجتماع إلى تدابير لتفعيل السياسة الخارجية، وبدء إجراءات الأمن على الحدود مع ليبيا ومالي، وشهد هذا التوجه تطوراً في اجتماع مجلس الوزراء، 5 يناير/ كانون الثاني الحالي، عندما نظر إلى الأوضاع الإقليمية والدولية بوصفها بيئة معقدة تشكل مناخاً ملائماً لمناورات جيوسياسية، تشكل تهديداً للأمن الوطني.
وعلى مستوى آخر، دفع الدخول التركي على الأزمة في ليبيا الدول الأوروبية إلى التوافق على
انعقاد مؤتمر برلين، بعد تأجيله عدّة مرات، حيث شكل عقد مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق ضغطاً على الأطراف المنخرطة في الشؤون الليبية، وقد شكّل هذا التغير عاملاً مؤثراً من ناحيتين؛ تأكيد دخول تركيا منافساً حقيقياً بعد وضوح تقارب المواقف الدولية بشأن الحل العسكري للأزمة الليبية، وظهور فرصة للتنسيق مع الجزائر، لتكوين كتلة إقليمية داعمة للحل السلمي. ولعل هذه الأخيرة تمثل القاسم المشتركة بين دول عديدة ساعية إلى ضمان وقف إطلاق النار، والبدء بالترتيبات الانتقالية السلمية. ومن ثم، كان إصرار تركيا على دعوة الجزائر للمشاركة في مؤتمر برلين ذات دلالة على التقارب مع الجزائر والانخراط في السياسة الليبية.
تغير "جوار ليبيا" وثباته
لافتٌ أن اجتماع الجزائر جاء بعد مؤتمر برلين، ليعكس تغيراً غير مألوف في العلاقات السياسية بين دول الشمال والجنوب، فقد كان النمط السائد متمثلاً في بدء الاجتماعات في بلدان الجنوب كأعمال تحضيرية للمؤتمرات الدولية. وبهذا المعنى، تبدو مبادرة برلين مؤشراً على إعادة ترتيب النظر الدولي بشأن ليبيا. وهنا، يمكن النظر باهتمام إلى نشاط السياسة الألمانية، واتساقه حول دعم الحل السلمي، ولعل مشاركة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في اجتماع الجزائر، أضفت أبعاداً إيجابية على التلاقي مع الدول الإقليمية على دعم المسار السياسي.
وفي هذا السياق، انتقل موقف دول الجوار، بطريقة نوعية، إلى التأكيد على "ضرورة إشراك دول جوار ليبيا في أية مساعٍ دولية لحل الأزمة الليبية.. وآلية المتابعة المنبثقة عن مؤتمر برلين"، وهو ما يعمل على توسيع مساهمة ذوي المصلحة من دول الجوار، حسب التعريف الواسع، ولا يترك أمرها وفقاً لرؤية الدولة الداعية، كما حدث في مؤتمر برلين واجتماعات دولية أخرى، حيث اقتصرت الدعوة على دول من الجوار دون غيرها. وذلك على خلاف
التعريف السابق الذي اقتصر عدة مرات على دول الجوار الشمالية، وهو ما شكّل تجاوزاً لمصالح الجوار الأفريقي. وفي الوقت نفسه، يعطي حلاً ناقصاً لا يلبي شروط الخروج من الأزمة السياسية، فهي لا تقتصر على مسالة الحدود، ولكنها تشمل قضايا أخرى، كالتداخل السكاني، التبّو والطوارق، على جانبي الحدود، ما استدعى مشاركة دولة مالي باعتبارها واحدةً من إقليم الساحل والصحراء، وأيضاً، قضية مشاركة مليشيات السودانيين في الحرب، وهي قضايا لا تقل أهمية عن تسوية أزمة السلطة والشرعية في ليبيا.
ويمثل حضور دول الجوار الموسع علامة مهمة في التعامل مع الأزمة في ليبيا، وخصوصاً في ظل سيولة الحدود وانفلات الهجرة غير الشرعية. وهنا تبدو أهمية إطلاع دول الجوار الأفريقي جنوب الصحراء على مجريات التعامل الدولي على ليبيا، وطرق النقاش حول قضايا الأمن الجماعي، وتوفير الحلول الملائمة لمشكلة الهجرة، فهي لا تقتصر على تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث تمثل دولة عبور، وبالتالي، فإن تحدّي مقاومة الهجرة يكون من خلال إعمال المسؤولية المشتركة في مجالي أمن الحدود والتنمية الاقتصادية.
وعلى أي حال، كانت مخرجات الاجتماع، في جانب كبير منها، متماثلةً مع لغة البيانات
السابقة، من حيث الإشارة إلى دعم المسار السياسي، والتنسيق في مكافحة الإرهاب ودعم البعثة الدولية للقيام بمهامها السلمية. وهنا، بدا اهتمام اجتماع الجزائر بمسألتين؛ ارتبطت الأولى بتأثير الوضع في ليبيا على أمن دول الجوار واستقرارها. ولذلك كان تأكيد البيان على الالتزام بوقف إطلاق النار، ورفض الحلول العسكرية والتدخلات الأجنبية، سواء من الدول أو عبر شركات الأمن الخاصة لجلب المرتزقة، أما الثانية، فكانت في السعي إلى تطوير الحل السلمي، بحيث تؤدي العملية السياسية إلى تنظيم انتخابات شفافة، تضمن وقف الحرب واستقلال ليبيا ووحدتها.
وتشير الملامح المشتركة لمناقشات الاجتماع إلى تأكيد الحل السياسي، وتثبيت الهدنة، ووقف إرسال الأسلحة، ومكافحة الإرهاب ووقف التدخل الدولي، غير أن الموقف المصري كان أكثر تفصيلاً عندما حدّد حزمة من الخطوات للحل السياسي، فمن جهةٍ توسع في تعريف المنظمات الإرهابية القريبة من حكومة الوفاق، والتي تشكل تهديداً للمسار السياسي الليبي المستقل. ومن جهة أخرى، ولتوضيح موقفها، اعتبرت مصر أن الوصول إلى حل سياسي يتطلب اتخاذ خطواتٍ تبدو متزامنةً، لتشمل تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح المليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبي.
مسيرة دول الجوار
وبالنظر إلى مشوار دول الجوار الليبي منذ عام 2014، يمكن ملاحظة تغير مفهوم دول الجوار. فمن جهة عدد المشاركين، بدت الاجتماعات مفتوحةً لمشاركة الدول الحدودية مع ليبيا في اجتماعات الجزائر والقاهرة والخرطوم وتونس، لكنها شهدت انكماشاً في مرحلةٍ لاحقة، لتقتصر على ثلاث دول، مصر وتونس والجزائر. وبالتالي، تراعي العودة إلى الصيغة الأولية مصالح كل الأطراف، وتقلل التوجهات الاحتكارية للملف الليبي. ومن ناحية التوجه السياسي، ظلت البيانات الختامية والاجتماعات غير المنتظمة تؤكد الحل السلمي، ورفض الحلول العسكرية أو العنفية وإدانة الإرهاب، لكنها لم تتمكّن من وقف المعارك أو جمع السلاح.
ويرجع ضعف دول الجوار وعدم قدرتها على وقف الحرب إلى تشتت مواقفها السياسية. وهنا تبرز ثلاثة اتجاهات، فبينما انحازت مصر لمجلس النواب (طبرق) وتطلعات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، فقد وقفت تونس والجزائر على الحياد. أما الاتجاه الثالث، فكان في ابتعاد دول الجوار الجنوبي عن التعامل الإقليمي مع المشكلة الليبية. وقد أفسح هذا التفكّك الطريق أمام نفوذ دول عديدة على حساب الجوار الليبي، لا سيما من الدول الأوروبية وبعض دول الخليج.
ديناميكية الوضع الليبي
لدى صدور قانون العزل السياسي منذ مايو/ أيار 2013، تحول الخلاف السياسي في ليبيا
إلى أزمةٍ سياسيةٍ، واتخذ صيغة الحرب الأهلية. على أية حال، كشفت الأزمة عن ركود قدرات كل الأطراف وعجزها عن تقديم حل سياسي، يراعي مطالب المناطق المختلفة، أو تحقيق ميزة عسكرية. وبهذا المعنى، وصلت قدرات المكونات السياسية والعسكرية إلى حالة من التداعي بعد عنفوانٍ ظهرت عليه في السابق، ما وفّر فرصةً لتدخل وسطاء دوليين، وهذا ما يفسر، جزئياً، حرص الوساطات الدولية على التعامل مع مكوّنات حكومة الوفاق والسياسيين في شرق ليبيا، وهو تعامل يغلب عليه التعريف السياسي للمشكلة، القائم فعلياً، وبما لا يعني إهمال الجانب القانوني، وقد حدث ذلك في منتدياتٍ كثيرة، كان أهمها في باريس 2017 و2018، وإيطاليا 2018، وأبوظبي 2019، وموسكو 2020 وأخيراً اجتماع برلين الذي طالبت حكومة الوفاق، في سياقه، بوقف ازدواج التعامل الدولي وقبول بعض الدول التعامل مع حفتر طرفاً ليبياً، وأن دعم مصر والإمارات له يقوم على تقديرٍ غير سليم بسيطرة الإخوان المسلمين على القوى السياسية فيها. واستند في موقفه إلى نتائج الانتخابات في عامي 2012 و2014، حيث تظهر أن وزنهم السياسي لا يتجاوز 20% وفي حالة تراجع، ولا يمثلون ثقلاً يعتدّ به في حكومة الوفاق التي أوضح رئيسها، فايز السراج، تفهمه للقلق المصري الذي يمكن معالجته عبر الحوار المباشر.
وفي توقيت متزامن، صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، لتقييم الوضع الأمني والعسكري في ليبيا، جاء على انتهاكات مرتبطة بالهجوم غير الشرعي على طرابلس، وخصوصاً الغارات الجوية المتكرّرة (1020 غارة) ونزوح 140 ألفاً وقتل 284 مدنياً، وذلك بالإضافة إلى انهيار النظام العام في شرق ليبيا. وعلى الرغم من الطبيعة الوصفية للتقرير، ترتب الجرائم المرصودة في التقارير الدولية والمحلية مسؤولية سياسية مباشرة، قد تؤدي إلى إدانة خليفة حفتر، لكنها، على أية حال، قد تعني، في أحد جوانبها، تزايد فرصة مراجعة جادّة للحل العسكري ودور داعميه في ليبيا في العملية السياسية.
ويمكن القول إن جزءاً كبيراً من الأزمة يرجع إلى اختلاف التعامل الدولي، وتركيزه على مسائل الأمن يمثل المعضلة الأساسية. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أن تجربة الأمم المتحدة والاجتماعات الدولية المخصصة لبناء النظام الأمني والجيش من دون الاهتمام بدعم المسار السياسي، وهي بدأت بقرار مجلس الأمن 1995، وباريس 2013 وروما 2014، أدّت إلى نتائج عكسية، ترتب عليها شيوع الحرب الأهلية وانتشار أكثر للسلاح، وهذا ما يطرح أولوية مراجعة العوامل التي تسببت في إخفاق المجتمع الدولي، وعجزه عن امتصاص التوتر
وبناء الثقة فيما بين الأطراف المختلفة. وهنا، تتطلب تسوية الأزمة الليبية أو حلها تصنيفها ضمن مسارين؛ بناء الحكومة المستقلة وتمكينها من تنفيذ برامج الإدماج السياسي للمسلحين وتسوية المشكلات الأمنية، ووضع سياساتٍ للتنمية، تقوم على اقتراح أشكال لتوزيع العوائد تحفظ تماسك الدولة.
وبشكل عام، يمكن القول إن السياسة الجزائرية تجاه ليبيا تستمد زخمها من التسوية السريعة لأزمتها الداخلية، وقدرتها على تحديد نطاقات التهديد والمصالح. وهذا ما يشكّل ركيزة للتجديد السياسي، ويمنحها إمكانية العمل على تعويض التراخي الدولي تجاه ليبيا، وذلك من خلال محورين، يتعلق الأول بتطوير سياستها لبناء إطار إقليمي، يجمع بين مصر وتركيا لإيجاد بيئة توازنية في البحر المتوسط. أما الثاني، حيث تكون الأولوية لإصلاح العلاقات ما بين دول الجوار بطريقةٍ تساعد على طرح موقف متماسكٍ تجاه الحل السياسي في ليبيا.
وعلى مستوى آخر، دفع الدخول التركي على الأزمة في ليبيا الدول الأوروبية إلى التوافق على
تغير "جوار ليبيا" وثباته
لافتٌ أن اجتماع الجزائر جاء بعد مؤتمر برلين، ليعكس تغيراً غير مألوف في العلاقات السياسية بين دول الشمال والجنوب، فقد كان النمط السائد متمثلاً في بدء الاجتماعات في بلدان الجنوب كأعمال تحضيرية للمؤتمرات الدولية. وبهذا المعنى، تبدو مبادرة برلين مؤشراً على إعادة ترتيب النظر الدولي بشأن ليبيا. وهنا، يمكن النظر باهتمام إلى نشاط السياسة الألمانية، واتساقه حول دعم الحل السلمي، ولعل مشاركة وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، في اجتماع الجزائر، أضفت أبعاداً إيجابية على التلاقي مع الدول الإقليمية على دعم المسار السياسي.
وفي هذا السياق، انتقل موقف دول الجوار، بطريقة نوعية، إلى التأكيد على "ضرورة إشراك دول جوار ليبيا في أية مساعٍ دولية لحل الأزمة الليبية.. وآلية المتابعة المنبثقة عن مؤتمر برلين"، وهو ما يعمل على توسيع مساهمة ذوي المصلحة من دول الجوار، حسب التعريف الواسع، ولا يترك أمرها وفقاً لرؤية الدولة الداعية، كما حدث في مؤتمر برلين واجتماعات دولية أخرى، حيث اقتصرت الدعوة على دول من الجوار دون غيرها. وذلك على خلاف
ويمثل حضور دول الجوار الموسع علامة مهمة في التعامل مع الأزمة في ليبيا، وخصوصاً في ظل سيولة الحدود وانفلات الهجرة غير الشرعية. وهنا تبدو أهمية إطلاع دول الجوار الأفريقي جنوب الصحراء على مجريات التعامل الدولي على ليبيا، وطرق النقاش حول قضايا الأمن الجماعي، وتوفير الحلول الملائمة لمشكلة الهجرة، فهي لا تقتصر على تحقيق الاستقرار في ليبيا، حيث تمثل دولة عبور، وبالتالي، فإن تحدّي مقاومة الهجرة يكون من خلال إعمال المسؤولية المشتركة في مجالي أمن الحدود والتنمية الاقتصادية.
وعلى أي حال، كانت مخرجات الاجتماع، في جانب كبير منها، متماثلةً مع لغة البيانات
وتشير الملامح المشتركة لمناقشات الاجتماع إلى تأكيد الحل السياسي، وتثبيت الهدنة، ووقف إرسال الأسلحة، ومكافحة الإرهاب ووقف التدخل الدولي، غير أن الموقف المصري كان أكثر تفصيلاً عندما حدّد حزمة من الخطوات للحل السياسي، فمن جهةٍ توسع في تعريف المنظمات الإرهابية القريبة من حكومة الوفاق، والتي تشكل تهديداً للمسار السياسي الليبي المستقل. ومن جهة أخرى، ولتوضيح موقفها، اعتبرت مصر أن الوصول إلى حل سياسي يتطلب اتخاذ خطواتٍ تبدو متزامنةً، لتشمل تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح المليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبي.
مسيرة دول الجوار
وبالنظر إلى مشوار دول الجوار الليبي منذ عام 2014، يمكن ملاحظة تغير مفهوم دول الجوار. فمن جهة عدد المشاركين، بدت الاجتماعات مفتوحةً لمشاركة الدول الحدودية مع ليبيا في اجتماعات الجزائر والقاهرة والخرطوم وتونس، لكنها شهدت انكماشاً في مرحلةٍ لاحقة، لتقتصر على ثلاث دول، مصر وتونس والجزائر. وبالتالي، تراعي العودة إلى الصيغة الأولية مصالح كل الأطراف، وتقلل التوجهات الاحتكارية للملف الليبي. ومن ناحية التوجه السياسي، ظلت البيانات الختامية والاجتماعات غير المنتظمة تؤكد الحل السلمي، ورفض الحلول العسكرية أو العنفية وإدانة الإرهاب، لكنها لم تتمكّن من وقف المعارك أو جمع السلاح.
ويرجع ضعف دول الجوار وعدم قدرتها على وقف الحرب إلى تشتت مواقفها السياسية. وهنا تبرز ثلاثة اتجاهات، فبينما انحازت مصر لمجلس النواب (طبرق) وتطلعات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، فقد وقفت تونس والجزائر على الحياد. أما الاتجاه الثالث، فكان في ابتعاد دول الجوار الجنوبي عن التعامل الإقليمي مع المشكلة الليبية. وقد أفسح هذا التفكّك الطريق أمام نفوذ دول عديدة على حساب الجوار الليبي، لا سيما من الدول الأوروبية وبعض دول الخليج.
ديناميكية الوضع الليبي
لدى صدور قانون العزل السياسي منذ مايو/ أيار 2013، تحول الخلاف السياسي في ليبيا
وفي توقيت متزامن، صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، لتقييم الوضع الأمني والعسكري في ليبيا، جاء على انتهاكات مرتبطة بالهجوم غير الشرعي على طرابلس، وخصوصاً الغارات الجوية المتكرّرة (1020 غارة) ونزوح 140 ألفاً وقتل 284 مدنياً، وذلك بالإضافة إلى انهيار النظام العام في شرق ليبيا. وعلى الرغم من الطبيعة الوصفية للتقرير، ترتب الجرائم المرصودة في التقارير الدولية والمحلية مسؤولية سياسية مباشرة، قد تؤدي إلى إدانة خليفة حفتر، لكنها، على أية حال، قد تعني، في أحد جوانبها، تزايد فرصة مراجعة جادّة للحل العسكري ودور داعميه في ليبيا في العملية السياسية.
ويمكن القول إن جزءاً كبيراً من الأزمة يرجع إلى اختلاف التعامل الدولي، وتركيزه على مسائل الأمن يمثل المعضلة الأساسية. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أن تجربة الأمم المتحدة والاجتماعات الدولية المخصصة لبناء النظام الأمني والجيش من دون الاهتمام بدعم المسار السياسي، وهي بدأت بقرار مجلس الأمن 1995، وباريس 2013 وروما 2014، أدّت إلى نتائج عكسية، ترتب عليها شيوع الحرب الأهلية وانتشار أكثر للسلاح، وهذا ما يطرح أولوية مراجعة العوامل التي تسببت في إخفاق المجتمع الدولي، وعجزه عن امتصاص التوتر
وبشكل عام، يمكن القول إن السياسة الجزائرية تجاه ليبيا تستمد زخمها من التسوية السريعة لأزمتها الداخلية، وقدرتها على تحديد نطاقات التهديد والمصالح. وهذا ما يشكّل ركيزة للتجديد السياسي، ويمنحها إمكانية العمل على تعويض التراخي الدولي تجاه ليبيا، وذلك من خلال محورين، يتعلق الأول بتطوير سياستها لبناء إطار إقليمي، يجمع بين مصر وتركيا لإيجاد بيئة توازنية في البحر المتوسط. أما الثاني، حيث تكون الأولوية لإصلاح العلاقات ما بين دول الجوار بطريقةٍ تساعد على طرح موقف متماسكٍ تجاه الحل السياسي في ليبيا.