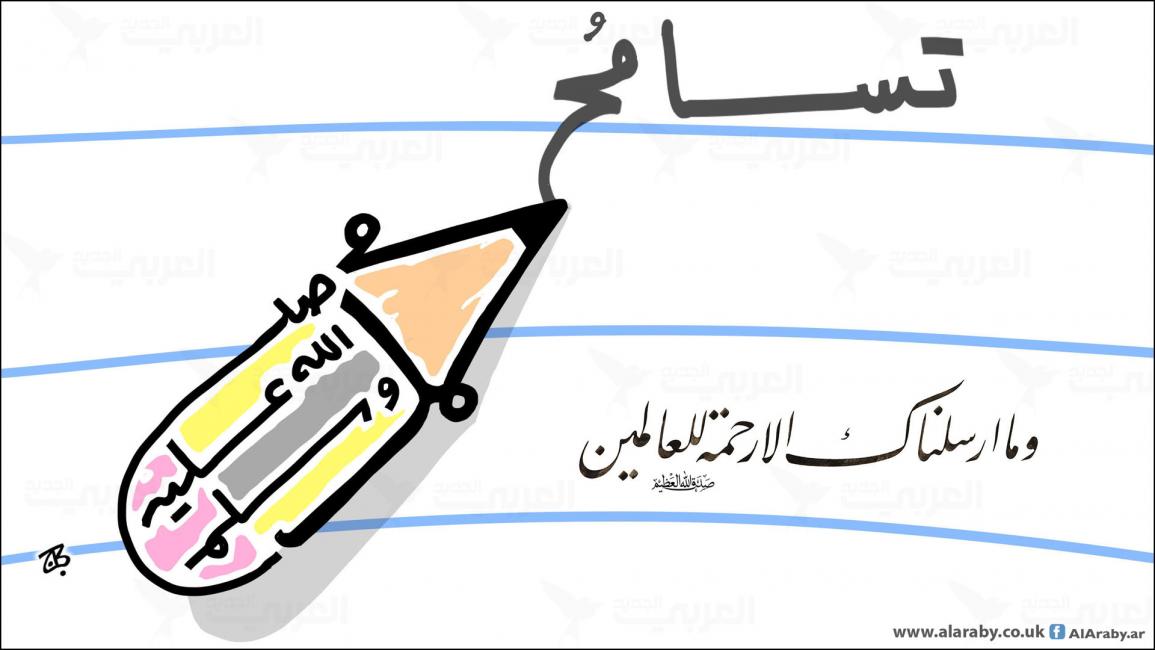25 مارس 2024
بين روحية الإسلام وعنف الإسلاميين في ألمانيا
بين روحية الإسلام وعنف الإسلاميين في ألمانيا
كان صديقي في مطعم سوري في برلين، وكان صاحب المطعم مع مجموعة من أصدقائه يتسايرون حول الوضع المناخي في سورية، حيث تشهد مناطق عديدة أمطارًا غير مسبوقة، قال لهم صاحب المطعم: الله يبعت الخير لكل بلاد الإسلام. فتدخل صديقي سائلاً إياه: وباقي البشرية؟ أليس من حقها أن تنعم بالخير؟ رد عليه مؤكدًا: لا، بلاد الإسلام فقط تستحق الخير. سأله: وهنا؟ هذه البلاد التي تستقبلك وتطعمك وتمنحك المسكن وفرصة العمل والمدارس لأبنائك وفرص الحياة كلها، ألا يستحق أهلها؟ فأصرّ على أن لا، فهم كفار. فقال له صديقي: ولماذا تعيش بينهم؟ ردّ عليه: هي بلادنا، بلاد الإسلام وإذا أردت أحاججك بالفتاوى الشرعية.
تتكرر هذه القصة في ألمانيا بأشكال مختلفة، وتدل على بنية تفكير واحدة، وإذا مررنا بشارع زونن أليه في برلين، والذي بات يُسمى حتى بين الجاليات العربية بشارع العرب، نرى مظاهر التمسّك السافر بالعادات وأساليب العيش المتبعة في بلد المنشأ نفسها من دون أي محاولةٍ للاندماج مع ثقافة المجتمع المضيف وعاداته، فحتى اللافتات على أبواب المحلات مكتوبة باللغة العربية فقط في غالبيتها، يوحي المشهد بأن هناك مجتمعًا موازيًا ينمو ويكبر في هذا الحي، على الرغم من العمل الحثيث من الحكومة الألمانية على توفير سبل دمج اللاجئين ومتابعتها. وحاليًا يسعى رؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، على مستويي الاتحاد والولايات، لتخصيص دروس للاجئين في شأن فهم الدستور الألماني وقيم المجتمع. ولقد طرحت هذه الفكرة للتدارس، مراعاة للخصوصية الثقافية لكل ولاية ألمانية.
بحسب الموقع الرسمي لجامعة دورتموند التي افتتحت فرعًا يختص بأمور اللجوء والهجرة، يكتسب الطلاب الكفاءة المهنية للعمل مساعدين للاجئين، ومن برامجه وتوجهاته كيفية الوصول إلى سوق العمل، حق الإقامة، قانون الاتحاد الأوروبي، إجراءات الطعن ضد القرارات. والقضايا السياسية الاجتماعية، ونظريات وطرق حلّ التمييز الاجتماعي والعنصرية المتعلقة بالأعراق، واكتساب المعرفة الثقافية للبلدان التي يأتي منها اللاجئون بشكل أكبر، بالإضافة إلى ثقافة الترحيب في المجتمع المضيف. وذلك انطلاقًا من الاقتناع بأهمّية أن يساهم مساعدو اللاجئين والمهاجرين الذين يتم تأهيلهم في بناء الجسور لإيصال الخدمات المتوفرة لمن يحتاجها من اللاجئين والمهاجرين. ولأجل الموضوعية أيضًا، لا يمكن إغفال إدراك ألمانيا أهمية المهاجرين واللاجئين إليها ودورهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، خصوصًا كونها دولة توصف بأنها هرمة، ونسبة النمو السكاني فيها في تناقص.
ومع هذا، هناك تخوف لدى قسم من الشعب الألماني من الوفود الكبير للاجئين إليها، تخوف من زعزعة الاستقرار المجتمعي وإرباك الإرث الثقافي والعادات وتشويش الهوية الألمانية الذي يؤدي بالمجمل إلى الشعور بفقدان الوطن. إذ لا يمكن إغفال ما لعبته وتلعبه الوسائط المتعددة في العصر الحالي والأخبار على مدار الساعة من قلق وتخوف من الإسلام أمام هذا الطوفان الأصولي الدموي الذي يكرّس ثقافة الموت خارج المعرفة الحقيقية بحدود الموت.
فكيف للإسلام أن يؤكد فعاليّته، بوصفه روحية كبرى في وسطٍ لا يخفي رفضه القبول العفوي برؤى المؤسسة الدينية للواقع والعالم؟ علينا أن نعترف بأن هناك أزمة يعاني منها الإسلام، ومن الضروري البحث عن هذه الأزمة التي يشعر بها المسلمون شعوراً واعياً، ويدفعون ضريبتها في مجتمعاتهم، وفي المجتمعات المضيفة، حتى لو لم يكن بعض منهم على علاقةٍ بهذا النوع من الفهم الديني والسلوك الديني. وما العمل لهؤلاء الذين يعتنقون ويمارسون الإسلام بوصفه دينًا شعبيًا ومعتقدًا يعيشون بروحيته ورحمته أمام الإحراج الذي تسببه الأصولية بواقعها الحالي، ومحاولتها السيطرة أو الهيمنة التاريخية من داخل رأسمال رمزي ثقافي وتاريخي، متكئين على مبادئ أساسية، تقول بختم النبوة التي تلخص "روح الثقافة الإسلامية" من جهة، وتجسّد مبدأ الاستخلاف، بوصفه إثباتاً لفعالية الإنسان من جهة أخرى. وهذا يشلّ المسلم المعاصر عن فهم وتقبل فكرة أساسية: ألا يكون الوحي مقصوراً على الحدث الإسلامي، بل هو ظاهرة إنسانية كونية، كما جاء على لسان الكاتب التونسي، الطاهر أمين، في كتاب الإسلام النقدي.
هذا الإيمان الراسخ كعقيدة جبارة في نفوس المغرّر بهم والمضللين من دعاة الإسلام السلفي الجهادي الإقصائي جعل صاحب المطعم المذكور مؤمنًا بأن ألمانيا وغيرها هي بلاد الإسلام التي يسعى الإسلام السياسي من هذا القبيل إلى تحقيق فكرة الخلافة عليها وعلى العالم. فهل
يكفي أن نتهم الغرب، والولايات المتحدة تحديداً، بأنها المسؤولة الوحيدة عن تلك الإيديولوجيا المتحولة بأن شجعتها ودعمتها ونظمتها وأسست لها؟ أم لا بدّ من نقد الذات وإماطة اللثام عن المسؤولية المنوطة بنا؟ وأولى درجات النقد الاعتراف بالمشكلة.
تقوم الحركات الأصولية على عدم فصل الديني عن السياسي، كذلك السلطات العربية فهي لم تقطع الحبل السري الذي يربط الديني بالسياسي قطعاً نهائياً، بل كانت تقف دائما بجانب الدين، ما ساهم في نمو تلك الحركات، معتمدة على سلعة ثمينة هي "الفضيلة" التي تجد مرتكزها الأخلاقي في الوحي السماوي، تسعى بنظرية الجهاد وتطبيقه إلى فرض "رعب الفضيلة"، من أجل الوصول إلى السلطة، وليس السلطة السياسية وحكم البلاد، كل البلاد، بل تكريس هذا الشعور في الوعي الجمعي، ليصبح الأفراد من تلقاء أنفسهم يمارسون هذا التسلط، مؤمنين بأنهم الأخيار، وبأنهم يحملون رسالة نشر الإسلام وهيمنته على العالم.
في المقابل، هل على الغرب إعادة نظره في الصورة الزمنية الطارئة التي شكّلها الفعل العنيف، في دار الإسلام قبل دار الغرب، للحركات السياسية الدينية المتصلبة وفك الارتباط بين الإسلام الحضاري، وهو فضاء إنساني رحيم، وهو الأكثري، وما يسميه الإعلام الغربي الإسلام السياسي الذي هو إفراز زمني كان للغرب نفسه يد طولى في نشأته وتطوره، كما كتب المفكر الأردني الفلسطيني فهمي جدعان؟
في المحصلة النهائية، تصنع الحكومات والأنظمة السياسية القضايا الخلافية، تبعًا لمطامعها ومطامحها والشعوب في الحالتين تدفع الثمن. لا يمكن نكران تخوف شريحة من الألمان من الوجود الكبير للاجئين والمهاجرين، خصوصا ممن ينحدرون من ثقافات مختلفة، وينتمون إلى الإسلام الذي صار فزّاعة الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا أن معظمهم لا يعرفون من المسلمين إلا "داعش" وأخواتها والممارسات الدموية التي تقوم بها بحق كل شعوب الأرض، وأن هناك كثيرين ممن يحملون هذه العقيدة، ويمارسونها عن قناعة، وانتظارًا لأجر مؤجل. من المؤسف أن نرى الانزياح في ألمانيا بحق اللاجئين من "ثقافة الترحيب إلى سياسة الترحيل" التي ستنعكس سلبًا على عشرات الآلاف من السوريين المهجرين من مدنهم وقراهم التي بعضها أصبح أثرًا بعد عين، بفعل الحرب التي لم يشهد التاريخ الحديث ببشاعتها، ولم يعد لديهم موطئ قدم في المستقبل المنظور في وطنهم.
تتكرر هذه القصة في ألمانيا بأشكال مختلفة، وتدل على بنية تفكير واحدة، وإذا مررنا بشارع زونن أليه في برلين، والذي بات يُسمى حتى بين الجاليات العربية بشارع العرب، نرى مظاهر التمسّك السافر بالعادات وأساليب العيش المتبعة في بلد المنشأ نفسها من دون أي محاولةٍ للاندماج مع ثقافة المجتمع المضيف وعاداته، فحتى اللافتات على أبواب المحلات مكتوبة باللغة العربية فقط في غالبيتها، يوحي المشهد بأن هناك مجتمعًا موازيًا ينمو ويكبر في هذا الحي، على الرغم من العمل الحثيث من الحكومة الألمانية على توفير سبل دمج اللاجئين ومتابعتها. وحاليًا يسعى رؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، على مستويي الاتحاد والولايات، لتخصيص دروس للاجئين في شأن فهم الدستور الألماني وقيم المجتمع. ولقد طرحت هذه الفكرة للتدارس، مراعاة للخصوصية الثقافية لكل ولاية ألمانية.
بحسب الموقع الرسمي لجامعة دورتموند التي افتتحت فرعًا يختص بأمور اللجوء والهجرة، يكتسب الطلاب الكفاءة المهنية للعمل مساعدين للاجئين، ومن برامجه وتوجهاته كيفية الوصول إلى سوق العمل، حق الإقامة، قانون الاتحاد الأوروبي، إجراءات الطعن ضد القرارات. والقضايا السياسية الاجتماعية، ونظريات وطرق حلّ التمييز الاجتماعي والعنصرية المتعلقة بالأعراق، واكتساب المعرفة الثقافية للبلدان التي يأتي منها اللاجئون بشكل أكبر، بالإضافة إلى ثقافة الترحيب في المجتمع المضيف. وذلك انطلاقًا من الاقتناع بأهمّية أن يساهم مساعدو اللاجئين والمهاجرين الذين يتم تأهيلهم في بناء الجسور لإيصال الخدمات المتوفرة لمن يحتاجها من اللاجئين والمهاجرين. ولأجل الموضوعية أيضًا، لا يمكن إغفال إدراك ألمانيا أهمية المهاجرين واللاجئين إليها ودورهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، خصوصًا كونها دولة توصف بأنها هرمة، ونسبة النمو السكاني فيها في تناقص.
ومع هذا، هناك تخوف لدى قسم من الشعب الألماني من الوفود الكبير للاجئين إليها، تخوف من زعزعة الاستقرار المجتمعي وإرباك الإرث الثقافي والعادات وتشويش الهوية الألمانية الذي يؤدي بالمجمل إلى الشعور بفقدان الوطن. إذ لا يمكن إغفال ما لعبته وتلعبه الوسائط المتعددة في العصر الحالي والأخبار على مدار الساعة من قلق وتخوف من الإسلام أمام هذا الطوفان الأصولي الدموي الذي يكرّس ثقافة الموت خارج المعرفة الحقيقية بحدود الموت.
فكيف للإسلام أن يؤكد فعاليّته، بوصفه روحية كبرى في وسطٍ لا يخفي رفضه القبول العفوي برؤى المؤسسة الدينية للواقع والعالم؟ علينا أن نعترف بأن هناك أزمة يعاني منها الإسلام، ومن الضروري البحث عن هذه الأزمة التي يشعر بها المسلمون شعوراً واعياً، ويدفعون ضريبتها في مجتمعاتهم، وفي المجتمعات المضيفة، حتى لو لم يكن بعض منهم على علاقةٍ بهذا النوع من الفهم الديني والسلوك الديني. وما العمل لهؤلاء الذين يعتنقون ويمارسون الإسلام بوصفه دينًا شعبيًا ومعتقدًا يعيشون بروحيته ورحمته أمام الإحراج الذي تسببه الأصولية بواقعها الحالي، ومحاولتها السيطرة أو الهيمنة التاريخية من داخل رأسمال رمزي ثقافي وتاريخي، متكئين على مبادئ أساسية، تقول بختم النبوة التي تلخص "روح الثقافة الإسلامية" من جهة، وتجسّد مبدأ الاستخلاف، بوصفه إثباتاً لفعالية الإنسان من جهة أخرى. وهذا يشلّ المسلم المعاصر عن فهم وتقبل فكرة أساسية: ألا يكون الوحي مقصوراً على الحدث الإسلامي، بل هو ظاهرة إنسانية كونية، كما جاء على لسان الكاتب التونسي، الطاهر أمين، في كتاب الإسلام النقدي.
هذا الإيمان الراسخ كعقيدة جبارة في نفوس المغرّر بهم والمضللين من دعاة الإسلام السلفي الجهادي الإقصائي جعل صاحب المطعم المذكور مؤمنًا بأن ألمانيا وغيرها هي بلاد الإسلام التي يسعى الإسلام السياسي من هذا القبيل إلى تحقيق فكرة الخلافة عليها وعلى العالم. فهل
تقوم الحركات الأصولية على عدم فصل الديني عن السياسي، كذلك السلطات العربية فهي لم تقطع الحبل السري الذي يربط الديني بالسياسي قطعاً نهائياً، بل كانت تقف دائما بجانب الدين، ما ساهم في نمو تلك الحركات، معتمدة على سلعة ثمينة هي "الفضيلة" التي تجد مرتكزها الأخلاقي في الوحي السماوي، تسعى بنظرية الجهاد وتطبيقه إلى فرض "رعب الفضيلة"، من أجل الوصول إلى السلطة، وليس السلطة السياسية وحكم البلاد، كل البلاد، بل تكريس هذا الشعور في الوعي الجمعي، ليصبح الأفراد من تلقاء أنفسهم يمارسون هذا التسلط، مؤمنين بأنهم الأخيار، وبأنهم يحملون رسالة نشر الإسلام وهيمنته على العالم.
في المقابل، هل على الغرب إعادة نظره في الصورة الزمنية الطارئة التي شكّلها الفعل العنيف، في دار الإسلام قبل دار الغرب، للحركات السياسية الدينية المتصلبة وفك الارتباط بين الإسلام الحضاري، وهو فضاء إنساني رحيم، وهو الأكثري، وما يسميه الإعلام الغربي الإسلام السياسي الذي هو إفراز زمني كان للغرب نفسه يد طولى في نشأته وتطوره، كما كتب المفكر الأردني الفلسطيني فهمي جدعان؟
في المحصلة النهائية، تصنع الحكومات والأنظمة السياسية القضايا الخلافية، تبعًا لمطامعها ومطامحها والشعوب في الحالتين تدفع الثمن. لا يمكن نكران تخوف شريحة من الألمان من الوجود الكبير للاجئين والمهاجرين، خصوصا ممن ينحدرون من ثقافات مختلفة، وينتمون إلى الإسلام الذي صار فزّاعة الشعوب في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا أن معظمهم لا يعرفون من المسلمين إلا "داعش" وأخواتها والممارسات الدموية التي تقوم بها بحق كل شعوب الأرض، وأن هناك كثيرين ممن يحملون هذه العقيدة، ويمارسونها عن قناعة، وانتظارًا لأجر مؤجل. من المؤسف أن نرى الانزياح في ألمانيا بحق اللاجئين من "ثقافة الترحيب إلى سياسة الترحيل" التي ستنعكس سلبًا على عشرات الآلاف من السوريين المهجرين من مدنهم وقراهم التي بعضها أصبح أثرًا بعد عين، بفعل الحرب التي لم يشهد التاريخ الحديث ببشاعتها، ولم يعد لديهم موطئ قدم في المستقبل المنظور في وطنهم.
مقالات أخرى
08 مارس 2024
23 فبراير 2024
14 فبراير 2024