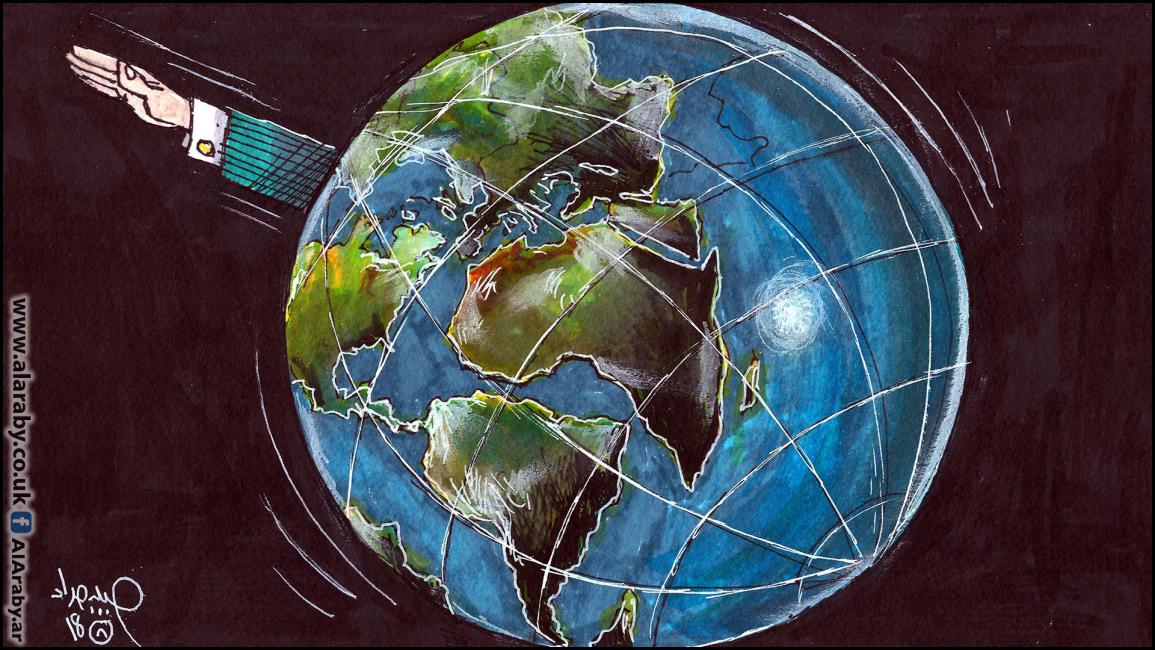21 مارس 2024
بين اليمينين الديني والعلماني
بين اليمينين الديني والعلماني
تكثر الكتابات على هامش أي حركة شعبية احتجاجية عالمية أو إقليمية، بشأن طبيعة الحركة وأهدافها وأفقها، ويتم الربط بشكل مباشر بطبيعة القوى المنظمة لها والمشاركة فيها، من دون إهمال خلفيات المتظاهرين الثقافية، والتي غالبا ما تشير إلى محاولات القوى والأحزاب اليمينية للسيطرة عليها وتوجيهها، سواء في المنطقة العربية أو في الدول الغربية المتطورة، وجديدها حركة السترات الصفراء، والتي تترافق مع قصور في مشاركة القوى اليسارية المنظمة، يصل، في بعض الأحيان، إلى غياب كامل، وهو ما يتناقض مع تاريخية التصنيف السياسي بين اليمين واليسار، المعمول به منذ الثورة الفرنسية، والمستند إلى تناقض بين تيارين كبيرين، يسعى اليميني منهما إلى الحفاظ على الوضع القائم ومنظومة الحكم، بينما يهدف اليساري إلى تحقيق تغيير متطور شامل.
وقد تقود المتابعة المتسرعة لتصريحات القوى اليمينية واليسارية التقليدية ومواقفها من الأحداث والأوضاع الراهنة، إلى حالة من الارتباك والتشويش، نتيجة سعي بعض القوى اليمينية بعد الانفجارات الشعبية إلى الخروج عن التقاليد السياسية المعمول بها داخليا وخارجيا، وكأنها تعبر عن نقيض كل ما هو قائم ومكرس منذ سنوات عديدة. وهو ما يجده بعضهم مثالا حيا وواقعيا على ثورية القوى التي تمثل اليمين من الأحزاب والقوى الدينية في منطقتنا، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك قوى اليمين في الدول الغربية المتطورة، التي يعتبر الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، أحد إفرازاتها العملية. وهو ما يغفل التدقيق في برامجها المعلنة، التي لا تقدم أي بديل حقيقي اقتصاديا وسياسيا، بل غالبا ما تعمل على حرف الصراع الطبقي والاجتماعي إلى زوايا أخرى، أخلاقية وجندرية وعنصرية ودينية، على اعتبارها القوى الوحيدة القادرة على حسم هذا الصراع الأخلاقي. بحيث نكون أمام مجموعاتٍ انتهازيةٍ، تستثمر الاضطرابات الحاصلة من أجل الحصول على السلطة، عبر حرف المشكلات القائمة عن جذورها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى متاهات طائفية وعنصرية.
وعلى الضفة الأخرى، نجد مواقف يسارية، أو لقوى محسوبة على اليسار التقليدي، متشبثة
وبقوة في الحفاظ على المنظومة السائدة، مثل مواقف الأحزاب الشيوعية واليسارية والقومية العربية من الثورة السورية، ومجمل الثورات العربية، إذا استثنينا الموقف من الثورة التونسية التي تمكّنت، بصورة شبه وحيدة، من كسر هذه القاعدة، فقد انقلب الموقف اليساري من الوضع المصري بصورة جذرية، من اعتبارها ثورة شعبية حقيقية ومباركة إلى مؤامرة أو مسرحية إقليمية، وأحيانا صهيونية وأميركية، تهدف إلى إسقاط نظام حسني مبارك لصالح جماعة الإخوان المسلمين، ما دفعهم نحو مباركة عودة الجيش إلى واجهة الأحداث السياسية المصرية عبر عبد الفتاح السيسي، مهما كانت الطريقة وبأي ثمن، وكأنه البطل المنقذ من نيران التخلف والعمالة والإجرام.
في الوقت نفسه، حافظت غالبية القوى المحسوبة على اليسار على موقفها الداعم للنظام السوري منذ بدايات الحركة الثورية وحتى اللحظة الراهنة، من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التدقيق في الأحداث الجارية، مهما استفحل النظام في إجرامه، أو تضحيته باستقلال سورية وسيادتها السياسية والجغرافية لصالح الروس والإيرانيين، في سبيل الحفاظ على الحكم، كما لم يكترثوا بأي من مواقف الأسد وتصريحاته القليلة الصادقة، مثل إقراره بسلمية الحركة الثورية ستة أشهر، وهو ما يبرئ الشعب السوري الثائر من جميع الاتهامات التي أغرقوه بها، والتي تحمّل السوريين الثائرين مسؤولية جميع القتلى من المدنيين والعسكريين السوريين في الفترة نفسها. وعليه، يمكن تلمس سعي اليسار التقليدي إلى المحافظة على الوضع القائم تماما، كصديقه اليميني التقليدي، وفي غياب أي طموح سلطوي، فردياً كان أم جماعياً، ربما نتيجة إدراكه غير الواعي مدى عمق الأزمة القائمة عالميا، أو ربما نتيجة اعتياده على أداء الأدوار الثانوية على مدى السنوات السابقة. وبالتالي، نحن أمام تيارين بتوجهات يمينية وفقا للمعنى التقليدي لليمين، أي لا يملكان أي تصور أو مسعى حقيقي لإحداث تغيير جذري بالنمط القائم، لكنهما يتمايزان فيما يخص المواقف الاجتماعية فقط، بين يمين تقليدي ديني، عنصري، يحجم المرأة ويأسرها، ويمين علماني ومتحرر من أي قيود دينية أو تقليدية وتراثية. وهو ما يتجاهل أن عملية التغيير الاجتماعي والثقافي هي نتيجة مباشرة لعملية التطور والتغيير السياسي والاقتصادي، فقد ساهمت الثورة الصناعية والليبرالية في إرساء قيم حرية الإنسان عموما، والمرأة خصوصا، فمن حرية التنقل والعمل، ومن الاستقلال المادي، انتقلنا إلى مكانة الأفراد والمجتمعات وحريتهما، وحق النساء والرجال والأطفال بتحديد خياراتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعيداً عن أي هيمنة أسرية واجتماعية وسلطوية، دينيةً كانت أم سياسية. وبالتالي، لن نتمكن من تحقيق التغيير الاجتماعي والثقافي المنشود في ظل الحفاظ على المنظومة الاقتصادية والسياسية القائمة التي أرست قيمها المعرفية وعاداتها الاجتماعية القائمة اليوم. سواء كان الهدف التقهقر بالمجتمع نحو قيم وعادات بالية أو الارتقاء به نحو مزيد من الحريات والحقوق الاجتماعية، فلكل منهما نمطه الاقتصادي والسياسي الذي يفرضه على المجتمع.
إذن، لا تعبر المواقف الاجتماعية التحررية بحد ذاتها عن أفكار يسارية، كونها لا تنطلق من
تغيير الوضع القائم بصورة جذرية وشاملة، بل تتحوّل عبر فصل المطالب الاجتماعية بشكل قسري عن المطالب السياسية والاقتصادية، إلى جزء من المعضلة، ومن المنظومة الحاكمة سواء أكانت على رأس الهرم السلطوي أم على الهامش. وبالتالي، لابد لأي خطاب يسعى إلى التغيير من تجاوزها كلياً، بالإضافة إلى تجاوز كامل المنظومة الحاكمة والسائدة، وهو ما يفسر انتشار ظاهرة القطيعة السياسية بين الشعوب الثائرة والمحتجة والقوى السياسية القائمة، شرقا وغربا، ومنها ندرك انتشار عفوية الشعوب واحتجاجاتها، نتيجة غياب القوى المعبرة عنها والمنخرطة معها في نضالها، بداية من قدرتها على تحليل المنظومة السائدة وتفكيكها، مروراً بتحديد البديل الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي، القادر على تحقيق تطلعات الشعوب وأهدافها، وصولا إلى الانخراط في النضال الميداني الحقيقي في الشوارع والمعامل، فاليسار بوصفه قوة تغيير علمية ومادية غائب تماما اليوم عن جميع ساحات النضال الميدانية والفكرية، ما يفسح المجال أمام تيارات تتبنى بعض القيم العلمانية والتحرّرية من ادعاء تمثيلها له، على الرغم من أنها جزء عضوي من كامل المنظومة القائمة، وإن كان هامشياً، وفقاً لموضعه الطبقي والثقافي والسياسي، وهو ما يجعلهم يخشون تغيير هذه المنظومة، أو حتى المساس بها، خوفا من تبدل أحوالهم ومكتسباتهم الذاتية، من دون أي اكتراث بمصالح الشعوب والأوطان. وهو ما يجعل منه تيارا يمينيا محافظا سياسيا واقتصاديا، وبأفكار اجتماعية تحررية. وبمعنى آخر، أضحى يمينا علمانيا لا أكثر.
وقد تقود المتابعة المتسرعة لتصريحات القوى اليمينية واليسارية التقليدية ومواقفها من الأحداث والأوضاع الراهنة، إلى حالة من الارتباك والتشويش، نتيجة سعي بعض القوى اليمينية بعد الانفجارات الشعبية إلى الخروج عن التقاليد السياسية المعمول بها داخليا وخارجيا، وكأنها تعبر عن نقيض كل ما هو قائم ومكرس منذ سنوات عديدة. وهو ما يجده بعضهم مثالا حيا وواقعيا على ثورية القوى التي تمثل اليمين من الأحزاب والقوى الدينية في منطقتنا، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك قوى اليمين في الدول الغربية المتطورة، التي يعتبر الرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، أحد إفرازاتها العملية. وهو ما يغفل التدقيق في برامجها المعلنة، التي لا تقدم أي بديل حقيقي اقتصاديا وسياسيا، بل غالبا ما تعمل على حرف الصراع الطبقي والاجتماعي إلى زوايا أخرى، أخلاقية وجندرية وعنصرية ودينية، على اعتبارها القوى الوحيدة القادرة على حسم هذا الصراع الأخلاقي. بحيث نكون أمام مجموعاتٍ انتهازيةٍ، تستثمر الاضطرابات الحاصلة من أجل الحصول على السلطة، عبر حرف المشكلات القائمة عن جذورها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، إلى متاهات طائفية وعنصرية.
وعلى الضفة الأخرى، نجد مواقف يسارية، أو لقوى محسوبة على اليسار التقليدي، متشبثة
في الوقت نفسه، حافظت غالبية القوى المحسوبة على اليسار على موقفها الداعم للنظام السوري منذ بدايات الحركة الثورية وحتى اللحظة الراهنة، من دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التدقيق في الأحداث الجارية، مهما استفحل النظام في إجرامه، أو تضحيته باستقلال سورية وسيادتها السياسية والجغرافية لصالح الروس والإيرانيين، في سبيل الحفاظ على الحكم، كما لم يكترثوا بأي من مواقف الأسد وتصريحاته القليلة الصادقة، مثل إقراره بسلمية الحركة الثورية ستة أشهر، وهو ما يبرئ الشعب السوري الثائر من جميع الاتهامات التي أغرقوه بها، والتي تحمّل السوريين الثائرين مسؤولية جميع القتلى من المدنيين والعسكريين السوريين في الفترة نفسها. وعليه، يمكن تلمس سعي اليسار التقليدي إلى المحافظة على الوضع القائم تماما، كصديقه اليميني التقليدي، وفي غياب أي طموح سلطوي، فردياً كان أم جماعياً، ربما نتيجة إدراكه غير الواعي مدى عمق الأزمة القائمة عالميا، أو ربما نتيجة اعتياده على أداء الأدوار الثانوية على مدى السنوات السابقة. وبالتالي، نحن أمام تيارين بتوجهات يمينية وفقا للمعنى التقليدي لليمين، أي لا يملكان أي تصور أو مسعى حقيقي لإحداث تغيير جذري بالنمط القائم، لكنهما يتمايزان فيما يخص المواقف الاجتماعية فقط، بين يمين تقليدي ديني، عنصري، يحجم المرأة ويأسرها، ويمين علماني ومتحرر من أي قيود دينية أو تقليدية وتراثية. وهو ما يتجاهل أن عملية التغيير الاجتماعي والثقافي هي نتيجة مباشرة لعملية التطور والتغيير السياسي والاقتصادي، فقد ساهمت الثورة الصناعية والليبرالية في إرساء قيم حرية الإنسان عموما، والمرأة خصوصا، فمن حرية التنقل والعمل، ومن الاستقلال المادي، انتقلنا إلى مكانة الأفراد والمجتمعات وحريتهما، وحق النساء والرجال والأطفال بتحديد خياراتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعيداً عن أي هيمنة أسرية واجتماعية وسلطوية، دينيةً كانت أم سياسية. وبالتالي، لن نتمكن من تحقيق التغيير الاجتماعي والثقافي المنشود في ظل الحفاظ على المنظومة الاقتصادية والسياسية القائمة التي أرست قيمها المعرفية وعاداتها الاجتماعية القائمة اليوم. سواء كان الهدف التقهقر بالمجتمع نحو قيم وعادات بالية أو الارتقاء به نحو مزيد من الحريات والحقوق الاجتماعية، فلكل منهما نمطه الاقتصادي والسياسي الذي يفرضه على المجتمع.
إذن، لا تعبر المواقف الاجتماعية التحررية بحد ذاتها عن أفكار يسارية، كونها لا تنطلق من