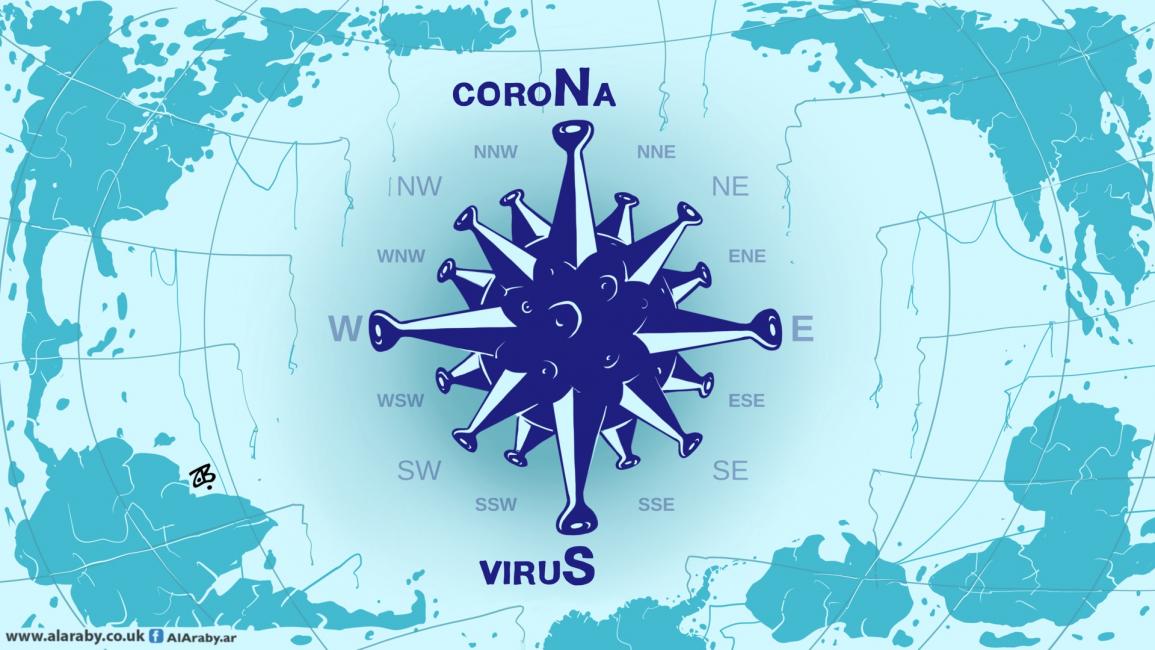مفارقات الوباء والانتباه الفائت
مفارقات الوباء والانتباه الفائت
يبدو أنّ النّاس لا تقرأ إلّا ما يطرحه زحام الأضواء في الميديا. لا ينتبهون، ربّما، إلى ما تؤجّله الأقدار من كوارث عامّة، يمكنها أن تفتك بنظام البشر على هذه الأرض. دليلان على ذلك؛ حين تكلّم الإعلام عن "ازدواجية المعايير" لدى البيت الأبيض في عهد دونالد ترامب، أخذ ناس كثيرون يبحثون عن رواية "1984" للبريطاني جورج أورويل، لفهم ما وراء ذلك من استخدام سياسيّ. وحين ضرب كوفيد-19 العالم، قبل عامين، هلع معظم العالم لقراءة رواية "الطاعون" للفرنسيّ ألبير كامي، بدافع المعرفة أو الفضول.
إذاً، نحن بانتظار الكارثة حتى نعرف ماذا يمكن للأدب الإنسانيّ أن يستشرف من غوص وتفكيك للعوالم البشريّة جرّاء تلك المتغيرات العظيمة، نستند إلى الخيال والتحليل؛ هذه الثنائيّة التي تكوّن فنّ البناء والانهيار الدراميّ للأحداث. نلجأ للكتاب، لتجربةٍ رأت شيئاً في المستقبل - اليوم، حدثاً جللاً سوف يغيّر وجه الحياة كلّ بضعة عقود، إذ شبّه بعضهم إجراءات مكافحة كورونا القاسية بأنها تدجين آخر للبشر، وربما مؤامرة للسيطرة أكثر على المجتمعات، وذلك يشبه، إلى حدٍّ كبير، مصائر من عاشوا في الروايات تلك، إننا نسير وفق تطعيمنا بالخوف الإعلاميّ، نمشي مجدّداً على الأرض حاملين تطبيق "المرور الآمن" على جوّالاتنا، ذاك المرور المسمّى "شهادة التلقيح"، وكأننا تجاوزنا ما جاء في الروايات والسينما!
نحن بانتظار الكارثة حتى نعرف ماذا يمكن للأدب الإنسانيّ أن يستشرف من غوص وتفكيك للعوالم البشريّة جرّاء تلك المتغيرات العظيمة
واليوم، تمرّ الذكرى الثانية لبداية انتشار كورونا الذي انطلق من الصين، البلاد العملاقة صاحبة القوة الاقتصاديّة المتشعّبة في العالم، المسيطرة تقريباً على كلّ شيء، ونحن طواعيةً قبلنا الكمّامّة القادمة من هناك، قبلناها بدورها الطبي، ولتتجاوز حدود وجودها معنا، كي تصبح جزءاً من هويتنا، قبلناها بعيونٍ مغمضةٍ عن أيّ وعي يمكن أن نجده في اتفاقية الهيمنة على حريتنا بشكل تدريجيّ، عيون لا ترى إلا الخوف، تماماً كما وضع ضحايا "العمى"، الرواية البرتغالي خوسيه ساراماغو الشهيرة. وهنا أيضاً أستشهد، متأخراً، بتلك الرائعة الأدبية التي انتقلت عام 2008 إلى السينما، لعلها تصل أكثر، لعلها تنشر وعياً ما، لكن العالم مصابٌ بلاهث "التريند"؛ بدايةً من نظرية المؤامرة ونهاية العالم، حتى الاستشهاد المنسوخ للقيم النظريّة في فهم الكارثة وإفناء الذات من أجل الجماعة، أليس ذاك الفهم هو بيت القصيد المطلوب للانتباه على معنى الحياة وشكل استمراريّتها، والتحكّم بأهواء الناس حسب السوق التجاريّة للاستهلاك البشريّ؟
الوعي المتأخر الذي نسعى إليه في أيامنا حالياً، مع تطورات كوفيد-19، قد لا يفيد بشيء طالما أننا تجاوزنا مرحلة اللقاح الإجباري الذي يخفّف من مضاعفات الفيروس، ويسهّل تنقلاتنا؛ فالفردانية في تقرير المصير، كثيراً ما تقع في مطبّ العزلة الاجتماعية والاستخفاف بالحرية، لن تشفع لنا البلدان المتقدّمة في التفكير بصوت عالٍ للتعبير عن ذواتنا. لقد حسم الأمر وبات انتباهنا إلى جدوى الحياة أكثر وضوحاً من قبل، ناهيك عن حمّى الاعتياد على طباع معينة، فإنّ في فهم المجتمع مع حالة القطيع شيئا من التعدّي على الخصوصية، وترك كثير من البيانات مكشوفة وقيد الاستهلاك في أي مكان؛ مثلاً في المقهى ومتاجر البيع الكبيرة والمطاعم والدوائر الحكومية والمهرجانات؛ عليك أن تبرز "كود التلقيح" لتمرّ، وهذا المرور مؤقت، فالجرعة الثالثة من اللقاح في الطريق، بعد انقضاء ستة أشهر على الجرعتين السابقتين... لم يجدوا لنا سبلاً للتأكد من التطعيم ضد "كوفيد" أكثر أماناً لبياناتنا، كلّ شيء مدوّن وفي تلك البطاقة الخضراء التي تمثلك في رموز فقط.
نعيش اليوم تفاصيلنا بأشياء مشتركة مع ما قرأناه عن توقعات نهاية العالم وانتشار السوداويّة والكآبة
نعيش اليوم تفاصيلنا بأشياء مشتركة مع ما قرأناه عن توقعات نهاية العالم وانتشار السوداويّة والكآبة، باليونانية "ميلانخوليا"، وهو عنوان فيلم عن كويكب يصطدم بالأرض وينهي الحياة. إضافة إلى انتشار الأوبئة الجماعيّ، ولكنّنا نصطدم بالواقع الذي هضم تقريباً معظم ما وصل إلينا ودوّنته الأقلام عن وقائع الألم المشترك، عن صور الوجود البشري المهدّد، فجأة ومن دون سابق إنذار، بالزوال! ولا أدري هنا هل يمكنني القول إننا نمتلك القدرة على التعايش مع الأوضاع الجديدة لحركتنا؟ وإذا افترضنا أنّه "تعايش"، فما هو مقدار المراعاة المرجوّة لاحتمالنا انتفاضاً مشابهاً على مستوى القبول بحربٍ على نحو آخر، ضد الإنسان، بأدوات أكثر نعومة من الفيروس؟ حرب يديرها نظام سياسيّ عميق، أو قوى تكنولوجيا بوزن شركة "ميتا" المالكة "فيسبوك"، "إنستغرام"، "واتساب"، "ماسنجر"؟ يمكن قراءة مفردة "حرب" على أنّها فيروس أيضاً، ثمة من يقول إن الأرض تدافع عن نفسها ضد ما يشيده البشر من كوارث كيميائية ونووية وعسكرية ومناخية وبيئية تكاد توقف قلب الكوكب، وهذا مجرّد افتراض.
هل قرأنا ما حدث في مؤتمر المناخ المنعقد في غلاسكو الاسكتلندية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حسب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: "الكارثة المناخية ما زالت ماثلة"، وربما لم يؤخذ كلام الرجل على محمل الجدّ بما يكفي، لكنّ التلوث هو المصير المقبل لهذا الكوكب، نتيجة التسارع وتطوير الأدوات والتقليل من الموارد الطبيعيّة، إضافة إلى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومعظمها ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الفحم والنفط والغاز، وذلك كله مجرّد خيار نفقد السيطرة عليه، سوف يصبح لاحقاً وباءً واقعياً!
الوعي المتأخر الذي نسعى إليه حالياً، مع تطورات كوفيد - 19، قد لا يفيد بشيء طالما أنّنا تجاوزنا مرحلة اللقاح الإجباري
لا ينتبه قادة العالم أيضاً إلى الوجع البشري بالطريقة المزعومة للتعاطف الذي يجب أن تبديه الدول الكبيرة تجاه قضايا الشعوب المضطهدة، إنما يبرمجون تلك النظرة إلى حراك سياسي لاستراتيجية مصالحهم في المنطقة؛ هذا تماماً ما تجسّد في سورية بصورة معاصرة، حين هدّد الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، نظام الأسد بسبب استخدامه السلاح الكيميائي في الحرب الأهلية القائمة في سورية عام 2013. وفي ما بعد، وتأكيداً على سياسة الولايات المتحدة أمام المأساة السوريّة، أمر الرئيس السابق، دونالد ترامب، عام 2017، بقصف بعض المواقع العسكريّة التابعة للأسد وإيران في سورية، بعد استخدام جيش النظام السوري السلاح الكيميائي مرةً أخرى ضد السوريين، وهذا الأمر لم يتحمّله "قلب ترامب" حسب ما سخرت الصحف حينها!
تمتلك الأوبئة الكيماوية التي تضرب في حياتنا اليوم القيمة الفعّالة ذاتها التي قد تمتلكها أزمات البشر من حروب وتهجير واعتقال وترهيب وتطرّف ديني أو عرقي، فالقرارات الكبيرة لا تتخذ إلا إذا كان في الأمر جدوى وفائدة لقوى تلك الأنظمة السياسية التي تحكم حياتنا، وإلّا ما تبرير هذا التمييز بين موت بطيء بسبب فيروس، وآخر ناتج عن قصف كيميائي أو غرق قوارب مطاطية لمهاجرين في طريق البحث عن حياة آمنة؟ إنّها القراءة الأكثر عبثيةً لأقدارنا في هذا العالم الموبوء بالأنانية والعنصرية والكذب؛ في مواجهة الانتباه المتأخر إلى انهيار مجتمعاتنا أمامنا ونحن نكتب مآسينا هنا وهناك من دون جدوى.