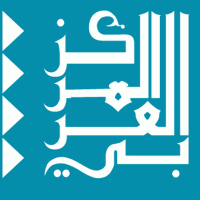الأزمة السياسية/ الدستورية في تونس .. حيثيات وآفاق
الأزمة السياسية/ الدستورية في تونس .. حيثياتها وآفاقها
قوات أمن تونسية تحاول منع تجمع متظاهرين في العاصمة (6/2/2021/الأناضول)
خلال الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي، في 18 نيسان/ أبريل 2021، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، نفسه قائدًا أعلى للقوات المسلحة المدنية (الشرطة، والحرس الوطني، والجمارك)، إضافة إلى صفته الدستورية قائدًا أعلى للقوات المسلحة العسكرية. ويأتي هذا الإعلان في سياق تجاذباتٍ بدأت قبل نحو عام حول الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية من جهة، ورئاستَي الحكومة والبرلمان من جهة ثانية، وأدّت إلى تعطيل أداء الفريق الحكومي الجديد اليمين الدستورية، وتأجيل النظر في تشكيل المحكمة الدستورية، ورواج مخاوف حول النزوع إلى الحكم الفردي، والانزلاق إلى أوضاع مماثلة لما جرى في بلدان عربية أخرى.
تأويلات الرئيس
انطلقت التجاذبات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان إثر انتخابات عام 2019. ففي أيار/ مايو 2020، هنّأ رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بمناسبة استرجاع قاعدة الوطية الجوية من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. فأثارت هذه التهنئة حفيظة الرئيس سعيّد الذي ردّ على الغنوشي بالقول إن "لتونس رئيس وحيد"، وأعقبها تحرّكٌ منسق للكتل البرلمانية الداعمة لسعيّد لسحب الثقة من رئيس البرلمان، غير أنها لم تتمكّن من تأمين العدد المطلوب لذلك.
تصاعدت التجاذبات مع اندلاع أزمة استقالة حكومة الفخفاخ الذي رشّحه رئيس الدولة لرئاسة الحكومة، على إثر اتهامه بالتورّط في ملفات فساد وتضارب مصالح
تصاعدت التجاذبات بين الطرفين أكثر، مع اندلاع أزمة استقالة حكومة إلياس الفخفاخ الذي رشّحه رئيس الدولة لرئاسة الحكومة، على إثر اتهامه بالتورّط في ملفات فساد وتضارب مصالح، فقد استبق الرئيس سعيّد جلسة سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأعلن قبول استقالة الفخفاخ ليضمن إعادة العهدة إليه، ويسمّي رئيسَ حكومة جديدًا ويتفادى تكليف حركة النهضة؛ بصفتها الحزب صاحب الكتلة الأكبر في البرلمان، كما ينص على ذلك الدستور. وعلى الرغم من أن هذه المناورة ضمنت لسعيّد اختيار هشام المشيشي رئيسًا للحكومة الجديدة، بعد رحيل حكومة الفخفاخ، فإنه سرعان ما تراجع عن موقفه، طالبًا عدم منح الفريق الحكومي الجديد الثقة؛ على خلفية ما اعتبره تمردًا مبكرًا من المشيشي الذي تمسّك بصلاحياته الدستورية التي تمنحه حق اختيار فريقه الحكومي، وعدم الاكتفاء بدور رئيس وزراء لدى الرئيس سعيّد. وكان من الواضح أنّ الرئيس يسعى إلى تثبيت نظام رئاسي في تونس، يكون فيه رئيس الحكومة خاضعًا للرئيس، وليس للبرلمان. وعلى الرغم من هذا التجاذب، قبل المشيشي قائمة من الوزراء المحسوبين على الرئيس سعيّد، بينهم وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والثقافة.
ولم تمض سوى ثلاثة أشهر من عمر حكومة المشيشي، حتى عمد الأخير إلى إجراء تعديل وزاري، أُعفي، بمقتضاه، الوزراء المحسوبون على الرئيس سعيّد، وفي مقدمتهم وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي أشرف على الحملة الانتخابية لسعيّد في ولاية سوسة. وكان الرئيس قام، قبل ذلك بأيام، بزيارة ليلية إلى مقرّ وزارة الداخلية، في غياب رئيس الحكومة، أعقبها إعفاء عشرات من كبار المسؤولين الأمنيين، واستبدالهم بآخرين محسوبين على سعيّد، الأمر الذي اعتبره رئيس الحكومة المشيشي تعدّيًا على صلاحياته، وردّ عليه بإبطال التعيينات الجديدة، وإعادة المسؤولين المعفيين إلى مهماتهم.
فتح التعديل الوزاري جبهة نزاع جديدة بين رئيسي الحكومة والبرلمان، من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة ثانية
فتح التعديل الوزاري جبهة نزاع جديدة بين رئيسي الحكومة والبرلمان، من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة ثانية، فبعد أن منح البرلمان الفريق الحكومي الجديد الثقة، رفض الرئيس دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه، بدعوى أنّ بعضهم تلاحقه شبهات فساد. وعلى الرغم من أنّ المشيشي راسل سعيّد طالبًا أسماء الوزراء المشمولين بشبهات الفساد، فإنّ الرئيس رفض تحديدهم، وتوجّه إلى رئيس الحكومة برسالة لوم شديدة اللهجة، أكد فيها أنّ منح الثقة من البرلمان قانون داخلي غير ملزم، وأنّ أداء اليمين ليس إجراء شكليًا، بل عمل "يحاسب عليه يوم الحساب حين يقف بين يديه سبحانه وتعالى"، مشبّهًا اليمين بـ "المرور على الصراط"، ومتّهمًا الحكومة والكتلة البرلمانية المساندة لها بالسعي لضمان مرور الفريق الحكومي "زقفونة"، في إحالة إلى كتاب "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري.
وتواصل الشد والجذب بين رئيس الجمهورية والحكومة وكتلتها البرلمانية، بعد أن صدّق البرلمان على تعديل قانون انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ليصبح بأغلبية 3/5 بدلًا من ¾، فقد رفض سعيّد، مرة أخرى، التصديق على التعديل، ووجّه رسالة مطولة في الغرض إلى رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، حمّلها إحالاتٍ لغويةً وشعريةً وفقهية، معتبرًا أنّ التعديل "غير علمي بل غير بريء". وبعد أيام قليلة من رفض التصديق على القانون المعدّل للمحكمة الدستورية، فاجأ سعيّد الحاضرين في عيد قوات الأمن الداخلي، وبينهم رئيسَا البرلمان والحكومة، بتأويلٍ دستوري جديد، أعلن، بمقتضاه، نفسه قائدًا أعلى للقوات المسلحة المدنية (الشرطة، والحرس الوطني، والجمارك)، هذا إضافة إلى صفته الدستورية قائدًا أعلى للقوات المسلحة العسكرية، معتبرًا أنّ الدستور لم يفصّل في تبعية قوات الأمن الداخلي، وأنّ وصف "القوات المسلحة" ورد في صيغة التعميم، وهو ما يسحبه على قوات الأمن الداخلي، إضافة إلى الجيش، ويلحق قيادتها برئيس الجمهورية. وهو تفسير غير مسبوق لمعنى عبارة القوات المسلحة.
ردود الأفعال: تباين وحسابات
بعد أن أعلن الرئيس قيس سعيّد نفسه قائدًا أعلى لقوات الأمن الداخلي، بلغت الأزمة مرحلةً جديدة. وعلى الرغم من أنّ هذا الإعلان لم يكن التأويل الدستوري الوحيد الذي ذهب إليه سعيّد في نزاعه مع رئيسَي البرلمان والحكومة، فإنّ الحدّة التي قوبل بها موقفه تنبئ بأنّ الأزمة قد تكون بلغت نقطة اللاعودة؛ إذ، أول مرة، يوجِّه الغنوشي والمشيشي ردودًا مباشرة إلى سعيّد يتهمانه فيها بخرق الدستور، والسعي إلى الانفراد بالسلطة، ويحمّلانه مسؤولية حالة الشلل السياسي والمؤسساتي في تونس، بعدما ظلّا، طوال الأشهر الأخيرة، يلتزمان خطاب المناشدة الذي يغلّب الدور التجميعي للرئيس، فقد وصف رئيس الحكومة هشام المشيشي تصريحات سعيّد بخصوص القيادة العليا لقوات الأمن الداخلي بأنها "خارج السياق"، وأنها "قراءة فردية وشاذّة للنص الدستوري، لا موجب لها"، في حين عبّرت حركة النهضة عن استغرابها من "عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتباره وثيقةً ملغاةً لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي"، معتبرة إعلان نفسه قائدًا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح "دوسًا على الدستور وتعدّيًا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة"، مؤكّدةً أنّ "إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدًا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة"، ومبديةً "رفضها المنزع التسلطي لرئيس الدولة"، وداعيةً إياه إلى "الالتزام الجادّ بالدستور والتوقف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها". أما حزب قلب تونس، أحد مكونات الحزام البرلماني للحكومة، فقد طالب رئيس الحكومة "بأن يأخذ كل صلاحياته، ويحكم، ويخاطب الشعب".
بعد أن أعلن الرئيس سعيد نفسه قائدًا أعلى لقوات الأمن الداخلي، بلغت الأزمة مرحلةً جديدة
وقد راهن قيس سعيّد الذي ليس له حزبٌ ممثَّل في البرلمان على ميل المعارضة البرلمانية إلى مناكفة الائتلاف الحكومي، من دون أن تأخذ في الاعتبار دوافع الرئيس وأهدافه. وقد ذهب بعضها، في بعض الحالات، إلى تفضيل الموقف المعارض، انطلاقًا من مسؤولية الحفاظ على الديمقراطية. وعلى مستوى هذه المعارضة، حاول حزب التيار الديمقراطي أن يتبنّى موقفًا وسطيًا؛ إذ أكد أمينه العام، غازي الشواشي، أنّ حزبه "لا يشارك رئيس الجمهورية الذي يعتبر نفسه قائدًا للجيش والقوات الأمنية المسلحة"، مضيفًا أنّ "الأمن الداخلي من صلاحيات رئيس الحكومة"، لكنه أكد، في الوقت نفسه، أنّ ما فعله الرئيس لا يعدّ انقلابًا، كما وصفته حركة النهضة، وأنّ الحل يكمن "في رحيل الحكومة وتعويضها بحكومة إنقاذ وطني حاملة لمشروع، مع إبعاد رئيس البرلمان الذي يعتبر جزءًا من المشكل". أما حركة الشعب فقد ساندت الرئيس سعيّد في ما ذهب إليه، وعدّته "الضامن لتطبيق الدستور والحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها، ومن حقه قراءة الدستور حتى في ظل وجود المحكمة الدستورية"، وأنه "القائد العام للقوات المسلحة العسكرية والمدنية، وهو رئيس مجلس الأمن القومي، ولا ينازعه أحد في هذا الاختصاص"، وأنّ "حكومة المشيشي عاجزة وفاشلة".
تأويل الأزمة: دستورية أم سياسية؟
دأب الرئيس قيس سعيّد، منذ بداية نزاعه مع رئيس البرلمان ثم رئيس الحكومة، على البحث عن تأويلاتٍ دستوريةٍ وقانونية، ليسند موقفه ويظهر في صورة المعلّم الذي يلقي إرشاداتٍ ودروسًا ومواعظَ يعمد، في أحيان كثيرة، إلى توشيتها بضروبٍ من البلاغة والشعر والمأثورات الخالية من الخطاب السياسي المسؤول.
راهن قيس سعيّد الذي ليس له حزبٌ ممثَّل في البرلمان على ميل المعارضة البرلمانية إلى مناكفة الائتلاف الحكومي
وعلى الرغم من أنّ الخلاف الحالي بين مؤسسات الحكم في تونس ليس الأوّل من نوعه، إذ سبق أن شهدت العلاقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة جفاءً وتوترًا في السنتين الأخيرتين من عهد الرئيس الراحل، الباجي قائد السبسي، وذلك في أثناء تولّي يوسف الشاهد رئاسة الحكومة، فإنّ الأمر لم يبلغ مرحلة القطيعة وتعطيل أجهزة الدولة، والتزم الطرفان، في نهاية المطاف، الصلاحيات التي حدّدها الدستور لكليهما. وعلى الرغم من أنّ الرئيس السبسي استغل خبرته الطويلة بشؤون الدولة وضعف تجربة الشاهد السياسية والإدارية لينتزع بعض الصلاحيات، فإنه تراجع، حين أبدى الشاهد مقاومة لذلك.
أما الرئيس سعيّد فلا يخفي رفضه الصيغة الدستورية الحالية التي توزّع السلطات بين المؤسسات الثلاث؛ الرئاسة والحكومة والبرلمان، كما لا يخفي رغبته في إقامة نظام رئاسي يمسك فيه الرئيس بكل الصلاحيات التنفيذية، ويتراجع دور البرلمان، ويتحول رئيس الحكومة إلى وزير أوّل يقتصر دوره على تنفيذ سياسة الرئيس. ومع أن الديمقراطية البرلمانية هي روح دستور 2014، فإنّ هذا الدستور ترك مناطق تماسّ تثير غموضًا والتباسًا بين صلاحيات الرئاسات الثلاث، لكنه، في الآن ذاته، يمنع أيّ طرفٍ من الانفراد بالحكم، ويقطع الطريق على عودة الحكم الاستبدادي.
لا يخفي قيس سعيد رغبته في إقامة نظام رئاسي يمسك فيه الرئيس بكل الصلاحيات التنفيذية
وتزيد العراقيل أمام محاولات إرساء المحكمة الدستورية من اللغط بين الرئيس سعيّد وخصومه بشأن مسألة الصلاحيات، فالمحكمة الدستورية، من حيث المبدأ، هي المؤهلة لتأويل النصوص الدستورية، والبتّ في مثل هذه الخلافات، على نحوٍ يجعل تشكيلها، في مثل هذا الظرف، أولوية ملحّة. وفي الآن ذاته، تدفع خطوات سعيّد في إدارة الخلاف مع خصومه في الحكومة والبرلمان إلى الاعتقاد بأنّ الخلاف يتجاوز التأويلات الدستورية النصّية. فأول مرة، منذ الاستقلال، يعمد رئيس الجمهورية إلى إلقاء خطابات سياسية متشنجة في ثكنات الجيش ومقارّ الفرق الأمنية، يصف فيها خصومه بأبشع النعوت، ويتوعدهم بالعقاب، ويحرّض عليهم. وهذا مؤشّر على الرغبة في الاستقواء بالقوات الحاملة للسلاح، وإقحامها في المشهد السياسي الذي ظلّت تنأى بنفسها عنه، منذ الثورة. ولا يناقض هذا النهج الديمقراطية البرلمانية بل الرئاسية أيضًا، فالديمقراطية عمومًا تتعارض مع زجّ القوات المسلحة وأجهزة الأمن في السياسة.
آفاق الأزمة
تتراكم جملة مؤشرات توحي بأنّ الأزمة السياسية التي تمر بها تونس تتجه نحو مزيد من التعقيد، فحتى الدعوة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إجراء حوار وطني (تشبه المبادرة التي أطلقها عام 2013، وأدّت إلى انسحاب حكومة الترويكا وتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة مهدي جمعة)، يبدو أنّ حظوظها تراجعت، ولم تعد تلقى الحماس الذي قوبلت به في البداية، فالرئيس سعيّد يبدو متمسكًا بتأويلاته للدستور التي لا تشاركه فيها الغالبية الساحقة من الخبراء الدستوريين وأساتذة القانون، ومصرًّا على رفض الحوار مع من يصفهم بـ "الفاسدين والمنافقين والمتآمرين وأصحاب الغرف المظلمة وذوي النفوس المريضة"؛ في إشارة إلى الكتلة البرلمانية الداعمة للحكومة، والمؤلفة من أحزاب النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة أساسًا. كما يبدو غير مهتمٍ بأيّ حل لتجاوز الشلل الحكومي الناتج من رفض استقبال الوزراء الجدد ليؤدّوا القسم، في حين ترتفع أعداد المصابين بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية، وتتجه الحكومة إلى إجراء مفاوضات جديدة وصعبة مع صندوق النقد الدولي؛ بحثًا عن اعتمادات للميزانية المستنزفة. ويبدو أنّ سعيّد يعوّل على عامل الزمن، لزيادة الضغط على الحكومة وكتلتها البرلمانية ووضعها أمام تحدّيات اجتماعية وأمنية لا قِبلَ لها بمواجهتها. في المقابل، لا تبدو حركة النهضة، وباقي مكونات الحزام البرلماني للحكومة، في وارد التسليم لسعيّد بما يريد، خصوصا بعد مواقفها المعلَنة. أخيرًا، يبدو رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مطمئنًا إلى تماسك الكتلة البرلمانية التي تدعمه، وإلى قدرته على تقليص رغبات الرئيس في السيطرة على أجهزة الأمن وتوجيهها.
لا الرئيس قادر على حلّ البرلمان من دون محكمة دستورية، ولا البرلمان قادر على عزل الرئيس من دون دعم المحكمة التي لم تشكّل بعد
وفي الآن ذاته، يبقى احتمال انتصار طرف على آخر، أي حلّ البرلمان أو عزل الرئيس، بعيدًا، وبلا سند دستوري، خصوصا في غياب المحكمة الدستورية، فلا الرئيس قادر على حلّ البرلمان من دون محكمة دستورية، ولا البرلمان قادر على عزل الرئيس من دون دعم المحكمة التي لم تشكّل بعد.
ويظل الرهان على تغييرات تنسف التجربة برمّتها على غرار ما حدث في بلدان عربية أخرى مستبعدًا، على الرغم من إشارات واردة في هذا الخصوص على إثر الزيارة التي قام بها الرئيس سعيّد إلى مصر، ودامت ثلاثة أيام من دون أن يوقّع أي اتفاقيات اقتصادية أو سياسية معلَنة، واكتفى خلالها بالإشادة بالتجربة المصرية والأدوار التي أدّاها الجيش المصري. ويدفع سجلّ الجيش التونسي البعيد عن التجاذبات السياسية، والتغييرات التي شهدتها المؤسسة الأمنية منذ الثورة إلى استبعاد انحيازهما إلى أيّ طرف من أطراف النزاع الحالي.
خاتمة
بعد أكثر من سنة من التجاذبات بين الرئيس من جهة، ورئيسي البرلمان والحكومة من جهة ثانية، بلغ المشهد السياسي في تونس مرحلة من الانسداد غير المسبوق. وعلى الرغم من لجوء سعيّد إلى إطلاق تأويلات للدستور تدعم موقفه، فإنّ جوهر الأزمة يتعلق، أساسًا، برفضه النظام السياسي الذي يوزّع السلطات بين الرئاسات الثلاث، ورغبته في توسيع صلاحياته لتشمل مجالات ظلت من اختصاص الحكومة والبرلمان. وأصبحت تصريحاته الأخيرة تتجاوز الرغبة في توسيع الصلاحيات. وتكمن خطورة هذه المحاولات في أنها تذهب إلى أبعد مما يحتمل وضْع الديمقراطية التونسية الناشئة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والصحية والاجتماعية الصعبة التي تمرّ بها البلاد. لذلك ينبغي للنخب السياسية التونسية أن تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، حتى لا تضيع الإنجازات التي تحققت خلال العقد الماضي، وأن تجد آلية مؤسسية دستورية لتدير خلافاتها بعيدًا عن التشنج والشعبوية والمزايدات الكلامية.