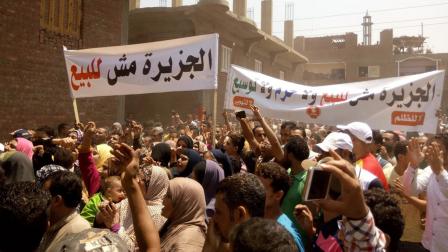نحن جيل المتفرجين
أنا في برلين الآن. لم تكلفني الرحلة إلا بعض الوقت وبعض النقود. عمليًا، لم أتحمل عناء البحر والتجربة الخطرة والمغامرة. حملتني طائرة حديثة الصنع من مطار "رفيق الحريري" في بيروت إلى مطار "شونيفيلد" في برلين. بجواز سفر سوري حمل تأشيرة غادرت سورية إلى ألمانيا الاتحادية لحضور مهرجان برلين السينمائي.
حين هبطت الطائرة في المطار المذكور، بعد رحلة استمرت ما يقارب ثلاث ساعات، تغيّر كل شيء. أنا في ألمانيا. وقفت في الصف وتمسّكت صبية تركية الأصل بي لأنني وعدتها بأنني سأرشدها إلى الطريق. نعم هكذا وعدتها. شعرت أن ألمانيا ملك لي. فتجرّأت على طرقاتها وعناوينها. حين جاء دوري عند الموظف تذكرت: "يا إلهي! إنكليزيتي الجيدة نسبيًا لن تساعدني، الألمان يتحدثون الإنكليزية بلهجة ألمانية". هذا كان كارثيًا بالنسبة لي. سألني بإنكليزيته الألمانية: "هل حجزت للعودة؟".
أجبته بإنكليزيتي العربية: "نعم". فطلب مني بطاقة العودة. بحثت عنها في المحفظة وفي جيوبي وعلى بريدي الإلكتروني. اعتذرت بسبب تأخري، وأخذت ركنًا بعيدًا نسبيًا لأبحث وأبحث. انهار الحلم، وبدأت أتصبب عرقًا. كنت على وشك الاعتراف. جهزت الجملة بالإنكليزية لنطقها: "سيدي، أنا هنا لأستقر في بلدكم، سأقدم طلبًا للجوء، وأحاول إتمام دراستي في المسرح". لم أكد أستجمع قواي، حتى ناداني من مكتبه، ختم جوازي وقال: bye bye.
تأكدت أن الحلم قد انتهى، إلا أنه كان يقصد أن أدخل إلى المطار، كأنه يقول: "أهلاً بك". يا لتعاسة اللغة، تغير كل شيء بسببها، شتمتها آلاف المرات، بكل البذاءات حتى وصلت إلى حقيبتي. فاجأني لحظتها المطار بصغره، فاجأتني الشوارع ببساطتها، كنت أمشي واثقًا من نفسي مع صديقي ونسيبي الذي يقودني إلى منزله، كل شيء كان يحدث بهدوء تام. ربما أنا ابن الصخب، عمليًا أنا ابن حلب، المدينة الصاخبة، وناجٍ من الحرب وضجيجها، كان الهدوء القاتل أعجوبة بالنسبة لي.
سيطر الصمت طويلًا علي، استمعت لنسيبي كثيرًا، شرح لي كل شيء تقريبًا في القطار الذي يقودنا إلى منزله - لا شيء يبدو غريبًا. لم أدر لم شعرت بود يربطني ببوتسدام منذ زمن. لا أدري لمَ، لكن هذا ما حدث. لم تكن الأماكن غريبة عني، سألت بعفوية عن مبنى ضخم أمام منزل نسيبي. أجابني بهدوء وبساطة: "هذه مدرسة غوته". يا إلهي، هل سأتعامل مع غوته بهذه البساطة بعد مضي أربع سنوات؟ هل سيصبح غوته ونيتشه وبريشت وباخ أمورًا يومية عادية، تمر مع فنجان قهوة وكأس نبيذ؟
زرت مهرجان برلين السينمائي قليلًا، إلا أنني ومن جديد تجرأت على شوارع ألمانيا وعناوينها. هبطت إلى برلين وحيدًا من دون دليل أو مرشد أو مساعد. تجولت كثيرًا باحثًا عن مسرح "الشيفبوردم"، مؤسسة "البيرلينالي إنسامبل" كما يناديها الألمان هنا، مسرح بيرتولد بريشت.
حقيقة درست بريشت في المعهد العالي للفنون المسرحية وقرأت عنه وله ما تيسّر لي/ إلا أنني في زيارتي مسرحه راودتني مشاعر متناقضة، الأولى تشبه تلك التي تراود المسلمين في موسم الحج عند زيارة قبر الرسول أو الكعبة أو الحرم. والثانية استياء عظيم، إثر رؤيتي تقنيات الباركود والفيزا كارد وما إلى ذلك داخل المبنى للتعامل والتواصل مع المؤسسة.
كنت مقتنعًا بالدور الذي لعبه بريشت؛ إذ آمن بكسر الاستلاب الجمعي، وإعلان المسرحة والتغريب والمسرح التعليمي، آمنت بدائرة الطباشير القوقازية وخسرت أصدقاء لأجلها، لطالما أحببت بريشت ودافعت وتحدثت عنه.
لا أدعي المعرفة الكاملة بمسرح بريشت، إلا أن ما عرفته كان يكفي لأحبه، ومحاولة تطبيق بعض تقنياته في ما عملت عليه في المسرح. أصابتني الدهشة من مشهد الأجهزة الحديثة في المبنى المترهل العتيق تماشيًا مع كتلة الأفكار السريعة عن بريشت، والتي مرت كشريط سينمائي بسرعة فائقة. لا بد أن لهم فلسفتهم عن الموضوع.
أنا كمسرحي سوري، وربما كغيري نتعامل مع الأشياء الغريبة كعبيد، ربما لافتقارنا إلى التراكم، وأنا في ذاك المكان فكرت في المتنبي كثيرًا، لو أننا امتلكنا المتنبي بشكل حقيقي، ربما حولناه إلى مصدر تمويل واستعضنا عن بعض آبار البترول وبعض الحروب.
المتنبي لنا ونفعل به ما نشاء، وبريشت لهم ليفعلوا به ما يشاؤون. ما دخلي أنا، أنا هنا متفرج مستلبٌ فحسب، تلاشى الاستلاب قليلاً حينما زرت "لايبزك" في اليوم التالي، فزيارتي كنيسة باخ كانت أكثر رقة، كانت موسيقاه حاضرة، تمثاله حاضر، حتى الشوارع كانت تخبرني أن باخ مر هنا. عمومًا كانت زيارة خاطفة وأنا لا أعرف باخ كثيرًا وموسيقاه ترعبني أحيانًا. إلا أنني سعدت، على الرغم من أنني في "لايبزك"، شاهدت ألمانًا يكرهون ألمانيا. شاهدت ألمانًا ليس لديهم بطاقات بنكية لرفضهم النظام العالمي. حدثوني كثيرًا بـ"إنكليزيتهم المؤلمنة" عن رفضهم ومقاطعتهم، أولئك يستطيعون دبّ الحماسة فيك بسرعة: "يا إلهي، سأهرب من "لايبزك" غدًا!".
أنا متفرج فحسب، لكن ما عناني هناك أن بعض مباني برلين ولايبزك ودريزدن ما زالت تعاني دمار الحرب العالمية الثانية. بحق، لم تغب عن ذهني صورة حلب بعد ستين عامًا. حسنًا بعد ستمائة عام. نحن لم نحتفظ حتى بتمثال للمتنبي، إلا أننا عبدنا قبر رجل غريب (مبروك) مر بشارع إسكندرون يومًا ما.
رسمت مفارقة عظيمة عندما دخلت إلى هانوفر. عنواني السريع لها (مدينة مؤمركة بنجاح). عرفت أو لمست جزءًا من ضخامة المجتمع الذي سأكون جزءًا منه وقبلت التحدي. ربما أموت هنا يومًا ما أو أغيب بشكل ما. لكن، مبدئيًا، هذا مجتمع يستحق الاكتشاف. وللمفارقة أحببت اللغة الألمانية عندما سمعتها، وقعها مثير للاهتمام، ونسيبي يحبها، وقد أحببته أو أحببت طرائقه في العيش.
انتهت هذه السياحة مع انتهاء تأشيرتي وتقديمي طلب اللجوء، منذ عشرين يومًا وأنا حبيس أوراق فقط، لا وقت للمسرح الآن؛ إنه وقت البيروقراطية الممتعة، لا وقت للاكتشاف الآن؛ فقصص السوريين المتنوعة المترامية على قارعة التاريخ هي التي تسحق الاستماع. سينتهي هذا الألم بالنسبة لي ولهم يومًا ما، وسنفهم أننا متفرجون في مجتمع متماسك بقوة، أدرك يومًا ما أن الحروب أدوات للقفز إلى الأمام بسرعة.
حاليًا لدي صديقة ألمانية وصديق ألماني، وآلاف السوريين البسطاء يشحذون الترجمة من أي ناطق بلغة غريبة، إلى جانب كتلة أوراق توازي كل ما درسته على مدار عشرين سنة.