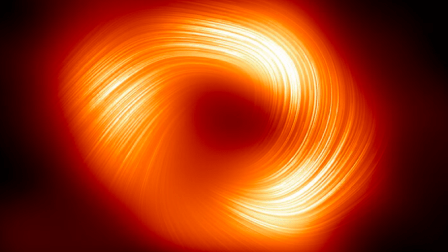قتيبة الجنابي: "المنفى صار جزءاً من الثقافة العراقية"
لم يتجاوز العراقي قتيبة الجنابي (بغداد، 1956) الـ18 عامًا من عمره عندما بدأ ممارسة التصوير الفوتوغرافي. لكن ذلك لم ينسه عشقه الأول للسينما، التي بدأها بتحقيق أفلامٍ قصيرة، كان يراها تمرينًا لا بُدّ منه قبل خوض تجربته الأولى في الفيلم الروائي الطويل، وهو "الرحيل من بغداد"، الذي نال اهتمامًا نقديًا يستحقه.
غادر إلى هنغاريا هربًا من النظام الديكتاتوري، وتخرّج من "معهد السينما" في بودابست. أقام معارض فوتوغرافية في بودابست وبيروت ولندن، وأصدر كتابًا فوتوغرافيًا بعنوان "بعيدًا عن بغداد". حقّق "الرحيل من بغداد" و"قصص العابرين" و"القطار" و"حياة ساكنة" و"المراسل البغدادي" و"أرض الخراب" و"عكس الضوء" و"الأرض الحرام".
في هذا الحوار مع السينمائيّ العراقي قتيبة الجنابي، كلامٌ عن العراق والمنفى وعشق السينما وتجربة العمل مع الكاميرا، الممتدّة على أكثـر من 3 عقود.
(*) نبدأ من "قصص العابرين"، فيلمك الاخير: توثيق 40 عامًا من الترحال والمنفى، وأيضًا سيرتك كمخرج عاش تجربة المنفى هذه الأعوام كلّها.
ـ في "قصص العابرين"، كنت أصوِّر فوتوغرافيًا بعين، وبالعين الثانية أصوِّر سينمائيًا. لم تخرج أفلامي عن موضوع المنفى. منذ نحو 40 عامًا، أصوّر هذا في محاولة لتحويل المأساة الى مساحة إبداعية شديدة الخصوصية، وإلى قوّة دافعة إلى الأمام. أردتُ تدوين المنافي والأيام فوتوغرافيًا وسينمائيًا، مازجًا أحاسيس إنسانية مشتركة بين كلّ من تعرّض لفقدان أحبّة، وللابتعاد قهرًا عن المكان الأول. بدأتُ العمل به قبل 40 عامًا كمشروع ذاتي، بتمويل ذاتي أيضًا، منذ اللقطة الأولى.
أبطال الفيلم يعكسون شخصية واحدة وخوفًا واحدًا، ويعانون "صوت المذياع"، هذا الجهاز الذي أخذ الكثير من حياة العراقيين. هذه ليست شخصية المخرج، بل الإنسان الذي يُقْلَع من جذوره، ويدخل متاهات المنفى والغربة والبحث عن حدود الوطن. تضمّن الفيلم أيضًا عرضًا لصُوَر فوتوغرافية في أمكنة وأزمنة مختلفة، ترسم حدود المنفى وتشير إليه. صُوَر ترتبط مواضيعاها بشروط المنفى وعسفه، خلال هذه الأعوام كلّها.
(*) والمنفى أيضًا في "رحيل من بغداد". إلى أي مدى يحضر المنفى، بتفاصيله وهمومه وظلاله، في عملك الفني؟
ـ المنفى حالة مفروضة على أبناء جيلي، خاصة أولئك الذين تمرّدوا على وسائل الترهيب التي اتّبعها النظام الفاشي نهاية سبعينيات القرن المنصرم. لهذه الحالة تأثيراتها علينا بأشكال مختلفة. بالنسبة إليّ، تأقلمتُ معها جغرافيًا لا روحيًا، لأني لا أزال أتعاطى معها رغم معايشتي إياها أكثر من 3 عقود كأنها أمر طارئ، ووقتي سينتفي سريعًا حال انتفاء الظروف التي أدّت إلى المنفى. بقيتُ مشدودًا إلى جذوري، وكلّ ما صنعته فوتوغرافيًا أو سينمائيًا مرتبط عندي باللاانتماء واللامكان. كلّ ما مررت به وأبناء جيلي، من معاناة وآلام، في الأعوام الطويلة هذه، محض اختبار. لكنّي لا أتردّد عن القول إن المنفى صار جزءًا من الثقافة العراقية، وما يجعلني أتمكن منه، بمعنى أن أبدِّد شيئًا من معاناته وآلامه، كامنٌ في رصدي إياه كحالة يجب أن أتخطّاها.
كلُّ ما أنجزته في الفترة الماضية تلك، وكلُّ ما قدّمته ـ بصريًا، أي عبر التصوير الفوتوغرافي أو العمل السينمائي ـ هو سعيٌ إلى توثيق أعوام الهروب المستمرّ واللااستقرار.
(*) لكن، في فيلمك القصير "حياة ساكنة"، هناك العزلة أيضًا، بل الموضوع نفسه: هاجس الملاحقة والخوف من المجهول.
ـ هذا صحيح. في "حياة ساكنة"، حاولت أن أرصد أثر العيش في المنفى، وأجسّد الخوف من قدر يترصّدنا أنّى حللنا. حاولت أيضًا أن أصنع منه مشروعًا بصريًا: رجلٌ في مكان (هنا غرفة صغيرة) في إحدى بلدان الشتات يشعر أنه مرصودٌ من الآخر المتربّص به في الشارع أو المقهى أو الباص. ربما هو ليس إلا وجود شبحي أسكنه الخوف في رأس هذا المنفيّ. هذا الشعور توضّح أكثر في "الرحيل من بغداد"، ربما لأنه روائي طويل، يتيح هامشًا كبيرًا لإيضاح التفاصيل.
باختصار، إنها تجربة حياتية. تصوَّر أني لا أزال حتى هذه اللحظة أشعر أني مُلاحقٌ ومُراقبٌ. ربما خفّت حدّة هذا الإحساس مع سقوط الصنم، لكنه إحساس مترسبٌ في اللاوعي.
(*) بين الفوتوغرافيا والسينما، أين تجد متنفّسك؟ هل السينما وسيط أكثر تحرّرًا في ترجمة أفكارك؟
ـ عملي في السينما عودة إلى عشقي الأول، المجال الذي كان عليّ دخوله مهما تعدّدت الاهتمامات أو طال الزمن. لكن التصوير الفوتوغرافي المحطة الأهم قبل السينما. أنا لم أجْنِ من المجالين حتى هذه اللحظة ما يسد رمقي. لا أزال هاويًا، وأتكبد الكثير من أجل عشقي. أسعى دائمًا إلى العمل مع مخرجين كبار، لكن الفرصة لم تُتَح لي. بدأت بتحقيق الأفلام القصيرة، وخضت عملاً تلفزيونيًا كان له دورٌ مهمٌ في صقل خبرتي. عملت في الـ"أوبرا هاوس" أيضًا.
هذه أعمال كانت تمرينًا لي على أن أمتلك عملي الخاص الذي يحمل اسمي. تمنّيتُ كثيرًا خوض تجربة الفيلم الروائي الطويل، فكان "الرحيل من بغداد" التجربة الأولى لي في هذا المجال.
(*) فلنعد قليلاً إلى الوراء: كيف بدأت علاقتك بالكاميرا؟
ـ أنتمي إلى جيل هيمنت السينما على عالمه، إذْ كانت أحد أهم مجالات الترفيه العائلي. عشقتها منذ طفولتي. أغوتني عبر الفيلم بحدّ ذاته، وعبر قصّته وطريقة عرضه، كما عبر طقوس ارتياد الصالات. سكنتني بالكامل. كان طبيعيًا أن أسعى إلى دراستها أكاديميًا. لم يتسنّى لي ذلك بسبب الشروط التي فرضتها المؤسسة التعليمية امتثالاً لسياسة الحزب القائد، واشتراطها ان يكون القبول في كليات كهذه محكومًا بالولاء لإيديولوجية الحزب والنظام. تصوّر أنهم وضعوا شروطًا قاسية للقبول في تلك الكليات، التي تعتمد على الجانب الإبداعي في الفن والرياضة والأدب. ربما كانوا يهيِّئون جيلاً ينتظم في هذه المجالات ويكون ولاؤه للسلطة فقط؛ فهل نجحوا؟
اكتشفتُ أن من يريد الدخول إلى عالم الصُوَر المتحركة عليه أن يبدأ بالفوتوغراف، يعني الصورة الثابتة، وهذا ما فعلته. ممارسة التصوير الفوتوغرافي درّب عينيّ على انتقاء اللقطة المعبِّرة واستبطان حركتها ورصدها. هذا مهمّ، أعانني كثيرًا في عملي السينمائي لاحقًا. لم أتجاوز الـ18 عامًا من عمري عندما عملت في جريدة "طريق الشعب"، في سبعينيات القرن الماضي. كانت تجربة عظيمة بالنسبة إليّ، اكتسبت فيها خبرة مهمة في مجال التصوير، وأيضًا في تنامي وعيي وثقافتي بعملي مع مثقفي العراق العاملين فيها. ساهم هذا كثيرًا في صقل موهبتي، وتكريس عشقي للكاميرا. اضطررت بعدها الى مغادرة العراق تحت وطأة القمع، فكانت هنغاريا أول محطات الشتات. هناك، درستُ التصوير الفوتوغرافي أكاديميًا، وأقمتُ معارض عديدة. ثم جئتُ إلى بيروت، التي منحتني فرصة توثيق نضال المقاومة الفلسطينية، فأقمتُ معرضًا في بودابست عن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، أثار اهتمامًا كبيرًا. ثم أصدرتُ كتابًا مُصوَّرًا يلخّص تجربتي في هذا المجال. في بودابست أيضًا، انتسبتُ لاحقًا إلى "معهد السينما"، قبل انتقالي إلى لندن والاستقرار فيها، وممارسة العمل السينمائي.
(*) مع "الرحيل من بغداد"، غرّدت خارج سرب المخرجين العراقيين، الذين وثّقوا الكوارث السياسية والاجتماعية التي أعقبت حرب 2003. هذه "ثيمة" اهتمّ بها آخرون، وأنت كنت بمنأى عنها.
ـ بخصوص تلك الـ"ثيمة"ن هذا صحيح تمامًا. أتيحت لي فرصة مشاهدة أعمال كثيرة لمخرجين عراقيين، خاصة الشباب، وكان الموضوع المشترك بينهم التأكيد على قول ما حصل بعد عام 2003. بعضهم اعتمد التوثيق، بمعنى أن "الوثيقة" مهيمنة على أعماله على حساب الجانبين الفني والجمالي. أحد هؤلاء المخرجين اعتمد كلّيًا على لقطات وثائقية بثّتها الفضائيات من دون تدخّل واضح له في تمثّل هذه الوثيقة وإعادة إنتاجها جماليًا. آن الآوان لاختيار زوايا نظر جديدة للحدث العراقي. لذا، أزعم أن "الرحيل من بغداد" اعتمد هذا الجانب، إذْ تناولت الموضوع أو الحدث عبر استعراض الأسباب المؤدّية الى نتائج كارثية.