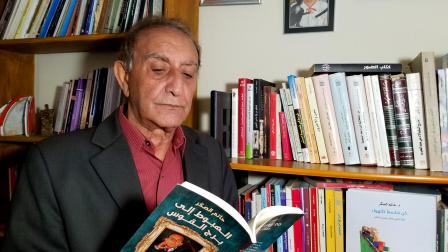محسن بوعزيزي: ورشة لبناء نصوص اجتماعية
كثيراً ما تجد العلوم الاجتماعية نفسها وقد فاجأها الواقع بما هو بعيد عن توقّعاتها وقدرتها على النمذجة، وهو ما ظهر بشكل جليّ مع الثورات العربية وما تلاها. من خلال أدوات من علم الاجتماع والسيميولوجيا، يحاول الباحث التونسي إضاءة هذا الوضع.
■ ضمن اختصاصك في علم الاجتماع، لديك اهتمام خاص باللغة التي جعلتَ منها مدخلك الأساسي لتناول مواضيع أبحاثك. لماذا هذا الخيار؟
- أهتمُّ خاصّة بالحياة الرمزية في الظواهر الاجتماعية، وبالتعبيرات الاحتجاجية في مختلف تجلّياتها، حتّى الصامتة منها، وأحاول أن أبني النصوص الاجتماعية من المجتمع. وأعتقد أنّ هذا كان هاجسي البحثي الأساسي. والذي جرّني إلى اللّغة هو علاقتي بالسيمياء بما لديها من قدرة على نسْجِ رمزيات حياتنا الاجتماعية. ولعلّك تلاحظ اليوم أنّ كلّ شيء تقريباً يتحوّل إلى علامة ورمز، ويتحوّل خاصّة إلى مشهد يجري إخراجه بعناية. حتّى الثورة التي نعيشها اليوم هي ثورة تنكشف الكثير من حقائقها في السيمياء، والغريب أنّها سيميائية يصعب بناء نسقيّتها لأن المعنى فيها لامتناهٍ، ويذهب في اتجاهات مختلفة؛ فلا تكاد تعثر له على حقيقة بعينها، ويبدو ذلك راجعاً إلى أنّها آتية من النّاس العاديين.
الثورات العربيّة ثورات سيميائيّة تجوّلت فيها العلامات هناك وهناك، فامتدّت لتطاول العديد من البلدان. خذ مثلاً الحملات الانتخابية الأخيرة في تونس، أكاد أجزم بأنّ أغلب التونسيّين لم يحلّلوا مضامينها وبرامجها بقدر ما تلقّوا مشاهد جرى إخراجها. الرئيس قيس سعيّد مثلاً كان عند التونسي نصّاً سيميائيّاً بامتياز من جهة جرسيّة صوته وتجلّيه الحاسم الذي يوحي بالثقة والصرامة والانضباط و"النظافة"، مع أنّه لا يكاد يقول شيئاً تقريباً، باستثناء شعار "الشعب يريد". الفاعلون الجدد اليوم يأخذونك من فلسفة الكائن إلى ثقافة المظهر والتجلّي، فلا يكاد الواحد منهم يقول شيئاً مع أنّه مؤثّر وتلك هي المفارقة.
السلفيون من الشباب غالباً ما لا يقرأون، ولا يعطونك مضامين بقدر ما يحيلونك إلى تجلٍّ خاص، تمظهُر خاص، ومنه السمة التي تَظهر على الجبهة، اللّباس على الطريقة الأفغانية، النقاب، إلى آخره... كلّ هذه لغات نحتاج إلى بناء نصيّاتها ونسج شبكاتها الرمزية. وكما تلاحظ فإنّي لا أكتفي بطبقات الرموز، بل أحاول ربطها بطبقات اجتماعية وسياقات وظروف وأوضاع. أنا مشدود كثيراً إلى رولان بارت وإلى جان بودريار، ويُضاف إليهما بيير بورديو الذي يبدو لي أنّ أهم مساهماته كانت في إشكالية العلاقة بين اللغة والرمز.
المشكلة في التقاط الرموز والقدرة على صيد العلامة، لأنّ ذلك يتطلّب قراءة من درجة ثانية وحتّى ثالثة. وهذا بدا لي قليلاً في البحوث الإنسانية والاجتماعية العربية التي تنساق وراء الحدث أكثر من تأويله.
■ ما الذي يُفسّر تناسي مسألة اللغة في العلوم الاجتماعية العربية؟
عوامل كثيرة، منها ارتهان الكثير من علماء الاجتماع العرب إلى المعرفة الموضوعية التي تشيّئ ظواهرها وتجعلها قابلة للقياس. وهنا تتحوّل الحياة الاجتماعية بضجيجها وتناقضاتها وبما لا تعلن عنه خاصّة من خفايا كامنة في الرمزي وفي النّفسي، تتحوّل إلى أرقام، فتضيع أشياء كثيرة من بين شقوق هذه الأرقام. وما ضاع قد يكون أهمّ بكثير ممّا قد جرى تكميمه. وكان يمكن ألّا نترك الواقع يباغتنا لو تنبّهنا إلى صمت النّاس ولامبالاتهم أحياناً وتعبيراتهم وأهازيجهم، وانسحابهم من المشاركة في الشأن العام، ولو انتبهنا إلى زلّات ألسنتهم ونكاتهم وصمتهم، ولو انتبهنا إلى ما هو استثنائيّ وعارض لما باغتتنا الثورة ولانتبهنا إليها وتوقّعناها.
كلّ هذا يتطلّب مقاربات مختلفة للواقع بعلم جديد يُسمّى علم المخصوص يتحسّس الجزئي والهامشي، وينتبه إلى الفريد، غير المتكرّر. ويحاول الإمساك بالعابر قبل أن يعبر. وعليّ أن أنبّه هنا إلى أنّ حقل اللغة ممتدّ جدّاً، ويمكن أن يشمل كلّ مظاهر الحياة الاجتماعية. هذه المقاربة للواقع تتطلّب تضافر اختصاصات تساند عالم الاجتماع، أوّلها السيمياء، في رأيي، واللسانيات، والفلسفة، والإثنولوجيا، والتاريخ أيضاً، لأنّ العلامة تأتي من التاريخ والرمزُ يتكوّن فيه.
■ هناك خيار آخر بارز في أعمالك وهو جعلك من الشارع حقل بحوثك، كيف تَبلور هذا التوجّه؟
- أظنّ أن اختيار الشارع مجالاً للبحث منذ أواسط الثمانينيات كان خياراً مشروعاً، فقد كانت الثورات العربية ثورات شوارع وساحات عامّة. انظر ماذا يحدث اليوم في الشارعَين العراقي واللبناني. كلّ شيء تقريباً يُقال ويُحسم في الشوارع. وانظر ماذا حدث ولا يزال في الساحات العامّة التونسية، ساحة محمد علي الحامي تمثّل أهمّ فضاء احتجاج في تونس. ما حدث في الساحات العامّة قلَبَ موازين القوى في تونس وأسقط نظاماً سياسيّاً.
لقد نقلت سيميائيّةً رائعة إلى العالم العربي، وإلى العالم بأسره، وبإخراج نادر غيّر الواقع العربي ولا يزال يغيّره. أوَليس الشّارع، إذن، فاعلاً اجتماعياً حقيقياً؟ لذلك كان مُراقباً ومنتهَكاً بأشكال مختلفة، حتّى أن الكثير من هذه الساحات التي كان يلتقي فيها النّاس جرى القضاء عليها وخنقها بوسائل النّقل خوفاً منهاً ومن قدرتها على خلق الاحتجاج والتفاعل والغضب.
الأنظمة السياسيّة تعرف خطورة الساحات العامّة لذلك تحاصرها. ثمّ أوَلم تنشأ الفلسفة منذ أرسطو في الساحات العامّة، في الأغورا اليونانية؟ لذلك جعلتُ، ومنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من الشارع ميدان بحثي الأساسي. الشارع كفضاء لإنتاج المعنى، كجغرافيا اجتماعية، كسيمياء، وكنصوص معلّقة مساحياً ودلالياً نمر بها دون التوقّف عندها. تعاملتُ مع الشارع كنص اجتماعي وسيميائي، وكان ذلك موضوع أطروحتي.
وأذكر أنه في مناقشتها وجّه لي عالم الاجتماع التونسي عبد الباقي الهرماسي سؤالاً مفاده: لماذا لم تتعامل مع الشارع كفضاء أنثروبولوجي؟ أربكني حينها بهذا السؤال، ولكنّي الآن أرى صواب خياري، لأنّ الرمزي هو الذي يحكمنا ويفعل فينا ويوجّه خياراتنا. كيف يمكن أن نقرأ الشارع التونسي، أي كيف نفهمه؟ ومدخلنا للفهم هو التعبير بما هو فضاء أوسع حتى من اللّغة، حيث يتضمّن الصمت والانسحاب واللاّمبالاة والعنف.
أعتبر نفسي متسكّعاً، بالمعنى المعرفي، في الشارع. وهكذا ينبغي أن يكون الباحث في علم الاجتماع، متسكّعاً بين الدلالات، بحثاً عن العلامة في حقول الصدفة. ليس بالضرورة من أجل مسألة بعينها تشغله، بل من أجل التقاط ما يدور في الواقع وتفكيكه ثم إعادة بنائه. ضمن هذا التسكّع المعرفي، حدث كثيراً أن امتطيتُ تاكسي دون أن تكون لي أي وجهة، كنت فقط أستدرج السائقين للحديث في شتى الأمور، في السياسة والرياضة والبرامج التلفزية، ومن هذه المعاينات البسيطة يبدأ بناء الانشغالات العلمية. وأظّن أنني قد فهمت بعض خفايا المدينة الخليجية بالطريقة نفسها، حين كوّنت علاقات اجتماعية مع سائقي تاكسي كشفوا لي الكثير.
لقد كان اهتمامي بالشارع وبالساحات العامّة مبكّراً، وها إنّي أرى اليوم مجموعات علمية تتشّكل في الغرب، في فرنسا مثلاً، ليبنوا نصوصاً اجتماعية من المدينة ومن الفضاءات المفتوحة بواسطة برمجيات.
■ وأنت تقرأ في خارطة التعبيرات الاجتماعية في الشارع، ماهي أبرز النقاط التي ترصدها؟
- كنت أرى قبل الثورة اللامبالاة، فكتبتُ بحثاً بعنوان "سوسيولوجيا اللامبالاة". كان ذلك في 2008، كما لاحظت تنامي لغة الفحش في الأمكنة العامة فنشرتُ بحثاً علمياً عنوانه "بلاغة الفحش" سنة 2009. واليوم اختفت اللامبالاة وقلّت لغة الفحش، ولكن ظهرت لامعيارية مخيفة في العلاقة بالدولة. هناك انتهاك للمؤسّسات، ولكلّ ما هو رمزي، وللنُّخَب أيضاً. لا شيء غير قابل للاستباحة والانتهاك وفي كلّ الأماكن: في الإعلام، في الشارع، في البرلمان.
كلّ السُّلَط الآن قابلة لأن يُتطاول عليها، وأوّلها السلطة الرمزية للنخبة ولحرم الجامعة وحتى لهيبة الأمن. الخط الأحمر الوحيد الذي لا مجال للتطاول عليه، على الأقل إلى حدّ الآن، هو الجيش في تونس. هناك نزعة عامّة شعبية، وغالباً شعبوية في تفكيك الرموز ولكن دون بدائل. هناك أيضاً اندفاعية غير مسبوقة، وظواهر واهتمامات وتعبيرات وأمزجة تأتي بسرعة لتذهب بسرعة. وثمّة أيضاً ما يمكن تسميته بالزوابع الاجتماعية، التي تحيل إلى ظواهر عارضة لا تكتمل. وهنا أذكّر بمفهوم سبق أن صغته قبل الثّورة سمّيته "الحركات الزوبعة".
وحتّى الآن لا أعتقد أنّنا قادرون على صنع ثورة تُحدث قطيعة مع الماضي، والدليل أننا إزاء عودة، قد تكون مؤقّتة هي، أيضاً إلى الإسلام السياسي؟ هل عودة الإسلام السياسي هي مقصد من مقاصد الثورة؟ أعتقد أنّنا لم نتخطّ العارض بعدُ. لا زلنا في قاعدة الزوبعة وفي المؤقّت.
الشيء الآخر الذي أعاينه باهتمام هو ما يحدث من تبدّلات رمزية هائلة في مجتمعات تعيد ترتيب الأولويات وتخلق موازين قوى جديدة في السياسة والاجتماع بالخصوص، تبدّلات رمزية تفكّ السحر عن السلطة القديمة والقائد الكاريزمي الكلاسيكي، لتخلق سلطاً متذرّرة ومتفكّكة وبقيادات صغرى مؤثّرة، ولكنّها فقيرة من جهة الكفاءة والرؤية والبدائل.
■ ما الذي يفسّر عدم القدرة على الاستمرار في فعل التغيير؟
- ليس في ثقافتنا ما يدفعنا إلى الذهاب بعيداً نحو القطيعة الكلّية. هل تذكر يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2011 في تونس حين سيطر الشعب الثائر على وزارة الداخلية، ولكنّه لم يقتحمها لأنّه فاقد للمشروع البديل، ولأنّه لم يتعوّد على أن يذهب بفعله الاحتجاجي إلى الأقصى. ثمّ إنّ ثقافتنا ليست ثقافة قطائع، وأنت تلاحظ كيف أنّ الكثير من الجماعات السياسية قد جعلت من الماضي "سيّداً للأيّام" بعبارة محمود درويش، وأن برامجها الانتخابية تكاد تعيد إنتاج لغة النظام القديم، وانظر ماذا فعلت الجماعات المتشدّدة في السنوات التي أعقبت الثورة، حتى أنّها أطلقت على نفسها "تنظيم الدولة". في رحم الثقافة العربية ما يجعل الماضي نمطاً مثالياً للمستقبل.
ثانياً، أعتقد أن التغيير الحقيقي والعميق يأتي من المعرفة ومن الجامعة ولا يذهب بعيداً إن لم يأت منها، وأنت ترى أنّ الجامعات العربية لم تخلق بعدُ بدائلها المعرفية ولم تُحدث ثورتها العلمية. الثورة تأتي من الفكر ولا تأتي من خارجه، وإلّا فإنّ نفسَها قصير. وأذكر أنّ نعوم تشومسكي كتب نصّاً عن الثورة التونسية أياماً بعد اندلاعها ليقول إنّها خفيفة، وأذكر حينها أنّني استأت ممّا قرأت، وأكاد أتفهّم قوله الآن، إذ لم يجد فيها مشروعاً فكرياً لتغيير العالم ورؤية مختلفة له. ليس هذا حطّاً من قيمة ما أُنجر، فذاك شيء ليس بالقليل، ولكنّه لن يذهب بعيداً ما دام بلا معرفة. الناس العاديون يثورون ويقلبون الأمور رأساً على عقب ولكنّهم يعودون في الليل إلى بيوتهم، وكأنّ شيئاً لم يكن.
هناك أناس يكتبون في الفيسبوك ويؤثّرون في الناس، وبدأت تتكوّن من بينهم قيادات صغرى، ولكن ماذا يكتبون؟ وما هي مشاريعهم المعرفية؟ ورؤيتهم للعالم؟ وقدرتهم على توسيع أفق الثورة؟ هل يكفي شعار "الشعب يريد" لنفتح باب القصر؟ التغيير تلزمه رؤية ومشروع واستراتيجية لتنفيذ هذا وذاك. لذلك أرى تونس مقبلة على تحدّيات كبيرة في الأشهر القادمة.
■ تستند إلى السيميولوجيا كثيراً، كيف تجد واقع هذا المجال المعرفي في الثقافة العربية؟ وهل يمكن أن يكون مدخلاً منهجياً لفهم الثورات العربية اليوم؟
- لا يمكن الحديث عن سيميائية عربية، رغم أنّ السيمياء موجودة تقريباً في كلّ تفاصيل الحياة اليومية عند العرب، الناس يأكلون أكلاً فيه سيمياء، ويلبسون أنساقاً من العلامات، وعلاقاتهم رمزية. حتّى أشكال العبادة تبدو إشارات وقرائن ورموزاً وسمات مختلفة: "سيماهم في وجوههم". في كل مكان يوجد نص اجتماعي لم نقرأه بعد؛ المقاهي، محطّات النقل، السجون، كلها تضجّ بالمعنى. هذه نصوص لا ضفاف لها. حقولها شاسعة لم تُحرث بعدُ.
من يشتغل على رسم تضاريس المعنى في واقعنا العربي؟ لا يزال الأمر في مقام النادر، يمكن أن نستحضر من ضمن القلّة عبد الكبير الخطيبي في "الاسم العربي الجريح" مثلاً. الحياة الرمزية للثورات العربية، مثلاً، ما زالت لم تُدرس بعدُ، فقد ظلّت بعد ما يقارب العقد من الزمن خارج الاهتمام العلمي، إلّا في القليل. يحدث هذا النقص في اللّحظة التي تبدو فيها الثورات العربية ثورات سيميائية بامتياز مارس خلالها الفاعلون سيميائية عفوية، ظهر هذا في ما تداوله الناس العاديون بالخصوص من كلمات على غرار أيقونة الثورة، رمز الثورة، علامة الثورة.
وإلى جانب الكلمات الملفوظة أو المكتوبة بدت صور الثورة أيضاً مشبعة بالاستعارات والإيحاءات والأيقونات، ومنها أيقونة الثورة السودانية التّي اتخذت من "الكنداكة"، لقب ملكات النوبيات في مملكة كوش الأفريقية، رمزاً. الصور الثورية هي أيضاً تقترح لغة إيحائية خارقة للّغة، فنظامها الدلالي التقريري غالباً ما يحيل إلى نظام من درجة ثانية لينتج الإيحاء. الظاهرة الثورية كظاهرة اجتماعية تُبنى وتُنمذَج وتُنسَج شبكاتها الرمزية بعيداً عن مسلّمات الأيديولوجيا وبداهاتها.
■ تقول في كتاب "السيميولوجيا الاجتماعية": "العلامة أخطر سكّان المدينة"، ماذا كنت تقصد؟
- العلامات والرموز تمثّل فاعلاً أساسياً في المجتمع. وأكاد أقول إنّ الرموز هي التي تفعل وتقاتل وتثور وتصمد. رموز تأتي وأخرى تذهب. بعد الثورة في تونس مثّل تمثال بورقيبة محور الصراع ولا يزال، معه أو ضدّه، وأذكر أنه، وبعد اندلاع الثورة بيوم، أوّل شيء استهدفه السلفيون هو تمثال بورقيبة، فتسلّقوه وحاولوا هدمه.
كان الأمر كذلك في بغداد مع تمثال صدّام حسين. القول بأن العلامة أخطر سكّان المدينة هو تكثيف لفكرة مفادها أن العلامات تخترقنا وتؤثّر فينا وتوجّهنا. وهي تفعل ذلك بطريقة ناعمة فلا ننتبه إلى خطورتها، بل إنّها تغيّر أمزجتنا وأذواقنا وحتّى مواقفنا. أعتقد أن المجتمعات العربية تعاني من فقر في إنتاج العلامة، وبالتالي في إنتاج المعنى، ويجري ذلك من خلال بناء نصوص متماسكة عبر هذه العلامات. من ناحية وظيفية، بناء هذه النصوص يساعد في توحيد الناس، توحيد رؤيتها، ومن دونها يكون كل شيء متشظّياً، أشبه بذرّات غبار.
■ كيف ترى واقع التأليف في العلوم الاجتماعية عربياً؟
هناك مشكلتان، الأولى تتعلّق بالاكتفاء بالحدث، إذا تعلّق الأمر بعلم الاجتماع، دون تأويله. لذلك تجد نفسك أمام كمّ هائل من الكتب لا يساوي أغلبها كلفة طبعاته. أمّا الثانية فتتعلّق بسؤال الكتابة، وهو سؤال مهمّ في سياق الثقافة العربية. أرى أن قلّة من علماء الاجتماع العرب كتبوا، أي صاغوا صياغة حسنة معرفتهم السوسيولوجية.
والكتابة بالمعنى الذي أشير إليه هي التي توصل الباحث إلى قارئ من خارج الاختصاص. وبالتالي علينا أن نصوغ السؤال هكذا: من تتجاوز نصوصهم اختصاصاتهم؟ من انتشرت كتاباتهم وفاضت في مجالات أخرى، كما هو الحال مع بارت وبودريار وبورديو مثلاً. بشكل عام، أشعر أنه يوجد نوع من التسيّب في الكتابة العربية ضمن علم الاجتماع، وفي معظم الكتابات البحثية، تسيّبٌ يحدث أحياناً باسم الموضوعية واليقظة الابستيميولوجية.
عموماً أعتقد أننا لم نتنبه بعد في الثقافة العربية إلى مسألة الصياغة الحسنة للعلم. التأليف، إذن، كتابة قبل كلّ شيء تفضي إلى أطروحة. والكتابة ليست فقط أسلوباً، بل مفردات ومفاهيم وطرق في ربط الأفكار بعضها ببعض لنصل إلى هذه الأطروحة.
■ كيف تجد علاقة منظومة النشر بمؤلّفات علم الاجتماع؟
- هناك بدايةً وضع عام للنشر يبدو صعباً؛ سوق الكتاب العربي ضعيف عموماً، والجهود هي جهود أفراد؛ إذ لا توجد تقاليد مؤسّسية إلّا في ما ندر، ومن هذه الجهود مشروع "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات". أمّا إذا خصّصنا المسألة بعلم الاجتماع، فقلّة من الناشرين تؤمن به كحقل معرفي فاعل. ولا يخفى أن دور النشر العربية تغلب عليها العقلية التجارية، في حين أن شرط ازدهار النشر في مجال علم الاجتماع هو تبنّي الناشرين لمشاريع بحثية، فتأليف أي كتاب في علم الاجتماع بمعايير جيّدة يقتضي خمس سنوات من الجهد الميداني والنظري، فأي حوافز تشجّع على هذا النوع من الكتب؟
كان يمكن للدولة العربية، كصيغة مفرد يراد بها الجمع، أن تتدخّل لتعويض انسحاب الناشرين، ولكن لا نجد أثراً لذلك. من الأدوار التي تتغافل عنها الدولة العربية خلق البنية المؤسّسية المنتجة للمعرفة. باختصار، علاقة النشر بالإنتاج في علم الاجتماع هي بالنسبة إليّ علاقة بلا عقيدة ولا إيمان. النتيجة هي أن كل المشتغلين في علم الاجتماع يجدون صعوبة في النشر، لكن فقر النشر لا يخفي فقر إنتاج المعرفة في كثير من الأحيان. لنقولها صراحة، لا يمكن أن يكون هذا الواقع عائقاً دائماً نبرّر به عجزنا، ونفسّر به غياب الأعمال الرائدة. ما هو مبدع لا خوف عليه، سيجد طريقه إلى القارئ دائماً.
■ لماذا لم تشتغل على الترجمة وهو أمر دارج لدى الباحثين؟
- الترجمة لها أهلها المختصّون بها، والأجدر بنا في علم الاجتماع أن نترجم الواقع، أن نحاول فهمه وتفسيره، وفي الحدّ الأدنى أن نصوغ بعض أسئلته وفي لحظة فارقة، وهذا في حدّ ذاته ليس بالأمر الهيّن. زيادة على أنَّ مجال البحث في علم الاجتماع ليس بقليل. واقعنا العربي اليوم يُفترض أن يتحوّل إلى ورشات تفكير لأنّه في حالة مخاض، في حالة جيشان غير مسبوقة، ومتابعة كلّ هذا ليس بالأمر اليسير. يكفي في الحدّ الأدنى أن نعاين بعض مظاهره، ثم إنّ علم الاجتماع هو علم المعاينات، علم الأسئلة، أي أنه - بالنسبة إليّ - يستند إلى دهشة السؤال، وهذه الدهشة لا تكون إلّا حين ينطلق السؤال منك، ومن واقعك، ومن تجربتك.
الترجمة هي بهذا المعنى نقلٌ لسؤال غيرك. هي مفيدة ولكن الأولوية تظل لأسئلتنا نحن، أسئلتنا التي نطرحها على واقعنا. سبق أن راودتني أفكار بترجمة أجزاء من رولان بارت، وهو الذي رأيت دائماً بأن في نصوصه لمسة سحرية، أسلوبه المنساب المتفرّد في صياغة أفكاره، وهي صياغة تأتي باللّامتوقع. كيف يمكن الإمساك باللامتوقع في كتابته؟
معروفٌ ذلك القول بأن الترجمة خيانة، هي ليست خيانة المعنى أو الفكرة فحسب، إنها أيضاً خيانة الصياغة. ما الذي يَبقى من نيتشه إذا نزعنا من جملته ترتيبه الخاص للمفردات؟ المعاني في النهاية هي التقاطات من الحس المشترك، أمّا الصياغة فتلك هي خصوصية الكاتب. الترجمة هي ألّا تخون الصياغة، وهي بذلك تصبح معادلة معقّدة جداً. ثمّ إنّ التدريس في الجامعات ليس أمراً سهلاً، إذ يأخذ منك الكثير من الوقت والجهد. ناهيك عن أنّ الترجمة لها أهلها، ولا أراني منهم.
■ بماذا تنشغل اليوم على مستوى البحث؟
- أشتغل على سيميائية التعبيرات الثورية وفق سيميائية مقارنة، وبالمناسبة هذا الفرع أكاد أقول إنّه "مستنبط النشأة": فكرة السيميائية المقارنة. وأشتغل على اللغة والثورة، ولكن ضمن مشروع أكبر يُعنى بكيفيات قراءة العارض (The contingent). هذا ما يشغلني بحثياً، وسؤالي: كيف يمكن تقليص زمن ردّ الفعل في مستوى الفهم إزاء ظاهرة فجئية عارضة؟
أحاول أن أفهم كيف يمكن أن يندرج ما هو مجرّد صدفة ضمن الممارسة العلمية، وهذا مهم في سياق مفهوم "الحركة الزوبعة" التي تضيء الكثير من واقعنا السياسي والاجتماعي للمنطقة العربية اليوم. سؤالي هو: كيف يمكننا الإمساك علمياً بذلك، بما هو مجرّد ومضة، يأتي ويذهب بسرعة؟ هل يمكن أن نكتفي بدراسته من خلال بقاياه أم علينا مقاربته حدسياً أم عبر المخيال أم سيميائيّاً، أم كما يفعل الكمّيون حين "يكمّمون" الواقع في أرقام.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطاقة
باحث تونسي، وأستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية وباحث زائر في "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات". شغل منصب رئيس "الجمعية التونسية لعلم الاجتماع"، وأمين عام "الجمعية العربية لعلم الاجتماع"، كما أطلق مجلة "المقدّمة". من مؤلّفاته: "السيميولوجيا الاجتماعية"، و"التعبيرات الاحتجاجية والمجال الاجتماعي"، و"الثقافة والإرهاب.. محاولة في الفهم"، و"العدالة في عيون المساجين".