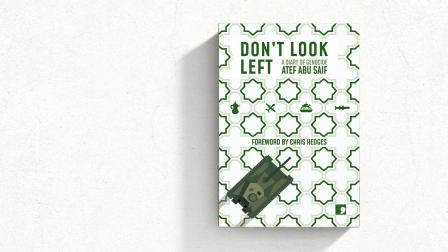وهمُ التفوّق الذي تمنحه الكلمات الأجنبية
ثمّة ظاهرة لُغويّة ثقافيّة يُعاني منها أفرادٌ في كافّة المجتمعات البشريّة، تتمثّل في قيام البعض باستخدام كلماتٍ من لغات أجنبيّة بوصفها لغاتٍ سامِية، تحيط بها هالة اجتماعيّة فوقيّة، يورِث التلفّظُ بها ضربًا من الاستكبار والافتخار.
وقد عُبّر عن هذه الظاهرة بمُصطلح Snobisme، ذي الأصل الإنكليزيّ، الذي يحتار المرء في تَرجَمته. فحتّى الفرنسية لم تجد مفرًّا من نقل جذره بشيء من التصرّف دون تغيير دلاليّ. وليس له في العربية مقابلٌ من كلمة واحدة. ولذلك نضطرّ إلى تمثيله عبر هذه الترجمة التفسيريّة: الإحساس بالاستعلاء والعُجْب بسبب استخدام لغةٍ أجنبيّة؛ إحساسٌ يولّد، في نفس الآن، احتقارًا للّغة السّائدة لدى الجمهور.
ينتمي هذا المفهوم إلى فرعٍ الألسنيّة الاجتماعيّة، ويشير إلى سلوك لغويّ يُلاحَظ لدى بعض المُتكلّمين إزاء مُخاطَبيهم، يتمثّل تحديدًا في الإحساس بالتفوّق بمجرّد النُّطق بكلمات أجنبيّة طيَّ الخِطاب الشفويّ في تعاملهم مع الآخر. وفي حالتنا العربيّة، يتمّ اللجوء إلى الإنكليزية أو الفرنسيّة، وربّما بدرجة أقل إلى الإسبانية، للتعبير عن هذه النّزعة.
ولا شكّ أنَّ هذه الظاهرة ألصقُ بالكفاءة الشّفويّة، ذلك أنّه فقط من خلال الحِوار المُباشر تَبرز الرّهانات الاجتماعيّة والنفسيّة لهذه النزعة في التّعالي، بحكم أنّ الهدف منها هو فرض حضور خطابي على أوسَع دائرة من الفاعِلين الاجتماعيّين، وهو ما لا توفّره المساحة المَحدودة للمكتوب، إلّا في حالة مُدوّنات التواصل الاجتماعيّ التي تتوفّر على شِفرات مُختلفة.
يرغب الأفراد في أن يتبنّاهم أصحابُ اللغة التي يقلّدونها
ولا بدّ من التذكير هنا أنّ هذا السلوك الاستعلائي يعني استخدامَ مفرداتٍ من اللغات الأجنبية، بما فيها تلك التي لها مقابلٌ دقيق في اللغة الأصليّة. ولذلك يؤكّد المفكّر اللغوي الفرنسي، من أصول تونسية، كلود حجاج، أنّ "التفوق اللغوي لا يعوّضُ نقصًا ولا يملأ خانة معجميّة فارغةً، ولا يقدم حتّى فويرقاتٍ دلاليّة"، وإنما غَرضه التباهي باستخدام تلك الكلمات لإظهار التفوّق على الآخر، حيث يتّصل العمق السيكولوجي لهذه الظاهرة برغبة الأفراد المُقلّدين في أن يتبنّاهم أصحابُ اللغة المُقَلَّدَة وأن يُحسّوا بالعَطف عليهم.
كما يجدر التمييز هنا بين ازدواج اللغة والتكبّر اللغوي والاقتراض، فهي سلوكات مُختلفة: إذ يُشير الأول إلى قُدرة الذات المُتكلّمة على امتلاك لغتَيْن واستخدام كلّ واحدة منها على حِدة حسب السّياقات الخاصّة بالتّواصل، وأمّا الثاني فيكمن في استعمال لغة أجنبيّة مع الإحساس بتفوّقها على اللغة الأصليّة وبعجز هذه الأخيرة عن التعبير. وكلاهما يختلف عن الاقتراض بما يعنيه من تبيئَة للمُفردات المقتَرَضَة داخل النّسَق المقتَرِض حتى كأنّها جزءٌ منه لا يتجزّأ.
وقد ترسخّت هذه الظاهرة بشكل لافت في الإذاعات والتلفزيونات العربية (وخاصة التونسيّة والمغربيّة واللبنانية)، إذ يعتقد مقدّمو برامج هذه القنوات أنّ إدماج عبارات أجنبيّة كفيل بأن يجعل تدخّلاتِهم أكثر جاذبيّة للجمهور، بل قد يتضخّم هذا الوَهم حتى يَظن المتلقّي أنّ البرنامج صار في مرتبة ما يُقدّم في الدّول الغربية في عملية تماهٍ نفسيّة.
ومن مظاهر هذه الغلواء الأكاديميّة، في عالَمنا العربيَّ، أنَّ الباحثين يلجأون إلى تحرير مقالاتهم العلميّة ومحاضراتهم بِلغة أجنبيّة مع انتفاء الدّواعِي لذلك، أكانت مهنيّة أو إجرائيّة، حتى في الدّراسات ذات الصّلة بالعربيّة، وذلك لمجرّد الاحتقار الواعي واللا-واعي للضاد واعتبارها غيرَ مؤهّلة للتعبير عن المضامين البحثيّة ونَسيجها المفاهيمي العقلاني.
احتقار واعٍ أو لا واعٍ للضاد واعتبارها غيرَ مؤهّلة
وللظاهرة أيضًا بعدٌ اقتصاديّ - إشهاريّ، يتجلّى في ما نراه من طغيان السّلع الغربيّة والعلامات التجاريّة الكبرى على واجهات المَحالّ والمراكز على امتداد الوطن العربيّ، حتى صارت جزءاً من النمط الاستهلاكي الذي أغرق أسواقَنا والوَعيَ السائد من ورائها، بهذه السّلع وبمسمّياتها، فصار مجرّد استخدامها دليلًا على التماهي بالنمط الغربيّ في الموضة والتمتّع بخصائص الأناقة التي يُروَّج لها.
ذلك أنه من خفايا هذا الإحساس بالفوقيّة ارتباطُه بتحرّر الجَسد والرغبة في إظهاره وحتى مَسْرَحته في الفَضاء العام، وبسط نفوذه على المُخاطَبين، فكأنّ الكلمات الأجنبيّة المُقحَمَة أدواتٌ تساعد مُستخدميها على التسلّط اللغويّ والغلبة لفَرض نمطٍ اجتماعيّ مخصوص في طريقة الكلام وهَيئته ولُكنَته.
ولا يخفى أنّ هذه الغُلواء اللغويّة مرتبطة بظاهرة الاستعمار، فالمتكلم يَلجأ إلى لغة المُستعمِر السابق، لأنّها ارتبطت في الذّاكرة الجماعيّة بحضور الغرب وحَضارته وامتلاكه لأسباب القوّة والوجاهة الاجتماعيّة، فالتلفّظ بكلماته الأجنبية يعني التّماهي مع السيّد الأبيض، الغنيّ والمتحضّر، واستعارة نَموذجه المضخّم في المخيال الجمعيّ.
فقد لعب الاستعمار وجالياته الأجنبيّة في البلدان العربية المُستَعمَرَة سابقًا دورًا كبيرًا بواسطة ما استخدمه من وسائل ثقافيّة لطمس الثقافة المحليّة، مثل المدارس والكنائس والجماعات التنصيريّة والمهمّات التبشيريّة، والتي لا يزال بعضها نشطًا الى حدّ اليوم ولكن تحت مُسمّيات أخرى كالمدارس التحضيريّة المرتبطة بكُبرَيات المعاهد في أوروبا، وكبعض المراكز البحثيّة، والتي من آثارها بسط هذه الأنماط في التخاطب وجعلها علامةً على الرقيّ الاجتماعيّ والانتماء الى النُّخب الناجحة، على عكس الجمهور العريض من الناس الذي يكتفي بتعلّم لغةٍ واحدة، ويتخرّج من المدارس العموميّة المجانيّة. وهو ما يؤكّد أن لهذه الظاهرة جذورًا اقتصاديّة بحتة، لا علاقة لها بالقدرات العقليّة. فالعائلات الفقيرة والمتوسّطة لا تستطيع إرسال أبناءَها إلى المَدارس الأجنبيّة ولا تَقدر على مجاراة نمط العيش للفئات المتغرّبة، بما في ذلك أسلوب التخاطب.
ومن المفارقات اللطيفة أنّ اللغة العربيّة ذاتُها قد تصبح، في بعض المناطق من العالَم، ولا سيما آسيا وأفريقيا وحتى في الغرب، قرينة التفوّق ويصير النطق ببعض كلماتها دليلاً على النباهة والنجاح، ويتأكّد من جديد هذا الاقتران بين اللغة والسّلطة واستخدام الواحدة للأخرى في سبيل فرض الذات على الآخر ضمن آليات التّصارع الاجتماعي اليوميّة التي لا تغيب مطلقًا عن أيّ موقف أو حركة أو كلمة.
ومن هذه المفارقة تنسلّ أخرى، وهي أنّ الفرنسيّة، التي يقلّدها البعضُ عندنا، هي مَن يعيش حالةً من الدّونيّة إزاءَ الإنكليزيّة، وذلك منذ عصر الأنوار، حيث أقْحَم المفكّرون والأدباء وحتّى عامّة الناس ألفاظًا منها في محاوراتهم اليوميّة. وترسّخَت هذه النزعة، في أيامنا، مع سيطرة ما سمّاه المفكر السوري مطاع صَفدي: "أمركة العالم" حين تعمَّم استخدام الإنكليزيّة في سائر مجالات النسيج التواصليّ.
تدعونا هذه الظّواهر إلى التفكير المعمّق في العلاقات السلطويّة التي تختفي وراءَ ظاهرة التقليد هذه، والتي تَبَيَّن أنها أكمةٌ، وراءَها ما وراءها من الأحاسيس والصّراعات، ولكنها، في نهاية المَطاف، مجرّد عُقدة يظنّ صاحبُها أنّ اللغة المُقلَّدة لغة سامِيَة، يتكلّمها عِرْقٌ أسمى من غَيره، ومجرّد التشبّه به يهبه نفس هذا السُّموّّ المزعوم.
* كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس