صدر قديماً: "المغرب الأقصى" وطواحين هواء أمين الريحاني
يُحدِّد كتابُ "المغرب الأقصى: رحلةٌ في منطقة الحماية الإسبانية"، الواقعُ في 690 صفحة، والذي جرى تأليفه بين 29 نيسان/ إبريل و11 آب/ أغسطس 1939، مجالَ تحرُّكه بوضوح، فهو يقتصر على جغرافية استعمارية نُعِتتْ من باب التلطيف بـ"الحماية" وأفردت، في مؤتمر 1884 في ألمانيا، لإسبانيا من الكعكة المغربيَّة الشمال والصحراء، بينما استحوذت فرنسا على الوسط الشهير بـ"المغرب النافع"، أي ما بين المنطقتيْن الآنفتيْن.
ويندرج الكتاب ضمن مشروع إصدار سلسلة من الرحلات إلى البلاد العربية، استهلَّها مؤلِّفُها أمين الريحاني بـ"مُلوك العرب"، الذي أعْقَبه "قلب العراق"، فـ"قلب لبنان"، ثم "المغرب الأقصى"؛ وكلها أعمال صدرت عن وعي حضاري وسياسي بضرورة إعادة اللحمة إلى الوطن العربي، ثقافياً على الأقل، الذي تناهَبته القوى الاستعمارية، وفرَّقت بين مواطنيه وبلدانه، فـ"سلسلة من الكتب تعنى بأحوالها كلها وتعرض لجميع مناحي الخير والضعف فيها تكون خير سفير لتعاطف هذه الأقطار وتقاربها ووحدتها"، كما يقول الريحاني.
ولم تكن هذه الرحلة إلى المغرب الأقصى، في نظر الرّيحاني، أقلَّ شأناً و"بأقلَّ إلحاح واستبداد من الرغبات في الرحلات التي تقدَّمتها، بل كانت أشدَّ وأحدَّ فنفذتْ إلى أقصى نواحي النفس [...] إلى ذلك البلد العربي في أفريقيا الغربية الشمالية".
ويَرُدّ الريحانيّ سببَ تأخرِّه في كتابة رحلاته عبر العالم العربي إلى توزُّعه بين هويّته العربية وهويته الأميركية؛ فقد وَفَد على العالم الجديد قادماً من لبنان، وهو في العاشرة من عمره، فكانت نيويورك مرتَع طفولته، إلى درجة إحساسه بأنه صار من أبنائها، وبأنه مَدين لها بالكثير، ففيها "سبقتْ لغةُ شكسبيرَ لغة أبي العلاء المعري إلى لساني وقلمي - كدتُ أقول أيضاً وقلبي - فوقعت في فخِّ التأليف هناك قبل أن وقعت فيه ها هنا، في وطني الأول".
وعلى الرغم من إحساس الرّيحاني بأميركيّته الجارفة، شأنَ كلِّ من استوطنَ الإلدورادو، فقد استيقظت فيه حميَّتُه العربية إثر معاينته "لنكبة فلسطين بالصهيونية" التي، وفق قوله، "فرضتْ عليّ الجهاد في سبيل قضية وطنية قومية هي قضيتي"، وهي القضية التي جعلته يتصوّر نفسَه "أكبر من أميركا!"، بل حرَّضته على أن يُعلّمَ الأمة الأميركية "أوليات العلم بالأمة التي أنا منها - كنتُ ولا أزال منها، اليوم وغداً، وعلى الدوام - أي الأمة العربية"، فخاض حربه التنويرية، "يحمل الترس والرمح، كما حملهما (دون كيخوته ده لا مَنْشا) حقبةً من الدهر" جائباً معاقل إسرائيل في أميركا مُشتبًكاً على جبهات عديدة، خصوصاً نيويورك "عاصمة تلك السيطرة اليهودية" وكان ترصُّد الصهيونية به مهمازاً استنفر هِمَماً عربية كثيرة في أميركا، فانبرتْ للدفاع عن فلسطين في عقر دار اليهودية.
ويشير الريحاني إلى أنه مرَّ بمضيق جبل طارق في رحلته، من قريته الفريكة بجبل لبنان، في اتجاه نيويورك، أو العكس، أكثر من خمس عشرة مرّة، وهناك كان يُحسّ بألم كبير كلَّ مرة، لأن جبل طارق بن زياد "لم يبق من عروبته غير اسمه وبعض الآثار في أعاليه". ومن هناك كان يرى على الشاطئ الأفريقي "المدينة العربية الجميلة: طنجة. تتمطى في ظلال الفردوس الدولي، مطمئنة آمنة"، لكنه لم يجرؤ على النزول بأرض المغرب "الذي جنَّد لفرانكو مائة وستين وألْفاً من أبنائه الأشداء البُسَّل، إلا حين انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية".
وعن عُمُر يتجاوز الستين، صادفَ سفر الريحاني إلى المغرب، يومَ افتتاح "المعرض العظيم" في نيويورك، الذي انتقد بهرجَتَه، لأن "الجزء الأكبر منه ألاعيب وشعوذات، والجزء الأصغر علم وفن وثقافة". هكذا نكتشف أنّ هذا "الجزء الأصغر"، كان الشغل الشاغل لأمين الريحاني، وأنه حظي باهتمامه الكبير أثناء رحلاته، لأنه كان يستدل به على أنّ دار العرب كانت دوماً دار علم وفن وثقافة، من جهة، ولأنه، من جهة ثانية، مَثَّلَ رهانَ المؤلِّف عليه، وعلى الثقافة تحديداً، لِما تعكسه من قوة جاذبة لخلق المؤالفة بين المشتَّت سياسياً في العالَم العربي.
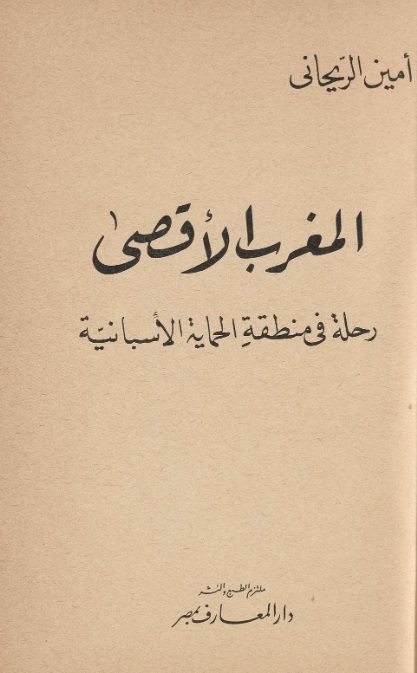 بأسلوب بياني مائز، وظّف الرحالة في سرده الكثيرَ من الوقائع والمعلومات التاريخية، يستعرض فيه التاريخَ التليد لبلاد المغرب ومكانتَه عند الأوروبيّين مثلاً؛ فهذا ملك فرنسا بعث رسولَه، بِيدُو دي سَنْتُولان، إلى السلطان المولى إسماعيل في مكناس، "فكتب السيد سنتولان إلى مليكه يصف أبهة بلاط السلطان، ويخصّ بالذكر والإعجاب الحرس السلطاني المؤلّف من أربعمائة عبْدٍ أسْوَد عِمْليق، فدقّق في وصف هيئتهم حتى جواربهم"، مثلما ركّز - في انفعال تضامنيّ - على فضح الأساليب التي استخدمتْها القوى الإمبريالية للتمهيد لاستعمارها البلاد، والصراع الذي كان بين هذه القوى، خصوصاً الإنكليز والفرنسيين، والحِيَل التي تمكنت بها فرنسا من بسط نفوذها على المملكة عَبْرَ إقراض السلطان أموالاً عجز عن ردِّها.
بأسلوب بياني مائز، وظّف الرحالة في سرده الكثيرَ من الوقائع والمعلومات التاريخية، يستعرض فيه التاريخَ التليد لبلاد المغرب ومكانتَه عند الأوروبيّين مثلاً؛ فهذا ملك فرنسا بعث رسولَه، بِيدُو دي سَنْتُولان، إلى السلطان المولى إسماعيل في مكناس، "فكتب السيد سنتولان إلى مليكه يصف أبهة بلاط السلطان، ويخصّ بالذكر والإعجاب الحرس السلطاني المؤلّف من أربعمائة عبْدٍ أسْوَد عِمْليق، فدقّق في وصف هيئتهم حتى جواربهم"، مثلما ركّز - في انفعال تضامنيّ - على فضح الأساليب التي استخدمتْها القوى الإمبريالية للتمهيد لاستعمارها البلاد، والصراع الذي كان بين هذه القوى، خصوصاً الإنكليز والفرنسيين، والحِيَل التي تمكنت بها فرنسا من بسط نفوذها على المملكة عَبْرَ إقراض السلطان أموالاً عجز عن ردِّها.
لكن رحلة الريحاني، مثل كل كتب أدب الرحلة، كانت أيضاً اكتشافاً لأنماط عيش ميّزت المجتمع المغربي، وعمِل على نقلها إلى القارئ العربي. فبعد أن نزل أولاً بجبل طارق بن زياد، انتقل منه إلى طنجة "جنينة الفرنجة" التي لا "تختلف عما في مصايف أوروبا [...] إنما نحن على مصايف الجنان الأرضية، في صيف اللذات أو في شتائها". وقد أفزعت المَشاهدُ الاجتماعية لطنجة الريحانيَّ الذي لم يُخف تذمّرَه منها بصِفتها "مدينة الشهوات العارية، والمنكرات السارية" يُسيطر عليها نمط عيش أوروبي صارخ، لاحتجانها بأجناس متنوعة، وهي تلخّص بسوقِها الداخلي "المغرب في مرحه وفرحه، في ألاعيبه وشعوذاته، المغرب الروائي الشعري، المغرب اليائس الضحوك، المغرب العجيب!"، وكأنه يُفسِّر لنا سبب أسْطَرتها من قِبل الأوروبيين والأميركيين، وافتتانهم بها.
لكن زيارةَ الريحاني لِتطوان "المدينة البيضاء"، غيَّرتْ ما كان لديه من رواسم جاهزة؛ إذ يقول عن نفسه "جئتُ المغرب وفي الذهن صورة لمدنه وقراه، لا تختلف عما كنتُ أشاهده في اليمن وفي نجد"، فإذا به يقف على حال أخرى مختلفة تماماً. صادف دخول الريحاني تطوان اليومَ الثاني من عيد المولد النبوي، فانبهر "للشعب المغربي قد اختلط بدْوه بحضره، وكلهم في بهجة العيد، ولا أثر للبهجة في الوجوه. يمشون ساكنين قانتين، كأن على رؤوسهم طيورَ الجنة، أو كأنهم، مثل الإنكليز، يستقبلون المسرات بوجوه ألفت الكآبة!".
وقد راعه ما عليه التطوانيون من تمدُّن أصْلُه تحدُّرهم من محتد أندلسي، فقال عنهم ممتدحاً سلوكَهم العادي، "أمَّا أنهم في تجمهرهم متمدّنون أكثر ممن يظنون أنهم شعب المدنية المختار، كالأميركيين مثلاً أو الأرلنديين المتدافعين المتصاخبين في الاجتماعات، فهذه السكينة السائدة في سَيْرهم، أو تلك التؤدة المرافقة لصفوفهم، تشهد بذلك شهادة صادقة عادلة".
وكان الرحالة قد عقد صداقة مع بِغْبِدِر (المقيم العام)، فوقف عند الحال العمرانية للمدينة واصفاً، ونبَّه إلى المشاريع التحديثية الكُبرى التي يسهر عليها الحاكم الإسباني بنفسه، والذي أنشأ بها ساحات ومرافق عمومية من مكتبة عامة ومعاهد للدراسة وبنايات وغيرها. لكنّ كَرَمَ بِغْبِدِر مع الريحاني لم يمنع العربيَّ من أن يسأل الحاكم عن الحال السياسية، إذ كتب "فقلتُ: والسياسي؟ فقال: العدل... كل السياسات تستقيم بالعدل. ووقف هنيهة عندها، ثم أردف قائلاً: والمحبة. بالعدل والمحبة يستقيم كل شيء. وبدون العدل والمحبة لا يستقيم شيء. وستشهد هذه الساحة غداً على ما أقول".
يُثير "المغرب الأقصى" قضايا سياسية وثقافية واجتماعية أخلاقية وغيرها، وقد انتبه الريحاني إلى أن كتابَ رحلتِه هذا ضخْمٌ، وإلى أنه قد يرهق القارئ، لذلك لجأ إلى التعبير استعارياً عمّا أفاده من رحلته بهذه الكلمات: "في المغرب طبخة يُسمُّونها الحَريرة، هي شبيهة بالحساء، ولكنها تشمل على الكثير من أنواع اللحم والخضر والأباريز، فيرسب الأكبر في قعرها. فلا تحظى أنتَ به إلا بعد أنْ تصل في احتسائك إلى القعر - النهاية. فإلى قعر الحريرة - النهاية" إلى قراءة الكتاب والاستمتاع به.



