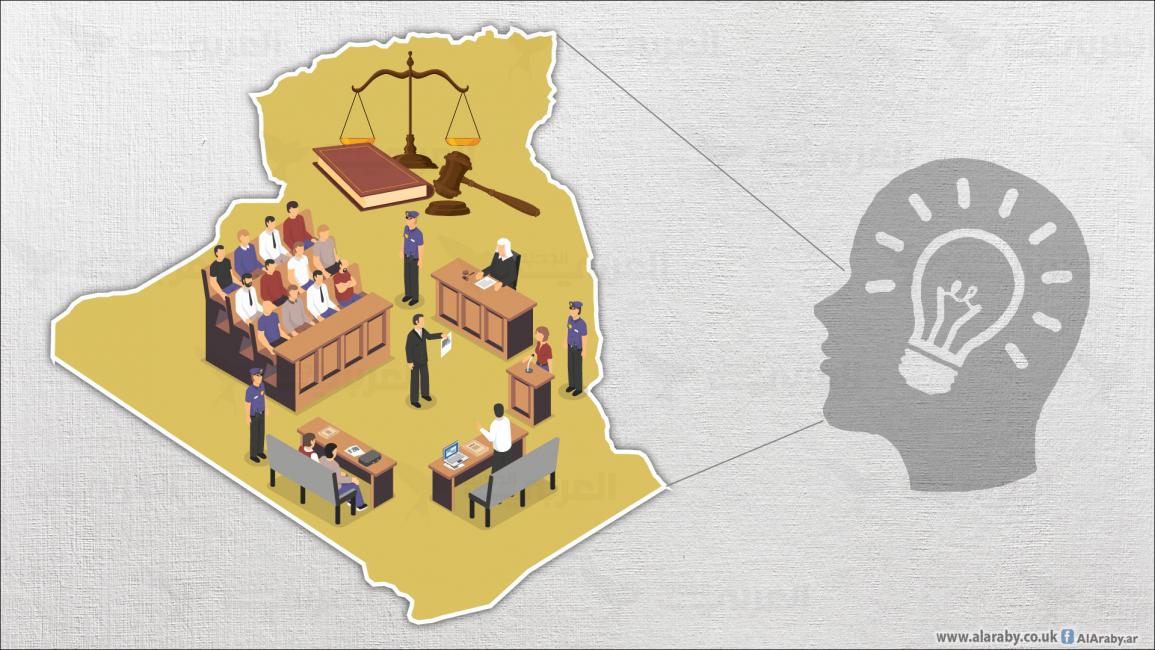21 مارس 2024
من دروس المحاكمات في الجزائر
من دروس المحاكمات في الجزائر
تشهد الجزائر حالياً حدثاً له ما بعده، حيث يُحاكم أشخاص نافذون، كانوا - إلى الأمس القريب - أصحاب القرار في أعلى هرم المسؤوليات. وأهمية ذلك، أن المحاكمات تفتح علينا باباً لمقاربة جديدة للمحاسبة، لم نكن نفطن إليها من قبل، حيث تدل الأرقام الهائلة لما نهبوه على حجم ما كان يمكن أن يتحقق، لو أن تلك الأموال استخدمت في مشاريع لتنمية الجزائر وتطويرها، وإخراجها مما هي فيه من ضعف هيكلي حقيقي.
ولعلّ الطابع الفريد في الحراك الذي تشهده الجزائر، منذ عشرة أشهر، يمتدّ، في تأثيراته وتداعياته، إلى إبداع مقاربة جديدة في التّعامل مع النّظام البائد، الضّالع في عمليات النّهب للمال العام، الفساد، الرّشوة، وإدامة الاستبداد، مقاربة جديدة تضاعف من الألم، بكلّ أبعاده، بالنّسبة إلى ما ضيّعته البلاد من فرص/ خيرات، حيث لن يُعمَل، من الآن فصاعداً، على المحاسبة على ما حدث، على ما أُهدر وما نُهب من مال فقط، بل يتجاوزه إلى ما ضُيِّع من فُرص على الجزائر التي كان يمكن أن تكون اليوم، دون هؤلاء، دون فشلهم وسياستهم العامّة الكارثية، في مكانة أخرى أفضل وأرفع، ولم لا قوّة إقليمية في حجم بلدان تصنع الفعل الإقليمي، اليوم، على غرار إيران وتركيا، الأولى في الملفّ النووي والمشاريع الصّاروخيـــة، والأخرى في ملفّ التّموقع في الشّرق الأوسط وحيازة السلاح (أس 400).
عندما ينطلق المدّ الإصلاحي في أيّة تجربة انتقالية، يكون من بين مآخذه على النّظام البائد الاتّجاه نحو القضاء على منظومة الفساد والفشل التي أقامها لإدامة إمساكه بزمام الأمور، وهي مآخذ
صحيحة في المجال القانوني، عندما تجري مقاربتها من دون إرادة انتقامية أو انتقائية، بل في إطار عدالةٍ انتقاليةٍ، تحقّق العدل من دون الذّهاب إلى الإقصاء أو الانتقام. وقد اتُّبِعَت هذه المقاربة في أكثر من بلد، واكتُشِف أنّها سريعاً ما يثبت فشلها، إذ يختلط الانتقام والإقصاء (خصوصاً السياسي) مع إرادة تحقيق العدالة ورفع الغبن عن البلاد والعباد اللّذين يمسّهما الظّلم والنّهب، وتكون عاقبة ذلك كلّه الفشل الكبير والتامّ لآلة السياسة العامّة على الأصعدة كافة.
نصل، هنا، إلى بيت القصيد، وهو المقاربة الجديدة للمحاسبة، إذ يكون الفشل التامّ، المشار إليه، يكون، زماناً، قد ضيّع على البلاد فرصاً سمحت لغيرها، في الوقت ذاته، بركوب موجة القوّة لتصبح اقتصاديات ناشئة وقوى متوسطة تصنع الفعل الإقليمي. وإذا أردنا تطبيق هذه المقاربة على الجزائر في حراكها لصنع التغيير، سنكون أمام فعل قانوني - قضائي، لا مناص من الذّهاب فيه إلى أبعد ما يمكن لملفّات الفساد من تأثير بطبيعة الحكم والسياسة العامّة طوال العشريتين اللّتين حكم فيهما الرئيس المستقيل. وقد كان لهذه المقاربة أكبر الأثر في التّمكين لسلميّة الحراك، من ناحية، وفتح ورشات وجوب تجديد النّخب الحاكمة، من ناحية أخرى، حيث طاولت ملفّات الفساد شخصيات مقرّبة من دائرة اتّخاذ القرار في النّظام السّابق، إضافة إلى شخصيات تنتمي إلى أداتها الاقتصادية – المالية، بما يوحي أنّ الفساد مستشرٍ، في مركز الحكم وهامشه وأدواته، ويستوجب، لمحاربته، "أن يتنحّاو قاع" (ليرحلوا جميعاً، بالعامّية الجزائرية، شعار يرفعه المتظاهرون، منذ بدء الحراك)، بمعنييه، السياسي بتجديد النخب، والسوسيولوجي بالتمكين لتلك النّخب صاحبة الكفاءة.
على الرّغم من ذلك كلّه، لماذا لا نتّجه إلى مقاربة مزدوجة تزاوج بين المقاربتين المذكورتين للمحاسبة، عدالة تقف بأدواتها القانونية لرصد قرائن الفساد وصنع ملفّات ليفصل القضاء فيها، وعدالة أخرى، معنوية وعلمية، في آن واحد، يقوم بها الخبراء يحصون فيها الفرص التي يكون الفشل والسياسة العامة المتهالكة قد ضيّعتها على البلاد في المدّة التي حكم فيها المستبد؟
يمكن الانطلاق، للإجابة عن السّؤال، بالنسبة إلى الجزائر، من حقيقة أكّدتها مراجع علمية وأكاديمية كثيرة، خاضت في الشّأن الاقتصادي الجزائري، وهي أنّ كلاً من الجزائر، كوريا الجنوبية وإسبانيا كانت، في حدود منتصف سبعينيات القرن الماضي، في مرتبةٍ متقاربةٍ من النّمو الاقتصادي، من ناحية، وكيف استطاعت كلّ من تركيا وإيران، بمقدّرات متقاربة من تلك التي تملكها الجزائر، من ناحية أخرى، من بلوغ مصافّ القوّة المتوسطة الإقليمية، وهي حقائق تؤسّس لمقاربة المحاسبة بالفرص الضّائعة، لأنّ تلك البلدان المذكورة تنتمي، كلّها، ما عدا إيران، إلى أسبابٍ سياسية، لمجموعة الاقتصاديات الناشئة، أو ما يعرف بمجموعة العشرين.
تقوم تلك المقاربة على أسس علمية، إذ إنهّا تلجأ إلى حساب الفرق بين الوضع العادي (والوضع الآخر) لاستخدام الموارد والكفاءات بمنهجية تحقيق الصالح العام، وبانتهاج مقومات السياسة العامة، بالارتكاز على التّوفيق بين الموارد والاحتياجات، وباستخدام الأدوات العلمية التي لا يتيحها إلّا العدل في فسح المجال أمام الكفاءات، لتعبّر عن نفسها في جوّ كلّه تنافسية ونزاهة في إطار تكافؤ الفرص. ويُقصد بالوضع الآخر، هنا، وضع الفساد، الرشوة والمحسوبية في التّعامل مع تلك المقدرات/ الموارد نفسها، وما ينتج من ذلك من إهدار للموارد/ المقدرات، وبالتالي، تضييع الفرص ومنع البلاد من بلوغ المرتبة التي تليق بتلك الموارد/ المقدرات.
بالنّسبة إلى الجزائر، أقرت بعض الدّراسات بما تملكه البلاد من تلك الموارد/ المقدرات، وما كان
يمكن أن ينتج منها، لو استُخدِمَت لتوليد التنمية/ التطور، خصوصاً أن تلك الموارد/ المقدرات تشير إلى بلد بحجم قارة، ويملك منها الكثير لبلوغ مرتبة الاقتصاد الناشئ والقوة الإقليمية، ودليل ذلك، على أقل تقدير، أن بعضهم يشير إلى رقم هائل هو ألف مليار دولار، هي جملة مداخيل الجزائر من بيع النّفط والغاز، أُهدِرَت في مشاريع لم ترفع من قدر البلاد، ولم تخرجها من دائرة الريع النفطي أو التخلّف.
وكانت دراسات جزائرية قد قامت بمحاكاة المكانة التي كان يمكن بلوغها في حالة الاستخدام الجيد لتلك الأموال فقط، من دون الذهاب في تلك العملية الاستشرافية إلى ما كان يمكن أن ينتج من الاستخدام العلمي لتلك الموارد/ المقدرات والارتكاز، فقط، على الطاقات المتجدّدة. (يذكر، هنا، تضييع الجزائر فرصة المشروع الألماني لتوليد الطاقة وتصديرها إلى أوروبا "ديزارتاك" الذي رفضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأسباب ما زالت مجهولة)، الزّراعة (تمتلك الجزائر ما يزيد على 40 مليون هكتار قابلة للاستغلال الزّراعي، ومثلها بل ضعفيها إذا حسبنا احتمال تطوير الزّراعة الصحراوية بالإمكانات التكنولوجية المتوافرة حالياً). والابتكار (بالاعتماد على التقنيات الجديدة وقدرات الموارد البشرية الجزائرية، في الداخل والخارج، للاضطلاع بمهمّة الدفع بالبلاد إلى الأمام). وهي طرق ثلاثة، على شاكلة طريق الحرير الصيني، هي رهان تلك الفرص الضائعة التي يمكن، بإنجاح الحراك وببناء جزائر جديدة تجسيدها، لتكون الدافع إلى الوصول إلى المكانة الحلم: اقتصاد ناشئ وقوة إقليمية.
بالنتيجة، هذه هي مقاربة العمل، في المراحل المقبلة، تحقيق العدالة وعدم البكاء على الأطلال، بل البناء على تلك المقاربة الجديدة في المحاسبة بالفرص الضائعة، للانطلاق في مشروع المستقبل، مشروع الانبعاث للأمّة وللجزائر. لا يجب أن يُلام، أحد، أياً كان، إذا أردنا النجاح للمشروع، لأنّ ذلك مناط المصالحة الاجتماعية/ المجتمعية، ونقطة الولوج للعروج الحضاري بالنّظر للحاجة إلى الكلّ، كل السواعد التي تملك الإرادة للبناء، بعيداً عن أية نية مبيتة لتحويل مقاربة الفرص الضائعة من مقاربة محفزة على العمل والإرادة إلى زخم انتقامي، وصل بالتجارب إلى ما نراه، الآن، وأُولاها تجربة الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.
عندما ينطلق المدّ الإصلاحي في أيّة تجربة انتقالية، يكون من بين مآخذه على النّظام البائد الاتّجاه نحو القضاء على منظومة الفساد والفشل التي أقامها لإدامة إمساكه بزمام الأمور، وهي مآخذ
نصل، هنا، إلى بيت القصيد، وهو المقاربة الجديدة للمحاسبة، إذ يكون الفشل التامّ، المشار إليه، يكون، زماناً، قد ضيّع على البلاد فرصاً سمحت لغيرها، في الوقت ذاته، بركوب موجة القوّة لتصبح اقتصاديات ناشئة وقوى متوسطة تصنع الفعل الإقليمي. وإذا أردنا تطبيق هذه المقاربة على الجزائر في حراكها لصنع التغيير، سنكون أمام فعل قانوني - قضائي، لا مناص من الذّهاب فيه إلى أبعد ما يمكن لملفّات الفساد من تأثير بطبيعة الحكم والسياسة العامّة طوال العشريتين اللّتين حكم فيهما الرئيس المستقيل. وقد كان لهذه المقاربة أكبر الأثر في التّمكين لسلميّة الحراك، من ناحية، وفتح ورشات وجوب تجديد النّخب الحاكمة، من ناحية أخرى، حيث طاولت ملفّات الفساد شخصيات مقرّبة من دائرة اتّخاذ القرار في النّظام السّابق، إضافة إلى شخصيات تنتمي إلى أداتها الاقتصادية – المالية، بما يوحي أنّ الفساد مستشرٍ، في مركز الحكم وهامشه وأدواته، ويستوجب، لمحاربته، "أن يتنحّاو قاع" (ليرحلوا جميعاً، بالعامّية الجزائرية، شعار يرفعه المتظاهرون، منذ بدء الحراك)، بمعنييه، السياسي بتجديد النخب، والسوسيولوجي بالتمكين لتلك النّخب صاحبة الكفاءة.
على الرّغم من ذلك كلّه، لماذا لا نتّجه إلى مقاربة مزدوجة تزاوج بين المقاربتين المذكورتين للمحاسبة، عدالة تقف بأدواتها القانونية لرصد قرائن الفساد وصنع ملفّات ليفصل القضاء فيها، وعدالة أخرى، معنوية وعلمية، في آن واحد، يقوم بها الخبراء يحصون فيها الفرص التي يكون الفشل والسياسة العامة المتهالكة قد ضيّعتها على البلاد في المدّة التي حكم فيها المستبد؟
يمكن الانطلاق، للإجابة عن السّؤال، بالنسبة إلى الجزائر، من حقيقة أكّدتها مراجع علمية وأكاديمية كثيرة، خاضت في الشّأن الاقتصادي الجزائري، وهي أنّ كلاً من الجزائر، كوريا الجنوبية وإسبانيا كانت، في حدود منتصف سبعينيات القرن الماضي، في مرتبةٍ متقاربةٍ من النّمو الاقتصادي، من ناحية، وكيف استطاعت كلّ من تركيا وإيران، بمقدّرات متقاربة من تلك التي تملكها الجزائر، من ناحية أخرى، من بلوغ مصافّ القوّة المتوسطة الإقليمية، وهي حقائق تؤسّس لمقاربة المحاسبة بالفرص الضّائعة، لأنّ تلك البلدان المذكورة تنتمي، كلّها، ما عدا إيران، إلى أسبابٍ سياسية، لمجموعة الاقتصاديات الناشئة، أو ما يعرف بمجموعة العشرين.
تقوم تلك المقاربة على أسس علمية، إذ إنهّا تلجأ إلى حساب الفرق بين الوضع العادي (والوضع الآخر) لاستخدام الموارد والكفاءات بمنهجية تحقيق الصالح العام، وبانتهاج مقومات السياسة العامة، بالارتكاز على التّوفيق بين الموارد والاحتياجات، وباستخدام الأدوات العلمية التي لا يتيحها إلّا العدل في فسح المجال أمام الكفاءات، لتعبّر عن نفسها في جوّ كلّه تنافسية ونزاهة في إطار تكافؤ الفرص. ويُقصد بالوضع الآخر، هنا، وضع الفساد، الرشوة والمحسوبية في التّعامل مع تلك المقدرات/ الموارد نفسها، وما ينتج من ذلك من إهدار للموارد/ المقدرات، وبالتالي، تضييع الفرص ومنع البلاد من بلوغ المرتبة التي تليق بتلك الموارد/ المقدرات.
بالنّسبة إلى الجزائر، أقرت بعض الدّراسات بما تملكه البلاد من تلك الموارد/ المقدرات، وما كان
وكانت دراسات جزائرية قد قامت بمحاكاة المكانة التي كان يمكن بلوغها في حالة الاستخدام الجيد لتلك الأموال فقط، من دون الذهاب في تلك العملية الاستشرافية إلى ما كان يمكن أن ينتج من الاستخدام العلمي لتلك الموارد/ المقدرات والارتكاز، فقط، على الطاقات المتجدّدة. (يذكر، هنا، تضييع الجزائر فرصة المشروع الألماني لتوليد الطاقة وتصديرها إلى أوروبا "ديزارتاك" الذي رفضه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لأسباب ما زالت مجهولة)، الزّراعة (تمتلك الجزائر ما يزيد على 40 مليون هكتار قابلة للاستغلال الزّراعي، ومثلها بل ضعفيها إذا حسبنا احتمال تطوير الزّراعة الصحراوية بالإمكانات التكنولوجية المتوافرة حالياً). والابتكار (بالاعتماد على التقنيات الجديدة وقدرات الموارد البشرية الجزائرية، في الداخل والخارج، للاضطلاع بمهمّة الدفع بالبلاد إلى الأمام). وهي طرق ثلاثة، على شاكلة طريق الحرير الصيني، هي رهان تلك الفرص الضائعة التي يمكن، بإنجاح الحراك وببناء جزائر جديدة تجسيدها، لتكون الدافع إلى الوصول إلى المكانة الحلم: اقتصاد ناشئ وقوة إقليمية.
بالنتيجة، هذه هي مقاربة العمل، في المراحل المقبلة، تحقيق العدالة وعدم البكاء على الأطلال، بل البناء على تلك المقاربة الجديدة في المحاسبة بالفرص الضائعة، للانطلاق في مشروع المستقبل، مشروع الانبعاث للأمّة وللجزائر. لا يجب أن يُلام، أحد، أياً كان، إذا أردنا النجاح للمشروع، لأنّ ذلك مناط المصالحة الاجتماعية/ المجتمعية، ونقطة الولوج للعروج الحضاري بالنّظر للحاجة إلى الكلّ، كل السواعد التي تملك الإرادة للبناء، بعيداً عن أية نية مبيتة لتحويل مقاربة الفرص الضائعة من مقاربة محفزة على العمل والإرادة إلى زخم انتقامي، وصل بالتجارب إلى ما نراه، الآن، وأُولاها تجربة الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.