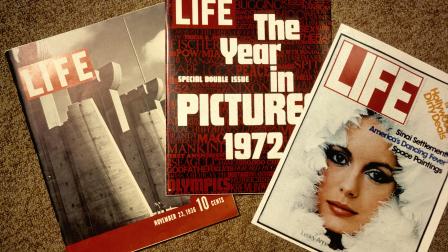لوقا فيرنييه في سورية: زمنٌ مضى
"أهلاً وسهلاً": كاميرا العلاقات الودّية (الملف الصحافي للفيلم)
عام 2009، صوّر لوقا فيرنييه في سورية، محاولاً تجديد ذكرى عائلية تعود إلى زمن الانتداب الفرنسي، فارتبط بعلاقات ودّية مع عائلات سورية في تدمر. عام 2011، عاد لمتابعة التصوير، لكن الثورة قامت، وبدأ معها القمع العنيف للنظام، الذي أجبره على التوقّف. عام 2019، حمل كاميراه مُجدّداً، ليبحث عن هؤلاء الرجال المشتّتين في أنحاء الأرض، الذين قال لهم قبل مغادرته سورية: "أراكم قريباً".
في "أهلاً وسهلاً"، سجّل فيرنييه رحلته في سورية، المنتهية مع "بدء الثورة، وقمع نظام بشّار الأسد العنيف للسوريين"، كما قال في الفيلم، المُشارك في الدورة الـ42 لـ"المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي ـ سينما الواقع"، التي كان مزمعاً إقامتها بين 13 و22 مارس/ آذار 2020 في "مركز جورج بومبيدو" في باريس، قبل إلغائه بسبب تفشّي فيروس "كورونا"، وتحويل عروضه إلى العالم الافتراضي.
غادر فيرنييه فرنسا بزادٍ قليل: كاميرا ومفردات عربية، وأسماء عائلات تدمرية، كالدبل والمطلق والمرشد، ونواف الفيصل شيخ الحديديين. صُور قديمة بالأسود والأبيض، التقطها جدّه في سورية عام 1935، خلال مهمته ضابطاً في وحدات الهجانة في الجيش الفرنسي أيام الانتداب. ذهب فيرنييه إلى سورية بحثاً عمن بقي من عائلات سورية من البدو، رافق أبناؤها جدّه، ونشأت بينهم وبينه علاقة صداقة متينة. مهمّة مستحيلة؟ ليس تماماً. فبفضل تلك الصُور، تعرّف على أشخاص وأمكنة، وتابع الأثر، ووجد طرقات وبقايا معمار. بنى مساره الخاص، وعثر على أحفاد أصدقاء جدّه. أمضى وقتاً في تدمر باحثاً عن العائلات التدمرية التي ذكرها جدّه في كتاب عنهم، والتقى أشهر وأقدم مُصوّر هناك، واكتشف عنده صُوَراً متراكمة منذ عهود، تُعبّر عن عصر كامل، وعن تاريخ مدينة.
سجّل فيرنييه رحلته بالكاميرا. لم يبخل بمنظرٍ يُتيح رؤية سورية، كما عُرِفتْ بالوجوه المبتسمة لأهلها، وتعليقاتهم الظريفة، وترحيبهم بالضيف، وأسلوبهم في الحياة. التقط تفاصيل صغيرة لأناسٍ عكست حساسية شخصية ورغبة في تواصل، مكّنت صاحبها من تمرير مشاعر الذين اختلط بهم.
افتُتح الفيلم بقلعة حلب، مع صورتين حديثتين لها بالألوان، مقابل صورة قديمة بالأسود والأبيض، تتناقلها أيدٍ عدّة. أناسٌ يطرحون أسئلتهم، ويُظهرون فضولاً وتعابير دهشة على وجوههم. ثم تظهر امرأتان مبتسمتان ترحّبان به، وتدعوانه إلى الابتعاد عن أشعة الشمس اللاهبة، وشابة تعبّر ببساطة عن جمال المُصوّر الفرنسي، ورجل يتحدّث كما يجب أمام أجنبي، شارحاً له مساوئ الاستعمار، وبدوي مستلقٍ بطريقته في الخيمة وهو يدخّن، وحذاء ينتظر قدمين لا تتعبان من ملاحقة تحرّكات الآخرين. حذاء بمقدمة مدببة، "خاص برجال المخابرات"، الذين يحومون في البادية لرصد تبدّلات ذرّات الرمال وتحرّكات الجمال واستقبالات العربان، وللاستفسار: هل من غريبٍ هنا؟
في "أهلاً وسهلاً"، سجّل فيرنييه رحلته في سورية، المنتهية مع "بدء الثورة، وقمع نظام بشّار الأسد العنيف للسوريين"، كما قال في الفيلم، المُشارك في الدورة الـ42 لـ"المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي ـ سينما الواقع"، التي كان مزمعاً إقامتها بين 13 و22 مارس/ آذار 2020 في "مركز جورج بومبيدو" في باريس، قبل إلغائه بسبب تفشّي فيروس "كورونا"، وتحويل عروضه إلى العالم الافتراضي.
غادر فيرنييه فرنسا بزادٍ قليل: كاميرا ومفردات عربية، وأسماء عائلات تدمرية، كالدبل والمطلق والمرشد، ونواف الفيصل شيخ الحديديين. صُور قديمة بالأسود والأبيض، التقطها جدّه في سورية عام 1935، خلال مهمته ضابطاً في وحدات الهجانة في الجيش الفرنسي أيام الانتداب. ذهب فيرنييه إلى سورية بحثاً عمن بقي من عائلات سورية من البدو، رافق أبناؤها جدّه، ونشأت بينهم وبينه علاقة صداقة متينة. مهمّة مستحيلة؟ ليس تماماً. فبفضل تلك الصُور، تعرّف على أشخاص وأمكنة، وتابع الأثر، ووجد طرقات وبقايا معمار. بنى مساره الخاص، وعثر على أحفاد أصدقاء جدّه. أمضى وقتاً في تدمر باحثاً عن العائلات التدمرية التي ذكرها جدّه في كتاب عنهم، والتقى أشهر وأقدم مُصوّر هناك، واكتشف عنده صُوَراً متراكمة منذ عهود، تُعبّر عن عصر كامل، وعن تاريخ مدينة.
سجّل فيرنييه رحلته بالكاميرا. لم يبخل بمنظرٍ يُتيح رؤية سورية، كما عُرِفتْ بالوجوه المبتسمة لأهلها، وتعليقاتهم الظريفة، وترحيبهم بالضيف، وأسلوبهم في الحياة. التقط تفاصيل صغيرة لأناسٍ عكست حساسية شخصية ورغبة في تواصل، مكّنت صاحبها من تمرير مشاعر الذين اختلط بهم.
افتُتح الفيلم بقلعة حلب، مع صورتين حديثتين لها بالألوان، مقابل صورة قديمة بالأسود والأبيض، تتناقلها أيدٍ عدّة. أناسٌ يطرحون أسئلتهم، ويُظهرون فضولاً وتعابير دهشة على وجوههم. ثم تظهر امرأتان مبتسمتان ترحّبان به، وتدعوانه إلى الابتعاد عن أشعة الشمس اللاهبة، وشابة تعبّر ببساطة عن جمال المُصوّر الفرنسي، ورجل يتحدّث كما يجب أمام أجنبي، شارحاً له مساوئ الاستعمار، وبدوي مستلقٍ بطريقته في الخيمة وهو يدخّن، وحذاء ينتظر قدمين لا تتعبان من ملاحقة تحرّكات الآخرين. حذاء بمقدمة مدببة، "خاص برجال المخابرات"، الذين يحومون في البادية لرصد تبدّلات ذرّات الرمال وتحرّكات الجمال واستقبالات العربان، وللاستفسار: هل من غريبٍ هنا؟
الغريب ليس غبياً، فهو أدرك مقصدهم منذ البداية، فتلاعب معهم. يختفي تارة أولى، ويقدّم السجائر لهم تارة ثانية، ويتظاهر بالسذاجة تارة ثالثة. لكن حيرتهم وغيظهم يبقيان: "ماذا يفعل هذا الفرنسي الذي يسوح على خاطره، ويُصوّر كما يحلو له، من دون إذن؟ ما هدفه يا ترى؟". في أيام قليلة، أدرك المخرج ما يعانيه السوريون منذ أعوامٍ طويلة.
التقط لوقا فيرنييه تفاصيل الأمكنة أيضاً، بكاميرا ثابتة أحياناً، ترصد كلّ حركة وكل وجه يمرّان أمامها، وبكاميرا متحركة أحياناً أخرى، ليَعْبُرَ في سورية، بباديتها وآثارها وناسها، في صُوَر تبدو اليوم مؤلمة وتحرق القلوب، وباتت من الزمن الماضي، الذي أراد المخرج إحياءه مجدّداً مع صُور جدّه، بحثاً عنه وعن شخوصه عبر الطرق والأحفاد. جاء فيرنييه إلى سورية وهو يبلغ 24 عاماً، العمر نفسه لجدّه حين كان في سورية مع البدو، في مهمة عسكرية. حَلّ الخلافات بين القبائل، ورَسَم الخرائط، وبعضها لحماية الآبار، وطبعاً المراقبة والاستعلام. كما جدّه، المرتبط بعلاقات صداقة قوية مع أناسٍ من هناك، تجدّد الأمر معه. الحفيد مع الأحفاد الذين عثر عليهم. هم بدو لكنّ معظمهم لم يعدْ رحّلاً، فالسلطات المتتالية "شجّعت تمدّنهم واستقرارهم، كما شجّعت تقسيم البادية لتسهيل السيطرة عليهم"، ولم تغفل عن تسمية نوابٍ منهم بالتزكية، "فلا أحد ينتخب هنا (في سورية)، بل الدولة هي التي توكّل الشيوخ". بهذا، لم تعد البادية السورية كما كانت، يقول فيرنييه مبدياً أسفه على ذلك.
بمتابعته التجوّل بحثاً عن عائلات أصدقاء جدّه، بثّ لوقا فيرنييه في كلّ مشهدٍ حنيناً مؤثّراً في وجدان مشاهدي "أهلاً وسهلاً"، طارحاً أسئلة مريرة، تُختزل بـ"ولكنْ، ما حلّ بهؤلاء جميعهم اليوم؟ ما باتت عليه بيوتهم وأعمالهم؟".
في كاميراه، تبدو تدمر عروساً، وواحةً خضراء جميلة. انعكس حبّه لها في صُور ساحرة، وعبر ما كشفته الوجوه المُحبِّة لأهلها، بابتساماتهم وترحيبهم به، "أهلاً وسهلاً"، باستثناء رجال المخابرات طبعاً. في فيلمه، نكأ جروحاً، وذكّر بماضٍ اختفى إلى الأبد. وحين عاد، عام 2011، لمتابعة بحثه، "انتفضت المدينة على نظام بشّار الأسد"، وتحوّل البحث عن حفيدٍ بعيد ومختف، إلى تسجيل ما سيختفي. انقلبت الذاكرة، وتحوّلت رحلة البحث عن آثار الجدّ إلى رحلة تسجيل أثرٍ، سيبقى فقط من خلال صُوَر المخرج. تدمير البلد تمّ بوتيرة جعلت صُوَره أرشيفاً، فيه سورية التي باتت نائية، وشوارعها التي أمست آثاراً.
ما حصل في سورية فرض عليه رحلة جديدة، قام بها عام 2019، للعثور على صداقات تشتّتت، فبعض أصحابها دُفِن مع من دُفن في حمص، وبعض آخر موزّع في أنحاء الدنيا، بعد هربه في ظلام الليل، ومشيه ساعاتٍ طويلة، وتغلّبه على وعورة الطرقات وخطورة المسالك. التقاهم حيث هم، وحيث باتوا "مواطنين مؤقّتين" في الأردن وتركيا وبريطانيا، لكنّهم لا يزالون يأملون بلقائه مجدّداً، لكنْ في تدمر، حيث التقوه للمرّة الأولى منذ 10 أعوام. سورية لا تزال برفقة كلّ واحدٍ منهم، ولا تزال مُرحِّبة، ولا تزال تقول: "أهلاً وسهلاً" بكل حرارة أهلها وطيبتهم وابتساماتهم.
آخر زيارة لجدّه كانت عام 1967، التقى خلالها صديقه أحمد الدبل، الذي بدا يومها كأنّه ينتظره كي يموت. حينها، قال الجدّ: "لا سورية بعد أحمد بن دبل"، كأنّه كان ينعي زمناً انتهى. والحفيد، بعد تلقّيه نبأ موت ابن الدبل في حمص، قال: "لا سورية بعد ابن الدبل". هذا عصرٌ انتهى أيضاً.