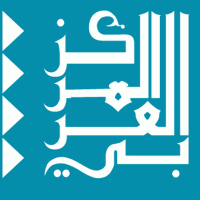أجواء زيارة أوباما إلى السعودية ونتائجها
أجواء زيارة أوباما إلى السعودية ونتائجها
أوباما والعاهل السعودي في مباحثاتهما في الرياض
جاءت زيارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إلى الرياض في الثامن والعشرين من مارس/ آذار الماضي، ولقاؤه العاهل السعودي، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد أَن شاب العلاقة بين الحليفين التاريخيين بعض التوتر، وعدم الثقة، في السنوات الثلاث الأخيرة.
خلفية أسباب التوتر
نبعت أسباب التوتر بين الطرفين السعودي والأميركي، بالدرجة الأولى، من تآكل ثقة المملكة العربية السعودية، بعد ثورات "الربيع العربي"، بجدوى الاعتماد الكامل على مظلة الحماية العسكرية الأميركية. ولم تخفِ المملكة استياءها من موقف إدارة الرئيس أوباما، عندما تخلت عن حليفها الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والذي واجه ثورة شعبية عارمة مطلع عام 2011، وعدّت ذلك مؤشرًا على إمكانية تخلي الإدارة الأميركية عن حلفائها المقربين في المنطقة. كما أنها عبّرت، غير مرة، عن استيائها من الموقف الأميركي من الاحتجاجات التي كانت تجري في البحرين، والتي ترى السعودية، وقوى خليجية أخرى، أنها انطلقت بتحريض إيراني واضح للطائفة الشيعية، وتتواصل على إيقاع الموقف الإيراني من مجمل الوضع الإقليمي. وفي المحصلة، تدخلت السعودية، ودول خليجية أخرى، عسكريًا في البحرين في مارس آذار 2011، لتعزيز وضع النظام وقمع أعمال الاحتجاج فيها، متجاوزة عدم الموافقة الأميركية على هذا التحرك.
ثمّ جاء الموقف الأميركي الغامض، والمتردد، حيال دعم الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد؛ وهي الثورة الوحيدة التي دعمتها المملكة، لأسباب متعلقة بالصراع مع إيران، وليس بمطالب الثورة ذاتها. وضاعف موقف أوباما غير المكترث، حتى بمعاناة المدنيين في سورية، الاستياء السعودي، وبخاصة بعد تراجع إدارته عن تهديداتها بتوجيه ضربة عقابية لقوات النظام السوري، الصيف الماضي، بعد خرقه "الخط الأحمر" الذي وضعته واشنطن ضد استخدام السلاح الكيماوي. ووصل التوتر بين الطرفين إلى ذروته في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عندما توصلت مجموعة الدول الخمس، دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا (5+1) إلى اتفاق انتقالي مع إيران، تم بموجبه وضع قيودٍ على برنامجها النووي في مقابل تخفيفٍ طفيفٍ للحصار المفروض عليها، وهو الاتفاق الذي فاجأ السعودية، وبخاصة أنه جاء بعد مفاوضات أميركية - إيرانية سرية، دامت عدة شهور بوساطة عمانية (خليجية) وغيرها، ومن دون أن تُطلع الولايات المتحدة أَقرب حلفائها في المنطقة على تفاصيلها.
وتضاعفت الهواجس السعودية من تراجع الموثوقية في الحليف الأميركي، جراء اكتشافات النفط والغاز الصخري الكبيرة في الولايات المتحدة، والتوجه نحو تقليل الاعتماد الأميركي على النفط المستورد من الخليج نتيجة لذلك. إنّ تحقيق اكتفاء ذاتي نفطي أميركي في المستقبل قد يؤدي، من وجهة نظر صانع القرار السعودي، إلى تراجع الالتزام الأميركي العسكري، والأمني، نحو المنطقة، ما قد يترك الدول الحليفة مكشوفة أمنيًا وإستراتيجيًا أمام النفوذ الإيراني.
وجاءت الأزمة الأوكرانية، وضم روسيا إقليم القرم في مارس آذار الماضي، متحدية بذلك التحذيرات الأميركية -الأوروبية لتعمِّق المخاوف السعودية من أنّ الولايات المتحدة، في ظل إدارة أوباما، إنما تقوم بانسحابٍ مبرمجٍ على الصعيد العالمي، غير مباليةٍ بمصالح حلفائها وهواجسهم الأمنية، ومخلفةً وراءها فراغًا قد تملأه قوى غيرها، وهو ما فعلته، من قبل، عند انسحابها أواخر عام 2011 من العراق؛ إذ تركته نهبًا لنفوذ إيران، الخصم الجيوستراتيجي اللدود للسعودية.
وعلى نحو أبعد من ذلك، تتخوف السعودية من أن تفاجئها الولايات المتحدة، المنكفئة عن المنطقة بفعل الاستنزاف، بالمسلك ذاته الذي اتبعته في أزمة أوكرانيا، على الصعيد الشرق أوسطي، والذي قد يتجسَّد عبر التقاط إيران إشاراتٍ، تنمّ عن أنّ أميركا غير راغبة في تورطٍ عسكري جديدٍ، في حال قررت توسيع نفوذها وتعزيزه في المنطقة، على حساب حلفاء أميركا، ومنهم السعودية التي ترى في تنامي دور إيران تهديدًا وانتقاصًا من نفوذها في المنطقة.
تطمينات وليست تغييرات
جاءت زيارة أوباما إلى الرياض ضمن السياق الذي أشرنا إليه؛ فالولايات المتحدة التي تدرك جميع المعطيات والهواجس السابقة تسعى إلى طمأنة الحليف السعودي بأنّها لا تنوي الإخلال بالتزاماتها نحو المنطقة، وحلفائها، فيها، لكنها -من جهة أخرى -تبدو غير مستعدة لتغيير سياساتها المتبعة في أَيٍ من القضايا محلّ الخلاف مع السعوديين.
وفي مسعى إلى التوفيق بين محاولات طمأنة الحليف مع عدم النزول عند رغباته، اختارت إدارة أوباما أن تحتوي الاستياء السعودي العام من السياسة الأميركية من دون تكلفة، إذ أعلن البيت الأبيض أنّ أوباما لن يتطرق في لقائه العاهل السعودي لموضوعات الحريات الدينية وحقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة في المملكة. وكان المبرر الذي ذُكر في هذا السياق أنّ مدة اللقاء بين الزعيمين (ساعتان) غير كافية لطرح جميع الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأنّ الهدف الأكبر من الزيارة كان مناقشة القضايا الأمنية، الأكثر إلحاحًا في المنطقة، بما في ذلك المفاوضات النووية مع إيران و"الحرب الأهلية" في سورية. وعلى الرغم من أنه لم يرشَح الكثير من المعلومات، أميركيًا، عن تفاصيل اجتماع الرئيس أوباما مع الملك عبد الله، فقد تطرق اللقاء إلى بحث الوضع في مصر أيضًا.
إيران
وفق تصريحاتٍ لمسؤولين في البيت الأبيض، فإنّ أوباما سعى في زيارته للتأكيد على أهمية العلاقات الأميركية –السعودية، وبأنّ الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، كما أنها لن تغض الطرف عن نشاطات إيران الأخرى في المنطقة، والتي تزعزع الاستقرار فيها. وحسب هؤلاء المسؤولين، فإنّ المفاوضات النووية الجارية مع إيران لا تشمل نشاطاتها الأخرى في المنطقة، والتي تتوجس السعودية منها؛ بمعنى أنها لن تُدرَج ضمن أي صفقة أميركية -إيرانية محتملة، على حساب السعودية. كما أعاد الرئيس الأميركي التأكيد على أنّ الولايات المتحدة لن تنسحب من منطقة الشرق الأوسط، ولن تترك فيها فراغًا تملأه قوى أخرى، مثل إيران، بما يشكل تهديدًا للحلفاء الأميركيين. مع ذلك، بقي أوباما مصرًّا على الاستمرار في نهج التفاوض، والانفتاح الذي اعتمده مع الإدارة الإيرانية الجديدة التي يقودها الرئيس حسن روحاني، وهو خلاف ما ترغب فيه السعودية، المتوجسة من عدم انعكاس خطاب إيران التصالحي أفعالًا على الأرض.
سورية
وفي ما يتعلق بسورية، كانت لافتةً تصريحات نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، بنجامين رودس، والذي رافق أوباما في زيارته، أنّ إدارة أوباما تفكِّر في توسيع برنامج سري، وضعته لمساعدة قوات المعارضة السورية "المعتدلة"، وتعزيز موقفهم ضد قوات الأسد، والتيارات الجهادية المتحالفة مع القاعدة، في آن معًا. وأشار في تصريحاته تلك، قبل مغادرة الوفد الأميركي للرياض، إلى أنّ الولايات المتحدة عزّزت التنسيق والعمل مع السعودية في الأشهر الماضية في السياق السوري، وقال مسؤولون آخرون إنّ الدولتين متفقتان على ضرورة حدوث انتقال سياسي في سورية، ودعم معارضي الأسد "المعتدلين".
وفهمت هذه التصريحات حول هذا البرنامج على أنها محاولة أميركية لاسترضاء السعوديين، المستائين من التردد الأميركي في سورية، ورفض إدارة أوباما، حتى الآن، السماح للسعودية بتزويد مقاتلين "معتدلين" من المعارضة بصواريخ مضادة للطائرات، على الرغم من أنّ المملكة قدمت خطةً معززةً بضماناتٍ، تؤكد فيها أنّ هذه الصواريخ لن تقع بالأيدي الخطأ، وحتى، في حال حدوث ذلك، ثمة ضمانات أخرى، كفيلة بتعطيلها إلكترونيًا، والسيطرة على فاعليتها وحركتها عن بُعد. وحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية في 27 مارس/آذار؛ أي قبل يومٍ من زيارة أوباما للسعودية، فإنّ تفاصيل هذا البرنامج السري، والذي لا يزال قيد النقاش ولم يحسم بعد، تتضمن تدريب مزيدٍ من قوات المعارضة السورية في معسكرات في الأردن وشمال السعودية وقطر. ويناقش البرنامج، أيضاً، إمكانية دعم المجالس المحلية، والشرطة المدنية التي تديرها المعارضة في المناطق المحررة في سورية، فضلًا عن إمكانية فرض ممرات آمنة، لإيصال المساعدات إلى تلك المناطق. ويهدف البرنامج، في المحصلة إلى إيصال رسالةٍ إلى نظام الأسد بأنّ الحل العسكري غير ممكن في سورية، وبخاصة في ظل تقدم قواته على الأرض مؤخرًا.
غير أنّ نقطة الخلاف المركزية بين الولايات المتحدة والسعودية تبقى بشأن تزويد قوات المعارضة السورية "المعتدلة" بصواريخ مضادة للطيران، من أجل تغيير المعادلة العسكرية التي فرضها تقدم النظام عبر تفوقه الجوي؛ وهي نقطة ما زالت واشنطن تبدي هواجس وشكوكًا كثيرة بشأنها. وكان الرئيس أوباما قد استبق زيارته إلى السعودية بالتقليل من إمكانية حدوث تغيير كبير في موقف إدارته من الأزمة السورية، عندما رفض، في مقابلة مع شبكة "سي .بي .إس" التلفزيونية، فرضية أنّ بلاده كان بإمكانها منع الأزمة الإنسانية في سورية، فقد قال "أعتقد أنها فكرة خاطئة القول إننا كنا، بشكل ما، في وضع يتيح لنا منع حدوث المعاناة التي نشهدها في سورية، من خلال بضع ضربات منتقاة". وعبّر عن تقديراتٍ تشير إلى قلة الحيلة، أو عدم الاكتراث تجاه القضية، بقوله إنّ الصراع في سورية قد يستمر "عقدًا آخر ربما"؛ وذلك ليبرر رفضه التدخل عسكريًا.
مصر
بشأن مصر، سعى الأميركيون، في الزيارة، إلى التأكيد على اهتمامهم بتحقيق الاستقرار فيها، وتضييق هوة الخلافات التي نشأت مع السعودية منذ إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعمَّقت بسبب الموقف من الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو تموز 2013.
فعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة لم تعدّ عزل الرئيس محمد مرسي، في الصيف الماضي، على يد الجيش المصري، بوصفه انقلابًا عسكريًا، حتى لا تضطر إلى قطع المعونات العسكرية عن مصر، حسب القوانين الأميركية -مع أنها أجلت بعضها -فإنها عبرت عن عدم رضاها عن أسلوب الجيش في معالجة الأوضاع، بعد عزل مرسي، وبخاصة التعامل العنيف مع رافضي الانقلاب.
أثارت هذه المواقف حفيظة السعودية التي قدمت، مع الإمارات العربية المتحدة، مساعداتٍ ماليةً كبيرةً لتمويل حكومة الانقلاب وإسنادها، وصولًا إلى دعم ترشّح المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق وقائد الانقلاب، للرئاسة. ويبدو أنّ شقّة الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية أخذت تتضاءل في السياق المصري، وبخاصة مع قبول الولايات المتحدة ضمنيًا ترشّح السيسي "المدني"، بعد استقالته من وزارة الدفاع. وتكتفي الولايات المتحدة، الآن، بمطالبة القاهرة بالالتزام بـ "خارطة طريق تستوعب كل مكونات المجتمع المصري".
خلاصة
يبدو واضحًا أنّ الخلاف الأميركي -السعودي يتمحور، في جوهره، حول قلق الرياض من الانطباع السائد الذي يشير إلى انكفاء أميركي، وانسحابٍ من ساحات دولية عديدة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. وهو قلقٌ يساور حلفاء آخرين للولايات المتحدة. وبناءً عليه، تشعر السعودية بالقلق من أن تكون المساعي الأميركية للوصول إلى اتفاق مع إيران على حسابها، وترى في التردد الأميركي في سورية دليل ضعفٍ، يثير شكوكاً كثيرة حول مدى التزام واشنطن بأمن حلفائها، وإمكانية اعتمادهم على القوة الأميركية الرادعة. وعزّزت هذه الشكوك "مسارعة" إدارة أوباما إلى التخلي عن حلفائها خلال ثورات "الربيع العربي".
حاول الرئيس أوباما أَن يبدّد هذه المخاوف خلال زيارته إلى السعودية، كما حاول تأكيد التزام بلاده أمن منطقة الخليج، وعدم السماح لإيران بالهيمنة عليها. لكنه لم يبدِ -في الوقت نفسه -أي مؤشراتٍ بشأن استعداده لتبني سياسات مختلفة إزاء إيران، أو حلفائها، خاصة في سورية، كما استمر في اعتبار حكومة نوري المالكي –على الرغم من سياساتها الطائفية، وتهميشها جزءًا كبيرًا من مكونات الشعب العراقي بسنته وشيعته وأكراده –حليفًا في الحرب على الإرهاب. ويشير هذا السياق إلى أنّ الطرفين الأميركي والسعودي مضطران إلى التعايش مع خلافاتهما، في إطار العلاقة التحالفية التي تجمعهما، ما يجعل السعودية، في وضعها الحالي، تحتاج، فعلًا، إلى تطمينات، لكنها تطمينات ليس في وسع أي رئيس أميركي، أو غير أميركي، أن يمنحها، بل يجب أن تنبع من حركة الشعوب العربية ذاتها، في مرحلة عاصفة حبلى بالأحداث