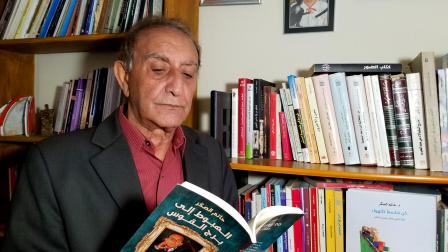"تَفسير المنار": القرآنُ سنداً للتحديث
رغم شهرةِ "تفسير المنار" ومتانَة مضامينه، فإنَّ وراءَه قصّةً حَزينة، فيها آثار خَيبة أملٍ. إذ تعودُ جذور هذا الكتاب إلى علاقة إجلالٍ كانت تربط الشيخ محمد عبده (1849-1905) بمُريدِهِ رَشيد رضا (1865-1934) والذي تَعرَّف على أفكار الإمام، حين كان شابًّا في باريس، يكتب المقالات الحارقة، في "العروة الوثقى"، مع المُصلح جمال الدين الأفغاني (1838-1897).
ثمَّ التقى به في طرابلس الشام مرتيْن (سنة 1885 وسنة 1894)، حين جاء إلى زيارتها تلبيةً لدعوة علمائها. ثمَّ توثقت الصلة بين الرجليْن عبر المراسلة والتفكير المشترك في الإصلاح الديني. وازداد تعلّق رضا بأُستاذه حتى عزمَ على الهجرة إليه. فنزل الإسكندرية مساء الجمعة 3 كانون الثاني/ يناير من سنة 1898. وبعد أيّام قضاها في زيارة مُدن الساحل المصري، اتَّجه إلى القاهرة، وقابلَ محمد عبده صبيحة اليوم الذي وَصل فيه، بجامع الأزهر.
في تلك الجلسة الصباحيّة الأولى عينها، عرضَ عليه رضا فكرةَ تفسير القرآن كاملاً. فما كان من محمد عبده إلا أن مانَعَ برفقٍ، متعللاً بوجود "تفاسير عديدة للقرآن" وأنَّ "عمره قد لا يسمحُ له بإنجاز تفسير كامل". وما فتئ أن كرَّرَ عليه رضا الاقتراحَ، يوم الجمعة 4 شباط/ فبراير 1898، فمانعَ ثانيةً بحُجَّة اللامبالاة العامة التي تشيع بين المسلمين في مصر. وتذكَّر بمرارةٍ أنه ألقى درسًا، حضرَه طلبةٌ مسلمون فلم يُدونوا منه شيئًا، فيما سجَّل طالبان قِبطيان كلّ ما ذكر. وأكّد أنه يتكلّم بمقدار ما لدى السامع من الانتباه والطّلب. وهما، حَسَبَه، مفقودان يومَها.
وما زال رشيد رضا يُلحُّ عليه حتى وافقه على البدء في تفسير شفويّ، في شكل دُروس تُلقى في أروقة الأزهر بالاعتماد على كتاب "الجَلالَيْن"، لجلال الدين المَحَلّي (1389-1460) وجلال الدين السيوطي (1445-1505)، يرجع إليه لشَرح غرائب اللغة ثم يستطرد في استنباط معاني الآيات بما يُصلح شأنَ المسلمين في الدين والدنيا ويبعدهم عن أسباب الانحطاط. وكان رضا يكتب ما يقوله الأستاذ ويَعرضه عليه في اليوم الموالي، فيوافقه أو يعمّقه بتدوين إضافاتٍ جديدة. واستمرَّ الحال حتى طبعَ الجزء الأول وبدأ في الثاني، وهكذا حتى وفاة الشيخ عبده سنة 1905 الذي توقّف عند الآية 125 من سورة النساء.
وبعدها، واصلَ رضا التفسيرَ ولكنه خالف منهجَ شيخِهِ، فَأكثرَ من إيراد السُّنَن الصحيحة وتحقيق بعض مفردات القرآن وتراكيبه اللغوية والمجازيّة، كما أفاض في تحرير استطراداتٍ، في شكل مباحث مستقلة، يحتاج إليها مسلمو عَصره، وتدور حول الإصلاح الديني والفكري، يحكمها الهاجس النهضوي، وغايتها تأصيل الإسلام في سياق القرن العشرين. ولمَّا يتمَّ هو الآخر التفسير إذ وصلَ إلى الآية الثانية والخمسين من سورة يوسف، أي قرابَة نصف القرآن.
 وقد كُتِبت أجزاءُ التفسير الثلاثَةَ عَشَرَ في دار المنار بدرب "الجماميز" بالقاهرة، وقد كانت، كما وَصفَها عباس محمود العقاد، الذي زارَها وقتها: "دارًا صغيرةً، لها سلَّم ضيقٌ، تصعد عليه إلى حجرةٍ لا تزيد في مساحتها على أربعةِ أمتار مربعة، وفيها ديوانٌ مفروشٌ وعلى أرضها حَصيرة فوقَها فروةٌ يَجلس عليها الأستاذُ وقد أثنى قَدَمَه وفي يَدِه وَرَقَة يكتبُ عليها للمَنَار". (من كتاب "رِجالٌ عَرفتهم").
وقد كُتِبت أجزاءُ التفسير الثلاثَةَ عَشَرَ في دار المنار بدرب "الجماميز" بالقاهرة، وقد كانت، كما وَصفَها عباس محمود العقاد، الذي زارَها وقتها: "دارًا صغيرةً، لها سلَّم ضيقٌ، تصعد عليه إلى حجرةٍ لا تزيد في مساحتها على أربعةِ أمتار مربعة، وفيها ديوانٌ مفروشٌ وعلى أرضها حَصيرة فوقَها فروةٌ يَجلس عليها الأستاذُ وقد أثنى قَدَمَه وفي يَدِه وَرَقَة يكتبُ عليها للمَنَار". (من كتاب "رِجالٌ عَرفتهم").
انطلق الرجلان من ملاحظة ما في كتب التراث من خرافات وتعقيدات نحويّة وبلاغيّة، تشوِّه الرسالة الأصلية للقرآن، باعتِباره كتابَ هداية وإرشادٍ، قبل أن يكون كتابَ علومٍ صحيحةٍ تُستقى منها اللوغاريتمات والنظريات الطبيعيّة، أو مسطرة قوانين جافّة. فطفقا يخصّصان تأملاتٍ في الآيات في سبيل إنجاز شرحٍ "عقليّ" يُبعد كلَّ شبهةٍ للتعارض بين العقل والدين، وبين النهضة الحضارية وإيمان الضَّمير.
ولذلك زخَرَ هذا التفسير بالردود على الفلاسفة الأوروبيين المعاصرين له، مثل ارنست رينان (1823- 1892)، وألبرت هانوتو (1853-1944) وإسحاق تايلور (1829-1901) وهربرت سبنسر (1820-1903) وغيرهم. فقد كانت لعَبْده معهم نقاشاتٌ ومجادلات حول روابط الإسلام والمسيحيّة والعلم والفلسفة، فكان هذا التفسير ذريعةً لتقريب الشقة بين الأديان وبينها وبين الفلسفَة. وقد دافع الشيخان عن الإسلام "دون أن يقدحا في عقيدة المسيحيّة"، ولا في ضرورة المنطق، مما اقتضى الاطلاع على مقولات الإنجيليين ومناقشتها بالحجّة والبرهان، وأحياناً بالتبرير والتعميم.
كما لم يُرد الرجلان لتفسيرهما أن يكون تكرارًا لما قاله السابقون، بل تفجيرًا لمنابع الهدى من كلام الله في ظلّ الحداثة المادية والذهنيّة التي باتت تحاصر العالم الإسلامي مَطلعَ القرن العشرين. ولذلك صبَّا فيه همومَ النهضة وهواجسها وتناقضاتها ومفارقاتها وحاولا إيجاد أجوبة عنها في القرآن، بناءً على قاعدة ألَّا تناقضَ بين العقل والإيمان، بين الضمير والمجتمع وبين الدين والدولة.
كما سعى الشيخان إلى أن يكون "المنار" قطيعةً مع أخطاء المُفسّرين القدامى، وحتى بعض المعاصرين، مثل نقل الإسرائيليات والخرافات دون تمحيصٍ، والتوسُّع في تسجيل غرائب اللغة والإعراب والتفاصيل والإيغال في خلافيات النحو والبلاغة والإكثار من الآراء الشاذة التي لا تثمر مصالحَ عمليّة، ومن قَصَص الخيال الذي لا يتطابق مع قوانين الطبيعة، فضلاً عن عدم مراعاة الواقع المستجد في العالَم. بكلمةٍ، أريد لهذا التفسير أن يعيدَ الإسلام للتاريخ بَعدما كان على هامِشِهِ.
كما يتميَّز هذا التفسير باشتماله على مُراسلات الإمام عبده وفتاواه والأجوبة والمناقشات والمناظرات التي أجراها طيلَةَ حياته العلمية والدعويّة. فقد دوَّنها تلميذُه وحافَظَ عليها وأوردَها كلما سمحَ بذلك سياقُ الآية. فإذا عرضت الآية لمحورٍ ما، وكان للشيخ مقالٌ فيه، أورَدَه وإن لم يكنْ ظاهرَ الصِّلة بالتفسير. فالكتابُ، بهذا الاعتبار، مَوسوعةٌ جامعة لآراء عَبده وآثاره ولاسيما الشفويَّة، والتي يعود الفضل لرضا في جَمعها والمحافظة عَلَيها.
وقد يكون من المفيد إعادة بناء هذا النصّ حسب ترتيبه الزمني وتواريخ كتابة أجزائه المتفرّقة لندرك التطورات التي طرأت على الفكر الإصلاحي وتحوّلات المواقف حسبَ الظروف السياسية التي أحاقت بالعالم الإسلامي مثل الاحتلال الغربي والحرب الكونيّة وتفكّك الخلافة، فضلاً عن التطورات الذاتية لهذيْن المُصلحين. ذلك أنّ النصّ، في شكله الحالي، لا يقدّم أية إضاءة على هذه التحولات، رغم أن بناءَهَ تمَّ طيلة ثلاثة عُقودٍ وتزيد.
وهكذا، يُعدّ تفسير المنار مرآة تَنعكس خلالها منعطفات الالتقاء الحَرِج بين مقولات الإسلام ومنجزات الحداثة العقلية والمادية. فكان مجهودًا لافتًا للمواءمة بينهما، على صعوبَتها. وربّما لم يكن النص القرآني سوى ذريعة لدحض الشبهات حتى يظل الإسلام، واللغة العربية تبعًا، الرّابط الرئيس الذي يشدّ لحمة الأمة في مواجهة الاستعمار والمرجعيةَ القيمية التي أريد للمسلمين أن يشيّدوا وَفْقها القَرنَ العشرين. والغالب أنَّ هذا الطموح اصطدم بواقع عنيدٍ، من مَظاهره استمرارُ الاحتلال وهيمنة التخلف.